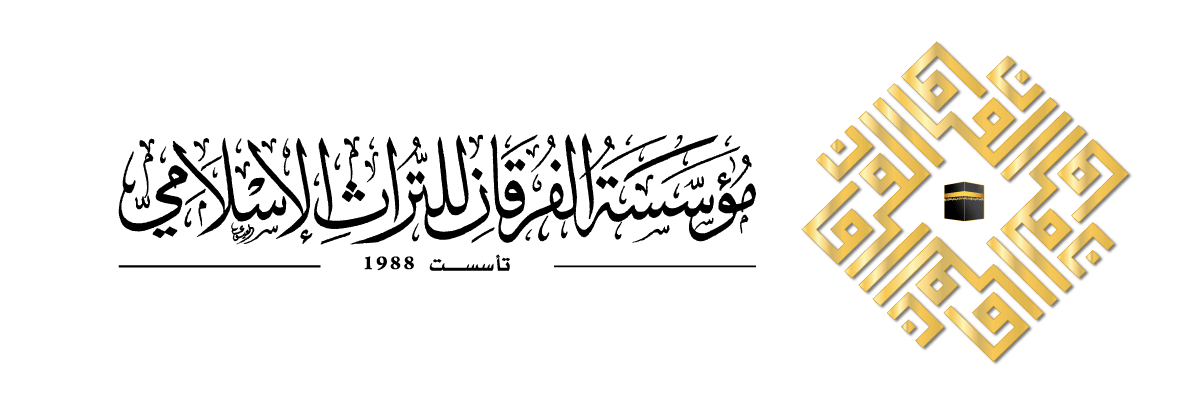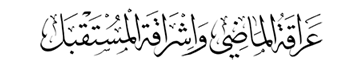إياد أبو شقرا
| محتويات المقال: 1- خواطر وذكريات 2- الأكاديمي... وعاشق دمشق 3- الحرب... ثم سنوات لندن 4- المعلم والصديق |
سمعت عنه قبل أن ألتقيه؛ وأحببته وقدّرته بعدما تتلمذت على يديه، وافتقدت بوفاته – وكنت قد زرته في مستشفاه بلندن قبل أن يسلم الروح بساعات معدودات بعدما دخل في غيبوبة الرحيل – صديقًا ومعلمًا ذا ميزات إنسانية رائعة.
ولد البروفيسور يوسف حسين إيبش عام 1925 في العاصمة اللبنانية، ونشأ فيها وفي دمشق التي أحبها حتى آخر يوم في حياته عام 2003. وهو أب بنت وولدين، كبيرهما حسين سار على خطى أبيه في المجال الأكاديمي فحاز درجة الدكتوراه في الأدب المقارن، وهو اليوم مدير شؤون الإعلام في «اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز»، كبرى المؤسسات العربية الأمريكية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة التمييز ضد العرب في الولايات المتحدة.
تلقى علومه الجامعية بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث تخرج بدرجة بكالوريوس في الآداب ثم حصل منها على درجة الماجستير، ودرّس فيها معيدًا بين 1953 و1956. ثم انتقل إلى جامعة هارفارد العريقة بالولايات المتحدة، حيث حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية والدراسات الإسلامية عام 1960.
بعد العودة من الولايات المتحدة التحق بهيئة التدريس في دائرة العلوم السياسية الإدارية بالجامعة الامريكية في بيروت بين عامي 1960 و1984، انتهت هذه الفترة بمغادرته لبنان بعدما عاش فصولاً مؤلمة من الحرب الأهلية التي عصفت به. ولقد تخللت هذه الحقبة الغنية من حياة البروفيسور إيبش الأكاديمية الناشطة سنوات أمضاها أستاذ كرسي هنري لوس للدراسات الدينية والأخلاق في كلية أمهرست (الولايات المتحدة) بين 1982 و1985، ثم أستاذًا للدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية بواشنطن بين 1985 و1986. وكان زميلاً زائرًا في جامعة كمبريدج ببريطانيا بين 1990 و1991.
على امتداد رحلة التدريس الجامعي ظل ناشطًا في ميدان البحوث والتأليف. فقد ألف وأعد أكثر من 30 كتابًا وأكثر من 100 دراسة في مختلف جوانب الدراسات الإسلامية. ومن مؤلفاته بالعربية: «نصوص الفكر السياسي الإسلامي: الإمامة عند السنة»، و«كشف تفاسير آيات القرآن الكريم»، و«الإمام والإمامة عند الشيعة» (إعداد وتحقيق)، و«الخلافة وشروط الزعامة عند أهل السنة والجماعة» (إعداد وتحقيق)، وفهرس مجلة «المنار» (أعده مع الدكتور كوسوجي ياسوشي الدكتور يوسف قزما الخوري)، و«رحلات الإمام رشيد رضا» (جمع وتحقيق)، و«السلطنة في الفكر السياسي الإسلامي» (جمع وتقديم مع كوسوجي ياسوشي)، و«صلاح الدين الأيوبي» لهاملتون جب (تحرير)، و«مذكرات الأمير عادل أرسلان» (تحقيق)، و«الأمير شكيب أرسلان: سيرة ذاتية»، و«محيي الدين بن عربي»، و«الوثائق العربية – الجامعة الأمريكية في بيروت (1963 – 1966)» - أربعة أجزاء - وبعد تقاعده عن التدريس، أسهم في تأسيس المركز الثقافي الإسلامي في بيروت ومن ثم تولى رئاسته، وكان عضو مجلس أمناء مؤسسة فون كرامر في مدينة بازل بسويسرا. ثم اختير عضو مجلس الخبراء وعُيّن مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة «الفرقان» في لندن وكان الأخير آخر مناصبه قبل وفاته – رحمه الله.
خواطر وذكريات
بالنسبة لكاتب هذه السطور، من أبرز ملامح هوية يوسف إيبش وشخصيته أنّه كان دمشقيًا «حتى النخاع»، شغوفًا بمدينته، بعبق تاريخها وياسمينها و«بحرات» بيوتها القديمة. كيف لا وهو المتحدّر من بيتين من أكرم بيوتاتها العائلية الكردية العريقة التي لعبت أدوارًا بارزة في حياة سورية السياسية: البيت الأول هو آل الإيبش (عائلة الأب) والبيت الثاني آل اليوسف (عائلة الأم). ولقد أنجب هذان البيتان ساسة كبارا تولوا الوزارة وشخصيات لامعة أخرى، منها أبوه حسين بك الإيبش، أحد أشهر صيادي العالم العربي بل العالم بأسره.
أول ما شاهدته داخل حرم الجامعة الأمريكية في بيروت كان يقود سيارته «لميني» الصغيرة، فاستغربت منظره وهو الرجل الخمسيني البدين القصير القامة كيف يقتني مثل تلك السيارة. كان أكثر بكثير مما يبدو لأول وهلة... مجرد أكاديمي وقور متجهم الوجه يدرِّس الفكر السياسي والمؤسسات السياسية الإسلامية. لكن مزاياه الإنسانية الاستثنائية أخذت تتبدى لي عندما صرت واحدًا من تلاميذته، وصار الذهاب إلى مكتبه في مبنى «جيساب هول» – حيث مقر دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة - متعة أحرص على ألا تفوتني كلما أتيحت لي الفرصة. وهناك كنت بفضولي أسأل... وكان هذا البحر المتلاطم من المعرفة يجيب، بظرفه المعهود، بلا كلل أو تبرم.
الأكاديمي... وعاشق دمشق
اعتدت سؤاله عن التاريخ الاجتماعي لبلاد الشام، وبالذات سورية، وبالأخص الأخص دمشق. كنت أسأله عنها، عن حاراتها وزعاماتها وثقافتها وفولكلورها ومهنها التقليدية، وعن دورها في النسيج الاجتماعي لسورية وعن بواطنه الرائعة المجبولة بالأصالة وعبقه من كل لون وطعم ورائحة. وكنت أقفز من موضوع إلى موضوع، تارة بغرور من يتوهم أنّه يعرف.. أو بسذاجة من أدرك أنه ما زال بحاجة إلى معرفة الكثير. وكان في الحالتين يعيدني إلى سكة التسلسل المنطقي والخلاصات المعرفية الجادة بأسلوب محبب بعيد عن «الأستذة».
أذكر في أحد أيام الربيع أنني كنت عنده داخل المكتب نتحدث عن تاريخ الإقطاع في سورية، وفجأة دق علينا الباب رجل رحّب به بلهجة من كان معه على موعد. فنهضت واستأذنته بالمغادرة، غير أنه التفت إليه وطلب مني المكوث. وعندما تردّدت برهة كرّر الطلب، لكنني لجهلي هوية الزائر فضلت المغادرة، فانصرفت. وفي اليوم التالي، بادرني بمجرد دخوله الحصة الدراسية بشيء من العتب متسائلاً عن سبب تعجلي المغادرة. فلما شرحت له أنني شعرت بتطفلي على لقاء معدّ مسبقًا، قال: «نعم، ولكنني كنت أريد منك البقاء لكي أعرّفك على أحمد حرشو البرازي... قاتل سامي الحناوي. وكان أحمد سيخبرك الكثير عن حماه وعن آل البرازي»[1].
وكما أشرت قبل فترة في مقالة لي في «الشرق الأوسط»، سألته مرة عن تجربتي الوحدة والانفصال، ومن كان مع الوحدة ومن كان مع الانفصال، فأجابني بشيء من المرارة: «والله عندما حصلت الوحدة كان معظم الأوادم معها... وعندما وقع الانفصال كان معظم الأوادم[2] معه». ثم شرح له بعمق وروية كيف أسهمت سوء تصرفات بعض الساسة والعسكريين المصريين والسوريين في حالة من النفور ساعدت «الضباط الشوام» على تنفيذ التمرد الذي أفضى إلى الانفصال.
الحرب... ثم سنوات لندن
بعد الحرب الأهلية اللبنانية، التي زرعت المآسي ودمّرت أجمل ما في لبنان، تفرّق الأهل والأصدقاء، وباعدت الظروف بين «المعلم»وطلبته ومريديه. وصرت أتسقط أخباره من معارفي. فعرفت أنه عاش لفترة في الولايات المتحدة، ثم التقينا فجأة عام 1990 من دون ترتيب مسبق في لندن، فعلمت منه أنه يمضي سنة بحثية في كمبريدج واتفقنا على التلاقي. غير أن الظروف لم تساعد بالصورة التي كنت أشتهي وإن كنا التقينا غير مرة عندما كان يأخذ لنفسه إجازة تنقله من منسك الأكاديمية الهادئ في كمبريدج إلى صخب لندن ومحبيه الكثر فيها.
بعد ذلك عاد إلى بريطانيا واستقر فيها لدى توليه مسؤولية الإدارة في «الفرقان»، وبذا عادت أيام الماضي مع بُعد إضافي أنضجته خبرة السنين. وما كان حقًا لصالحي في هذه المرحلة أنّ مقر «الفرقان»في ضاحية ويمبلدون القريبة من بيتي، وهكذا كان يتاح لي ولنفر من أصدقائي وجيراني من تلامذة الدكتور إيبش القدامى زيارته في مكتبه، ومن ثم عبور الشارع الرئيس إلى مطعمه الإيطالي المفضل لتناول الغداء معه.
وأحيانًا كانت شلة «المريدين» من تلامذته القدامى تبرمج معه، بشوق وتوق، لقاءات على العشاء في أحد مطاعم حي نايتسبريدج، قرب بيته، حيث تطول الدردشات والمسامرات إلى وقت متأخر من الليل. وفي كل مسامرة كان لنا بد لنا من التعريج على ناحية ما تتصل بـ «الشام». وهنا أتذكر كلامه ذات أمسية، عن «أن ثمة بقاعًا من العالم لا يمكن من الناحية البيئية إلا أن تكون حواضر، ودمشق محضتها اعتبارات الجغرافية والبيئة حتمية «مدينية» جعلت منها أولى حواضر البشرية. كما أتذكر في محاضرة جليلة من أواخر محاضراته في «الفرقان» كيف حمل مستمعيه معه في مشوار ممتع مع نشوء النقابات الحرفية وتطورها ودورها الديني والفكري والاجتماعي في دمشق. وكانت تلك حقًا جولة ثقافية لا تُنسى لما فيها من معلومات وأبعاد ومجالات رحبة.
المعلم والصديق
كطالبٍ، عرفتُ يوسف إيبش علامةً وأكاديميًا متميزًا لمع في تدريس الفكر السياسي والمؤسسات السياسية الإسلامية، وكانت له صولات وجولات في العديد من الدراسات البحثية الأكاديمية القيّمة، ولاسيّما في التاريخ السياسي والاجتماعي للمشرق العربي. وفي شخصه الفريد جمع توليفة نادرة من أصالة الشرق والإسلام المتنوّر السامي والمنهجية الغربية «الهارفاردية» الجادة. وكان في منهجيته سواء العلمية أو الحياتية يمقت التعصب والانعزال وضيق الأفق والجهل المتغطرس المتكبر.
وحول هذه النقطة، سألته ذات يوم عن أحد كبار أساتذة الجامعة التاريخيين ممن كان لهم أثر غير محمود في حياة لبنان السياسية، واختار لنفسه (رحمه الله وغفر له) أن يتحوّل إلى رمز للتقوقع والتعصب المقيت رغم نبوغه العلمي والثقافي، فجاء جواب الدكتور إيبش بإدانة قاسية واصفًا تعصبه بأنه «مرضيّ». ولما لمح عندي شيئاً من الاستغراب، قال بهدوء: إسمع منّي هذه الواقعة واحكم. قبل الحرب اللبنانية ببضع سنوات زار لبنان وفد أكاديمي أمريكي رفيع، وفي سياق الزيارة دعا الأستاذ المشار إليه الوفد إلى مأدبة عشاء في منزله دعا إليها مجموعة من أساتذة الجامعة كنت واحدا منهم باعتباري خريج جامعة هارفارد التي كان كان رئيسها يومذاك رئيس الوفد. وبينما نحن نتبادل أطراف الحديث بعد تناول العشاء باغتني الأستاذ بسؤال عن رأيي في رياضة مُصارعَة الثيران التي تشتهر بها إسبانيا. فأجبته: إنني شخصيًا لا أعتبر مصارعة رياضة بل هي ممارسة دموية لا إنسانية. لكنني ما كدت أنهي كلامي حتى صرخ بأعلى صوته وهو يضرب بيديه على الطاولة: «لا... لا... لا... أنت لا تفهم مغزى مصارعة الثيران. لا تفهم ما تعنيه...». ووسط ذهول الأكاديميين الأمريكيين، تابع كلامه: «إنها صورة حية تاريخية لصراع الإسلام مع المسيحية، صراع الإسلام القوي جسديا والمتخلف تقنيا الذي يمثله الثوم المهزوم حتمًا، والمسيحية الفطنة المتقدمة تقنياً التي يمثلها الماتادور المنتصر».
وكصديق لا يَمل مجلسه، وجدت يوسف إيبش فنانًا وذواقة وعلامة في الموسيقى والخط والزخارف والتحف والحرف الفنية الإسلامية. وما كان أسهل على من أسعده الله بدخول عالمه الخاص اكتشاف الجوانب الأخرى من شخصيته الغنية، البعيدة كل البعد عن صورة ذلك الأستاذ العبوس الوقور.
∞
كان الإنسان الودود الوفي، المرهف الحس والذوق، الحاضر النكتة، الخطاط والفنان وخبير الموسيقى والطرب، الذي لا يمكن أن يمل المرء مجلسه. كان «سمِّيعًا» وخبيرًا لا يُشق له غبار في الموسيقى والطرب الشرقي والفولكلور الشعبي، يمتلك مجموعات نادرة من تسجيلات سيد درويش وكثيرين من أساطين الموسيقى والغناء. وكنت قد علمت عن غير طريقه، طول باعه بجمع التراث الموسيقي الشرقي، وكيف أنّ لديه مجموعة نادرة لا تتوافر عليها حتى كبريات الإذاعات العربية.
وفي أحد آخر لقاءاتنا فاجأنا حاملاً معه مجموعة من أشرطة الكاسيت أبلغنا بفرح أنها المجموعة الكاملة لتسجيلات عمر الزعني «فنان الشعب» في لبنان. كنا ستة جمعتنا، كالعادة، مائدة عامرة في بيت الصديق الدكتور طلال فرح بشمال غرب لندن، وكان الكل متحمسًا لشأن سياسي محلي ما عاد في بالي البتة. وما يحضرني أنّ الدكتور إيبش جاء حاملاً معه لفافة قال لنا إنّها تحتوي المجموعة الكاملة لأعمال الزعني. فانصرفت عن الحديث الدائر وأخذت أسأله عنها، وما لبث أن سأل الحضور ما إذا كانوا راغبين في الاستماع فأجابوا بالإيجاب، وفعلاً شغلنا المسجل واستمعنا إلى بعض المونولوجات، بيد أنه بحساسيته المرهفة لاحظ أن البعض اختار أن يجامله وأنه ليس راغبًا بالاستماع، فاعتذر بلطف وقال: «ربما نحتاج إلى مناسبة أخرى... فلا شك أن الشأن السياسي يستحق وقفة الآن»، وبهدوء سحب الشريط وأعاده إلى اللفافة. مع أنّ غير واحد منا ألح عليه بألا يفعل. وخلال مأتمه، حرصت على تذكير ابنه الدكتور حسين بما لوالده من تراث ثقافي فريد لا يقدره حق قدره إلا الخاصة، ولعله إن شاء الله الشخص الصالح للمحافظة عليه.
رحم الله، يوسف إيبش، المعلم والباحث والعلامة الفنان والقيمة الإنسانية النادرة. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
[1] الزعيم سامي الحناوي قاد الانقلاب الذي أطاح بحكم حسني الزعيم، قائد أول انقلاب في البلاد العربية في آذار/ مارس عام 1949. ولدى إذاعة البلاغ الأول عن انقلاب الحناوي في آب/ أغسطس 1949 أعلن أن الإنقلابيين حاكموا حسني الزعيم ورئيس وزارته محسن البرازي، وحكموا عليهما بالإعدام، وثم تنفيذ الحكم فجر ذلك اليوم. ثم أطيح بحكم سامي الحناوي في أواخر العام نفسه في انقلاب قاده العقيد أديب الشيشكلي، فغادر سامي الحناوي البلاد وأقام في لبنان، حيث اغتاله أحمد حرشو البرازي بعد بضعة أشهر، انتقاما لإعدام محسن البرازي.
[2] الأوادم بالعامية السورية هي صيغة جمع لكلمة «آدمي» وتعني الشخص الطيب المتحلّي بالأخلاق الحسنة والإخلاص.
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، . 40-33 |