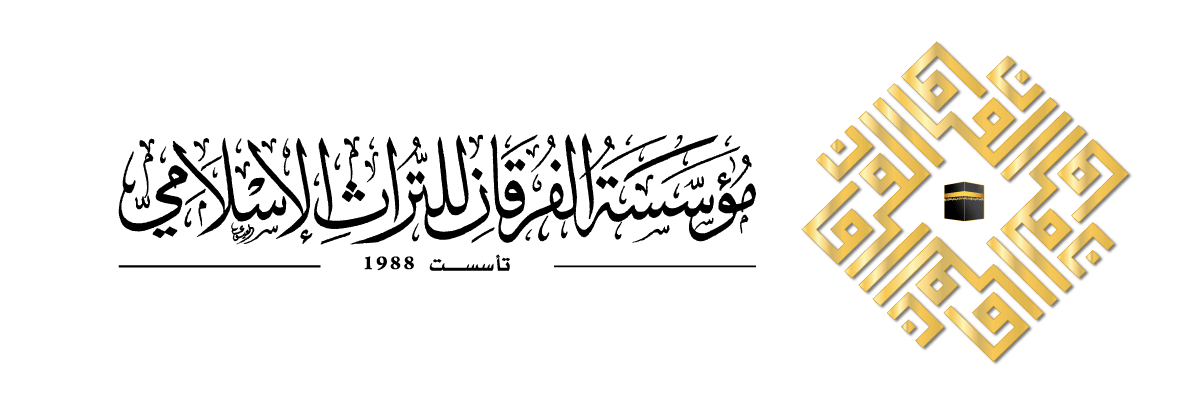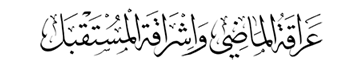أكمل الدين إحسان أوغلو
سعدت باللقاء مع يوسف إيبش أثناء إنشاء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي عام 1989، ثم كنا كثيرًا ما نلتقي في اجتماعات مجلس الخبراء، وبعد تعيينه مديرًا للمؤسسة، حتى وفاته. وكان يوسف إيبش، بصفته عالم اجتماع مفوّه واضح التفكير، ذا عقل تحليلي، يثير دائمًا إعجاب من يكلمونه أو من يلتقون به في المناسبات المختلفة. وفي رأيي أن زملاءه أفضل من يقيّمون الجوانب الأكاديمية من علمه، لذلك أترك ذلك الموضوع لهم. وخلال عمله الأكاديمي الطويل قام إيبش بالتدريس في جامعات مختلفة، مثل الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعات في الولايات المتحدة وإنجلترا، حيث اكتسب قدرًا كبيرًا من الخبرة. وقد أتيحت لي فرصة سماع بعض محاضرات ألقاها في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ومن المحاضرات التي تحدّث فيها عن الثقافة الإسلامية وما تلاها من نقاش يمكن للمرء أن يلاحظ أنه كان متعدّد الاهتمامات.
والمحادثات التالية تركّز تركيزًا رئيسيًا على لطف شمائل إيبش وتهذيبه وأخلاقه الرفيعة في سلوكه الاجتماعي وعاداته، فقد كان شخصًا يتمتّع بلباقة اجتماعية تمتزج بطبيعة أرستقراطية. ورغم أنني لم أره يرتدي ربطة عنق، إذ كان يبتعد أكثر عن الرسمية في ملابسه في شيخوخته، يمكن للمرء أن يرى أنه أرستقراطي في كل شيء. ولعل أخلاقه التي تصور آداب السلوك في أواخر العهد العثماني جاءت من أسرته التي استقرت في دمشق خلال الحكم العثماني. ومن خصاله الأخرى التي تستحق الذكر تواضعه. فحين أصبح المدير العام لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي كان يفضل استخدام لقب «المدير» وحده، وهذا من أفضل الأمثلة التي تبين شخصيته المتواضعة والتزامه بالتقاليد الأكاديمية العالمية.
وكان في اعتقادي أن سلسلة من المحادثات معه حول حياته ستؤدي إلى جمع مواد قَيِّمَة لكتابة سيرة حياته. لذلك خَطَّطْنا لهذه المحادثات أثناء زياراتي للمؤسسة. ومن سوء الحظ أن الأولى منها فقط تمت في آذار 2002 قبل وقت قصير من وقوعه فريسة للمرض. وكما سيرى القارئ أتاحت المحادثة التالية الفرصة لإلقاء الضوء على البيئة العائلية لأرستقراطي دمشقي عثماني من أصول كردية في وسط عربي، وكذلك على التقاليد المتعلقة بالزواج والطبخ التي كانت تتميز بها مدينة دمشق عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وفي هذه المقدمة الموجزة أود تقديم الجوانب غير المعروفة حتى الآن من سيرة إيبش - رحمه الله - لتكون مساهمة متواضعة للباحثين والدارسين الذين يتناولون تاريخ سورية الاجتماعي.
إحسان أوغلو:
■ اسمح لي أولًا أن أشكرك على تلطفك بقبول الاشتراك في هذا النوع من الحديث عن الأمور الهامة في حياتك. وأنا واثق أن ما ستخبرنا به سيبرهن أنه مصدر قيّم جدًا للمعلومات حول الحياة في دمشق والعالم العربي والعالم الإسلامي، على نحو يختلف عن كل ما هو متوافر لنا. لكن لنبدأ أولًا بأسرتك، فأنت من عائلة مشهورة تمامًا. وأنا شخصيًا لدي معلومات عن جدك ووالد جدك اللذين لعبا دورًا متميزًا في التاريخ العثماني، فهل لك إذن أن تحدثنا عن خلفيتك وجذورك؟
يوسف إيبش:
□ إنني أنحدر من كلا الطرفين من عائلتين كرديتين هما في الأصل من تركيا، كما هي اليوم، من منطقة ماردين وديار بكر. كان أجدادنا أكرادًا من الإمبراطورية العثمانية، وأصبحوا على ارتباط بالقوات المسلحة حين أرادت الإمبراطورية العثمانية اختيار ضباط عسكريين من أصل دمشقي لموكب الحج المتوجه إلى المدينة. كان هدفها حماية القوافل من تعديات البدو. والأمر لم ينجح حين كان والي دمشق هو أمير الحج، ففي التحليل النهائي كان المطلوب وجود قوات مسلحة نظامية ومدفعية وفرسان ترافق المحمل ومسيرته وهو يحمل الصرة. فكان من المطلوب حماية الحجاج من تعديات البدو والمحافظة على الطرق في وضع آمن، وكذلك حراسة الآبار الواقعة على الطريق، كي يستطيع الحجاج التنقل بأمان بين الآبار، لكي يكون لديهم ما يكفي من الماء لدوابهم وإبلهم وأنفسهم. كانوا بحاجة للماء للشرب والاغتسال ولسقاية دوابهم: البغال والجياد والإبل التي تستخدمها القوافل. وكان المطلوب قيام الجيش بصيانة هذه الأمور، باعتبار أن السلطان في إسطنبول يعتبر نفسه المسؤول عن سلامة هذه الطرق من الاعتداء أو من أي أذى. لذلك عُهِد بالمهمة إلى القوات المسلحة.
■ وهل تولى أحد من عائلتك، غير جدك، إمارة الحج؟
□ نعم، إذ كان جدي هو الثالث أو الرابع في العائلة الذي يتولى هذه المهمة، إذ كان أبوه أميرًا للحج، كما كان جده من قبل.
■ هل بإمكانك ذكر أسمائهم؟
□ جد جدي هو سيد باشا شمس الدين الذي كان مشهورًا في الدوائر العسكرية في ذلك الجيل. وقد نقل من ديار بكر إلى الموصل ومن الموصل إلى دمشق، ليكون بالتحديد المحافظ في موكب الحج. وتلاه صهره محمد باشا يوسف، وبعد ذلك حفيده لابنته التي تزوجت محمد باشا، وأصبح عبد الرحمن باشا أمير الحج، بالإضافة لكونه عضوًا في مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني) في إسطنبول.
■ وكان هذا هو جدك؟
□ كان هذا جدي لأمي. أما أسرة والدي، فقد كانوا بصورة رئيسية تجار ماشية وخيول. كان جدي أحمد إيبش من أشهر تجار الخيول في الهلال الخصيب، وكان يزود الجيش المصري بالخيول، وجمع ثروة من تلك التجارة. وقد عثرت مؤرخًا على ذكر له في الأرشيف البريطاني هنا في (كيو غاردنز (Kew Gardens، لأن البريطانيين أيضًا اشتروا منه الخيول للاستخدام الرسمي.
■ وهل كان من ماردين أم ديار بكر؟
□ كان من ماردين.
■ لكن أمك من ديار بكر، أليس كذلك؟
□ نعم هي من ديار بكر. وكانت هناك قرابة بين العائلتين.
■ هل يمكن من فضلك أن تذكر أسماءهم؟
□ أجل، كان جدي يدعى أحمد إيبش، كما ذكرت. وكان اسم أبيه حسين إيبش. وقد أتى حسين إيبش من سورية مع عدد من الخيول - من ماردين ومحافظة الجزيرة - وباعها على ما أعتقد للمصريين، قرب ماردين التي كانت منطقة الخيول.
■ ماذا تقصد بقولك «المصريين»: جيش إبراهيم باشا؟
□ بل بعد ذلك، بعد إبراهيم باشا. لا أدري من كان الخديوي آنذاك، ولكن أعتقد أنه توفيق، الذي كان يقوي سلاح الفرسان لديه والذي كان يتبع في تشكيله النموذج الفرنسي. كان بحاجة لخيول جيدة، وكان يحصل عليها من تجار مثل جدي الذي كان يزور بانتظام أماكن مثل العريش في سيناء ومحافظة الإسماعيلية ليبيع الخيل. وبعد أن قام بذلك، عاد حسين إيبش إلى دمشق. كان والد جدي، أي والد أحمد إيبش. عاد إلى دمشق وكان نظريًا في طريق عودته إلى بلده، ولكنه وهو في دمشق قرر أن يحج وذهب إلى الحج برفقة سيد باشا الذي كان يعرفه من قبل.
■ هل كان ذلك بعد إنشاء خط سكة حديد الحجاز؟
□ كلا، قبل ذلك. بل قبل ذلك بكثير. نحن نتكلم عن الستينات من القرن التاسع عشر. كان قد قابل سيد باشا وأودع المال الذي جناه من عملية البيع مع سيد باشا، لأنه كان شخصًا معروفًا وأهل ثقة. فقد كان يُعهد إليه بصرة الإمبراطورية العثمانية لإعطائها لأمير مكة، ولتوزيعها على البدو على الطريق، لتكون بمثابة عيدية لتهدئتهم، كيلا يهاجموا القافلة.
■ وللدفع للأشراف وإرسالها كهدية إلى مكة والمدينة.
□ نعم، كان يعهد إليه بمهمة تقديم هدايا للمؤذنين ولخادمي الحرمين، ولغيرهم من الشخصيات في مكة والمدينة. إذن كان شخصًا مشهورًا بأنه أهل للثقة وقد توجه إلى الحج معه. ومن سوء الطالع أن الكوليرا انتشرت في مكة في ذلك العام وتوفي هناك.
■ هل تاريخ انتشار الكوليرا في مكة معروف؟ وهل دفن فيها؟
□ لقد دفن هناك، وكان ابناه معه: حسين وبلال، والد جدي وعمه، ورجعا إلى دمشق مع سيد باشا في طريقهما إلى بلدهما. وقد تابع بلال الطريق وعاد إلى ماردين، حيث يوجد فيها فرع للعائلة.
■ وما اسم العائلة في ماردين الآن؟
□ تدعى عائلة إيبش. جدي أحمد، وهو أخو بلال، بقي في دمشق وتزوج فيها وولد له ابن. أحمد إيبش والد والدي استقر هناك كواحد من أعيان المدينة، لأنه كان على درجة من الثراء تؤهله للزواج من العائلات الكريمة المعروفة، وقد كان على صلة مع عدد كبير من العائلات المعروفة، مثل عائلتي العظمة ومردم بيك. أمي بالطبع كانت ابنة عبد الرحمن باشا بن محمد باشا، وهو بدوره صهر سيد باشا.
■ وما اسم هذا الفرع، أي جانب والدتك؟
□ عائلة اليوسف.
■ هل جميع الآخرين أصلهم من ديار بكر؟ وهل لا يزال يوجد لهم أقارب في ديار بكر؟
□ نعم بالطبع لهم أقارب هناك: أعتقد أن أقاربهم هم بصورة رئيسية عائلة بدرخان باشا، وهي في الأصل من بوتان. وهم أقرب الأنسباء. وقد ولد والدي في دمشق عام 1888.
■ إذن هل كان جدك لا يزال يعمل في تجارة المواشي والخيل؟
□ نعم، فتجارة الخيل هي تجارة عائلتي.
■ متى كان مولد أبيك؟
□ ولد عام 1888 في دمشق، واسمه حسين إيبش. وقد درس في المدارس النظامية في ولاية سورية العثمانية: مدارس المعارف.
■ هل درس في المدارس الحديثة؟
□ نعم، درس في المدرسة الرُشدية، حيث تعلم اللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية. ولأنه كان يعرف شيئًا من الفرنسية حين أنهى القسم الابتدائي، فقد دخل المدرسة الفرنسية التبشيرية في دمشق، المسماة مدرسة آباء العازرية، حيث تعلم بالفرنسية وفق نظام البكالوريا. وحين أكمل دراسته الثانوية وحصل على ما يعادل البكالوريا، انتقل إلى بيروت وأصبح طالبًا في الجامعة الأمريكية، حيث درس الإنجليزية والعربية ودرس في كلية التجارة. وحيث أن والده كان تاجرًا، تركزت حياتهم على صفقات بيع وشراء الماشية بين مصر وسورية. وقد درس التجارة والمحاسبة. وتخرج عام 1908 بشهادة بكالوريوس في التجارة. وعند تخرجه غادر البلاد لتولي شؤون العائلة في مصر، وأخذ معه عددًا كبيرًا من الخيول. كان يهوى السفر ويجيد ركوب الخيل.
وقد انتقى بعض أفضل الخيول المتوافرة وأخذها إلى القاهرة، حيث دخل دوائر سباق الخيل وأدخل خيوله في السباق في القاهرة. وبهذا الشكل قابل عددًا من أبناء الطبقة الأرستقراطية في القاهرة، وخاصة الأمير يوسف كمال الذي أصبح فيما بعد من أصدقائه الحميمين. فكلاهما كانا من هواة الخيل والصيد، وكان الأمير يوسف كمال عالمًا جغرافيًا معروفًا. وقد قاما معًا برحلات صيد واستكشاف في أفريقيا، موثقة بشكل جيد في كتب الأمير يوسف كمال، وكذلك حسب اكتشافي مؤخرًا في بعض مذكرات أبي وكتاباته في أدب الرحلات. وقد كتبها باللغة العربية، وهي واضحة جدًا جدًا. وهي تكمل ما كتبه الأمير يوسف كمال عن أفريقيا ومصر.
■ هل ستقوم بنشرها؟
□ إن شاء الله. أنا أنظر في إمكانية جمعها ونشرها.
■ مع هوامش من يوسف كمال؟
□ نعم. وفي النهاية، أعتقد في عام 1926، قررا الذهاب في رحلة واسعة في جميع أرجاء أفريقيا، لكن قبل ذلك قاما برحلة هامة جدًا وموثقة بشكل جيد إلى أقصى الحدود: إلى الهند وكشمير والتبت. لذلك قد يكون والدي هو الشخص السوري الوحيد الذي زار التبت.
■ هل كان ذلك قبل 1926؟
□ كانت رحلته هذه في عام 1911.
■ لابد أنه ليس السوري الوحيد الذي زار التبت فقط، بل وكذلك العثماني الوحيد، فأنا لا أعرف أي شخص آخر سافر إلى التبت.
□ نعم، توجه إلى التبت من كشمير في شمال الهند إلى نيبال، ومنها إلى التبت.
■ وهل هذا متضمن في ما كتبه يوسف كمال من أدب الرحلات.
□ نعم، وهو متضمن في ما كتبه حسين إيبش نفسه من أدب الرحلات.
■ ما هو طول هذا المؤلف في أدب الرحلات؟
□ قد يكون ما بين 400 إلى 500 صفحة.
■ هذا رائع، فهو يعني أنه في طول كتاب.
□ نعم، فقد أصابته حمى الجغرافيا، والجغرافيا عند والدي وعند يوسف كمال كانت متأثرة وقائمة إلى حد كبير ليس على رسم الخرائط، بل على وصف الجغرافيا البشرية، حسب السوابق التي وضعها إيفليا شلبي، وصف القبائل وعادات الحكام والأمراء والكثيرين من مهراجات الهند. وقام المسافران بزيارات لعدد من المسلمين والهندوس وأقاما علاقات مع كلا الجانبين. واستخدما نظام المواصلات العامة الهندية بالإضافة إلى بغالهما وقوافلهما. وكان المفترض برحلتهما الأفريقية عام 1926 أن تبدأ في الخرطوم وتنتهي في كيب تاون. وقد سافرا في خط متعرج على طول الطريق إلى البحيرات ومنابع الأنهار، وقابلا الكثيرين من رجال القبائل الأفريقية الذين احتفظ والدي لهم ببعض الذكريات الممتازة. وفي طفولتي كان يروي لي القصص، وأدهشني بكيفية تذكره لبعض الأنشودات والرقصات الأفريقية التي تؤديها القبائل، ولدينا في المنزل التذكارات التي جمعها من الصيد ومعها دروع وأقنعة جمعها أيضًا.
■ ألازالت لديك؟
□ نعم، فهي لا تزال في دمشق.
■ هل حُفِظَت في منزلك؟
□ نعم، كانت في منزلنا. وقد قررنا كعائلة أن نهديها لمدينة دمشق، لأن دمشق ليس فيها حديقة حيوانات، وهذه المجموعة من تذكارات الصيد المركَّبة والمحفوظة بشكل جيد تشكل مجموعة حسنة من الحيوانات للأطفال. فهم يقرؤون الجغرافيا ولكنهم لم يشاهدوا أي أسد أو حمار وحش قط.
■ هي إذن مجموعة كبيرة؟
□ نعم، وهكذا قررت العائلة إعطاءها لمدينة دمشق كهدية، بشرط أن تبقى المجموعة سليمة ويكون اسم الصياد وجامع المجموعة - حسين إيبش، الدمشقي - بارزًا بحيث تستثير مخيلة الصغار باتجاه المغامرة والاستكشاف.
■ وإتمامًا لقصة والدك، هل لك أن تخبرنا بما حدث منذ عام 1926؟
□ لقد عاد إلى سورية. ولدى عودته من التبت إلى سورية انضم إلى الجيش العثماني، حيث كان قد جنِّد في الجيش الإمبراطوري أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد أصبح ضابط مدفعية وعيِّن في غاليبولي حيث قاتل في معركة غاليبولي.
■ ماذا كانت رتبته؟ هل كان ملازمًا؟
□ كلا، أعتقد أنه كان يوزبا شيًا.
■ رغم أنه كان بلا تدريب وكان خريجًا في التجارة من الجامعة الأمريكية؟
□ بعد التخرج أرسل إلى ألمانيا، حيث درس العلوم العسكرية وتخرج من هناك.
■ من أرسله؟
□ أرسله الجيش العثماني.
■ هل أرسله جدك؟
□ كانت لجدي صلات في إسطنبول سهلت الأمر. وقد تم اختيار والدي من ضباط الجيش الذين أرسلوا إلى ألمانيا وألحق بسلاح الإشارة. وسلاح الإشارة هو الضباط الذين يراقبون المعركة ويرسلون إشارات إلى الأقسام العسكرية الأخرى، مثل المدفعية أو غيرها من القوات المساندة في المعركة.
■ هل تعرف أين درس في ألمانيا؟
□ أعتقد أكاديمية برلين الحربية. وهكذا عاد الآن وهو مزود تزويدًا كاملًا بالتدريب والمعرفة.
■ وهل خدم في غاليبولي؟
□ نعم، خدم في القوات العسكرية في غاليبولي؟
■ كان هذا في 1911 على ما أعتقد.
□ كان في عام 1911 و1912. وقد تم اختياره في غاليبولي ليكون ضابط اتصال لعدد من الضباط الألمان ذوي الرتب العالية. وبما أنه خدم في سلاح الإشارة وعمل بصفة ضابط اتصال وكان على معرفة بالضباط ذوي الرتب العالية، فقد نقل فيما بعد إلى قناة السويس.
■ هل كان مع جمال باشا؟
□ مع جمال باشا، وأصبح أحد ضباط اتصال جمال باشا، وأتيحت له معرفة جمال باشا معرفة جيدة جدًا. وقد جُرِح في المعركة وأًخِذ إلى مصر بصفة أسير جريح. وهناك استأنف صداقته مع الأمير يوسف كمال، وآخرون ساعدوه من الجانب الآخر.
■ هل أطلق سراحه أم بقي أسيرًا؟
□ بقي أسيرًا وأطلق سراحه بعد انتهاء الحرب.
■ في أي معسكر كان في مصر؟ - كانت توجد معسكرات في الإسكندرية وسيدي بشر والسويس - هل تعرف أين سُجِن؟
□ أعتقد أنه كان في سيناء لفترة، في معسكر حجر صحي، بسبب تفشي مرض التيفوس في المعسكرات الأولى في الإسماعيلية. وقد أُرسِل كثير من الضباط الذين أخرجوا منها إلى معسكر حجر صحي عند رأس شبه جزيرة سيناء.
■ ولكن هل كانت المعسكرات الرئيسية في سيدي بشر في الإسكندرية؟ هل لديك أي سجلات توثق ذلك؟
□ أعتقد أنه يوجد سجل للمكان الذي كان فيه ضمن أوراقه. أعتقد إن لم تخني الذاكرة أنه كان لفترة في الحجر الصحي، بسبب انتشار مرض التيفوس. كان أسيرًا لدى الجيش البريطاني المصري، أعتقد أن أللنبي كان المسؤول عن ذلك القطاع. وحين انتهت الحرب عاد إلى سورية.
■ لقد أطلق سراحهم وأرسلوا إلى تركيا، كان ذلك عام 1917 أو 1918. فهل أتى مباشرة من هناك إلى دمشق أم قَدِم عن طريق تركيا؟
□ أعتقد أنهم نقلوه بحرًا إلى تركيا، وأعتقد إلى إزمير. نزلوا إلى البر في إزمير، حيث إن لم تخني الذاكرة كانت توجد حامية بريطانية وقوة يونانية. وذلك هو المكان الذي أطلق فيه سراحه. واستكملوا الإجراءات الرسمية.
■ وهل سافر من هناك إلى دمشق؟
□ من هناك توجه إلى دمشق: سافر إلى حلب بالقطار ومن حلب ذهب إلى رياق في لبنان، ومن رياق إلى دمشق.
■ هل هذا خط سكة حديد الحجاز الشهير؟
□ نعم، هو فرع من خط سكة حديد الحجاز.
■ إذن فقد عاد. ترى هل عاد بعد ذلك إلى سيرته الأولى؟
□ عاد لوجود بيت للعائلة، وكان جدي أحمد إيبش لا يزال على قيد الحياة، لذلك عاد إلى بلده.
■ كان أعزب بالطبع؟
□ كل تلك الفترة كان أعزب. وفي أواخر 1918 على ما أعتقد تزوج أمي.
■ كيف تعرف على والدتك.
□ في الواقع جدي أحمد باشا كان يعرفه وقد أخبرتني جدتي والدة أمي، التي كانت من آل العظم أنه جاء أبي يخطب أمي، لم تكن جدتي مقتنعة تمامًا بهذا الزواج، وحاولت التدخل لدى جدي، عبد الرحمن باشا. ووالد أمي أخبرها أن والدي كان قبل كل شيء رجلًا واسع الخبرة في الحرب وفي الرياضة، والصيد والجغرافيا، وأنه سيكون عونًا كبيرًا لهما في شيخوختهما. كان أولادهما صغارًا، في حين أنه شاب مكتمل النضج ذو مزاج متكامل منفتح. وأنه مقاتل جيد وعالم جيد، مكتمل الثقافة، ذو وفرة من الرزق وسمعة لا تشوبها شائبة. وهكذا تزوج والدي من والدتي.
■ وكم عدد الإخوة؟
□ كان لأبي أخ واحد هو نوري بيك، الذي انخرط فيما بعد في السياسة السورية وأصبح وزير دولة.
■ في أية حكومة؟
□ حكومة شكري القوتلي، وفيما بعد على ما أعتقد مع الشيشكلي وغيره.
■ هل كان رجلًا عسكريًا؟
□ كلا لم يكن رجلًا عسكريًا. كان مشهورًا في مجال الزراعة، لأنه ذهب إلى لندن ودرس الزراعة قبل عودته إلى سورية. وفي ذلك الوقت كان جزء من ثروة العائلة مستثمرًا في الزراعة. فقد اشتروا أرضًا وانخرطوا في نشاطات زراعية كثيرة، وأعتقد أنهم عملوا أيضًا في تجارة القمح والحبوب.
■ إذن هل قام والدك بمتابعة التجارة أم لم يفعل ذلك؟
□ كلا، ففي ذلك الوقت كانت تلك التجارة قد تدهورت. فالطلب على الخيول من قبل المصريين هبط إلى حد كبير، لذلك اشترك أبي مع أخيه في الزراعة وتجارة القمح والشعير والحبوب، مثل العدس والذرة وما شابه، وأعتقد أنهما حققا أرباحًا جيدة، لأنهما فيما بعد زادا من حجم ملكيتهما للأرض خلال فترة الانتقال من الإمبراطورية العثمانية إلى سلطة الانتداب السورية. هذا الانتقال وجه ضربة قاسية للاقتصاد في سورية الذي انتقل من قاعدة الذهب إلى الفرنك الفرنسي، مما أدى إلى قدر كبير من التضخم وجعل الكثيرين من ملاك الأراضي يبيعون أراضيهم.
■ إذن والدك وعمك اشتريا تلك الأرض.
□ اشتريا مساحة كبيرة من الأراضي بسعر جيد جدًا.
■ متى توفي جدك؟
□ توفي جدي أحمد إيبش تقريبًا قبل الحرب العالمية الثانية تمامًا، في عام 1939.
■ إذن كان لا يزال موجودًا حين تزوج والدك وعمك. هل أقاما معه في المنزل؟
□ نعم، كان بيتًا دمشقيًا كبيرًا في سوق ساروجة.
■ بأي اسم كان المنزل معروفًا؟
□ منزل إيبش، شارع عبيد، وهو بالعربية حارة عبيد، بيت إيبش. وهو لا يزال موجودا.
■ وهل لا زالت عائلتك تقيم فيه؟
□ كلا، فقد صادرته وزارة شؤون العمل.
■ العمل؟
□ نعم، العمل.
■ وهل لا يزال في يد أسرتك الآن؟
□ نعم، إنه من أجمل بيوت دمشق. مساحته حوالي 6000 متر مربع، بيت كبير جدًا.
■ هذا هو المكان الذي عاش فيه جدك أحمد إيبش ووالدك حسين إيبش وعمك نوري إيبش. (نعم.) وهو المكان الذي توفي جدك فيه. ترى حين تزوج والدك، هل بقي مع أبيه أم انتقل إلى منزل آخر؟
□ كلا، لقد جرى شيء من التنظيم لقسم جديد من المنزل بطريقة أتاحت لنا الاستقلال ضمنه وفيه. أتت أمي لتقيم مع والدي فيه. وكان ما يسمونه الدمشقيون البراني، الذي يضم السملك، وفيه غرف كثيرة وصالات استقبال كثيرة ومرافق عديدة ومطبخ خاص. وقد قررت العائلة إعطاءه لأبي الذي كان الابن الأكبر، ولعله الأكثر كسبا ودخلًا. ومن خلال رحلاته الأوربية وصلاته في مصر اكتسب ذوقًا راقيًا جدًا. فجزء المنزل الخاص بنا مثلًا كان فيه غرفة الطعام الوحيدة في المنزل، من حيث توجد طاولة طعام وكراسي فيها، غرفة خاصة مكرسة فقط لتناول الوجبات. الباقي كان على الطريقة الدمشقية القديمة في إحضار الطعام على صوانٍ وبساط والجلوس حوله.
■ إذن هل كان المنزل جزئيًا على الطريقة الفرنسية؟
□ نعم، كان على الطريقة الفرنسية. وكذلك فإن والدتي من عائلة غنية. وأتت ضمن جهازها بالأدوات الفضية والسكاكين وباقي تلك الأشياء، واعتنت اعتناءً خاصًا بالتطلي [الحلوى التركية]، لأنه في استقبالات النساء كان التطلي يقدم على صوانٍ خاصة مع صحون صغيرة خاصة وشوكات خاصة.
■ لنعد الآن إلى الزواج أو ما قبل الزواج. ما اسم أمك؟
□ وجيهة هانم.
■ كيف كانت تربيتها؟
□ ربتها في البيت مربية أتت من إسطنبول. أعتقد أنها كانت من أصل يوناني.
■ هل تتذكر اسمها؟
□ نعم، صوفي كيكا. أتذكره جيدًا لأنها توفيت في البيت، وكانت امرأة شديدة التهذيب. وقد علمت أمي أنواعًا كثيرة من الأمور الراقية. عزف البيانو، واللغتين الفرنسية واليونانية، ولذلك كانت أمي تعرف اليونانية والتركية والعربية والفرنسية بالطبع. وهكذا كانت عائلة جيدة الثقافة، عائلة اليوسف.
■ إذن تعلمتْ في البيت. ألم تذهب إلى المدرسة؟
□ كلا. لم تدخل مدارس. كانت لها مُدرِّسات يأتين إلى المنزل.
■ هل كانت الابنة الوحيدة؟
□ لا، كانت واحدة من أربع بنات. ومعهن أربعة أبناء، والسيدة صوفي كيكا، وغيرها، ساعدن في تربية البنات وتعليمهن.
■ هل أتت المربية إلى منزلكم عند زواج والديك؟
□ نعم أتت إلى منزلنا.
■ وبأية لغة كانت أمك تتكلم مع المربية؟
□ كانتا تتحدثان بالفرنسية.
■ ربما أنها ووالدك أخبراك كيف تم زواجهما.
□ في الواقع أنهما تزوجا بالطريقة التقليدية - الطريقة الدمشقية - بعد فترة خطبة لم تزد على ثلاثة شهور. بعدها احتفلا بكتب الكتاب، وهو توقيع العقد وبعده العرس، تحقيق الزواج في المنزل.
■ أين أقيم العرس؟ هل كان في منزل والدك؟
□ كلا، كانت العادة في دمشق أن يكون العرس في بيت والد الزوجة، الذي يقيم حفلة كبيرة، وكان عرس والديّ في منزل أبيها.
■ وأين كان بيت والدها؟
□ كان في الشارع نفسه: سوق ساروجة، ولكن ليس في الحارة نفسها.
■ هل تتذكر الاسم؟
□ نعم، اسمها حارة الورد. منزل ابراهيم باشا اليوسف. وهو لا يزال موجودًا، لكنه أصبح مؤلفاً من شقق صغيرة. لم يهدم، بل قسِّم إلى شقق صغيرة عديدة وأُجِّر من قبل الحكومة، لأنه صودر مع ثروة آل اليوسف في ظل الاشتراكية، وهو بجوار منزل محمد فوزي باشا العظم الذي كان آنذاك وزير الأوقاف في الإمبراطورية العثمانية. وهو والد خالد بيك العظم. وقد صودر هذا من الحكومة أيضًا وحُوِّل إلى متحف من نوع ما، وقد قام فنانون إيطاليون بتجديده مؤخرًا، وأفسدوا حقًا الطابع الدمشقي النقي. وهو الآن مفتوح لعامة الناس للزيارة.
■ وهو مجاور لدار جدك؟
□ نعم، كانا في الأساس منزلًا واحدًا ثم جرى تقسيمه فيما بعد.
■ إذن كانت حفلة العرس في بيت والدها؟
□ حسب ما جرت العادة. كان العرس دائمًا يقام في منزل الوالد، ويتكون من المأذون الذي يأتي ليكتب العقد، عقد النكاح المأذون في الشريعة، ثم يلي ذلك حفل كبير.
■ هل كانت حفلة مختلطة؟
□ لا، لم تكن مختلطة، ولكن البعض كانوا يتسللون - بعض كبار السن من رجال العائلة يتسللون - لأن حفلة حرملك كبيرة كانت تقام في قسم النساء ويحضرون «كييفة»، أي من يغني ويرقص. وكانت توجد مغنيات وراقصات دمشقيات مشهورات، وعن بنات مكنو اللواتي ورد وصفهن في التاريخ المحلي بأنهن العائلة اليهودية التي كانت لديها هذه البنات اللواتي يرقصن ويغنين. وقد حافظ أحد الأصهار على بعض صورهن ورأيتُ بعضها. وكانت أمي تقول: «هذه ريجينا وهذه راشيل» أو اسم آخر، وتعدد أسماءهن. كانت تعرف الأسماء معرفة ممتازة. كنت أقول: «ماما، أين حدث أن تعرفتِ عليهن؟» فتقول: «قابلتهن، أتين إلى عرسي». وكانت هناك أيضًا راقصة شرقية. كان اسمها ملاكي جاغاتي. وكانت أيضًا يهودية. كان لها تخت موسيقى وترقص رقصًا شرقيًا على الطريقة المصرية.
■ بعد العرس، أخذها والدك؟
□ نعم، إلى منزله في موكب، وهو عبارة عن عربات تجرها أحصنة، وتكون العروس في عربة، وأمامها يكون مسؤول الأمتعة. ويكون معه ما يسمى جهاز العروس: ملابسها وممتلكاتها الشخصية والهدايا كالسجاد والأدوات الفضية والخزفية - كان يوجد الكثير من الخزف الصيني - وكان الناس في الطريق يَعدّون العربات التي تمر، والخاصة بعرس فلانة من الناس. ثم آخر شيء توصل العروس إلى منزل زوجها. وقد تكون الأحصنة التي تجر عربتها بيضاء، ثم يحيط بها أقرباء العريس، للدلالة على أنها تنتقل من منزل حسن التربية والحماية إلى منزل آخر حسن التربية والحماية. وكان هناك عدد كبير مما يمكن أن تسميهم القبضايات ويقومون بإطلاق أسلحتهم النارية في الهواء احتفالًا بالمناسبة.
■ بما أن داري الجدّين كانا في الحي نفسه - حارة سوق ساروجة - أعتقد أن المشوار لم يستغرق طويلًا من منزل إلى آخر.
□ كلا، قد يكون خمس عشرة دقيقة كحد أقصى. لأنه يجب أن يسيروا بسرعة معينة، فالعراقة تقتضي ألا تجري، كيلا توحي أن منزل والد العروس يتخلص من شخص غير مرغوب فيه، أو أنهم على عجلة للمطالبة بحقوقهم، فهذه هي الأكابرية كما تعلم، ويكون هناك مغنون.
■ على الطريق؟
□ على الطريق. يقوم أحد الأشخاص بالإنشاد.
■ هل شاهدت شيئًا مماثلًا في صباك؟
□ إحدى عماتي، وهي الآن في مصر، تزوجت في بيت جدي حين كنت صبيًا، وقد حضرت عرسها. رأيت كل الاستعدادات والتجهيزات وفرش سجاد إضافي على الأرض المكسوة بالبلاط في الباحات الداخلية.
■ في باحة منزلكم؟
□ نعم، ووَضْع الفواكه والأطعمة والحلوى على الموائد، بينما تعلق على الأشجار داخل الباحة مصابيح ملونة، لإضافة جو احتفالي، وكان هناك رقص كثير، ولم يقتصر الأمر على مجيء راقصة تهز بطنها ولكن عددًا كبيرًا من السيدات رقصن أيضًا «رقص الهوانم» فيما بينهن، ليُعرف أنهن يجدن الرقص. كانت هناك أغان وما يمكن تسميته مدائح - مثل النوع الخاص بالمولد - ثم بالطبع ينتهي الكتاب، أي يعقد المأذون العقد.
□ بعد إنهاء عقد النكاح يبدأ الغناء والرقص، ليس فقط رقص الراقصات المحترفات بل وأيضًا الحاضرات. وهذا ما كان يسمى في دمشق ومصر «رقص الهوانم». والكثيرات من الهوانم الشابات يستهدفن من قبل عائلات أخرى التي لديها شباب في سن الزواج، فأعضاء الأسرة كن يراقبن الشابات في تلك الأعراس ليقررن من منهن تحسن الرقص، وتأكل بطريقة مرضية، بشيء من الرقي، وطريقة تصرفها ونظرتها ومحافظتها على زينتها (مكياجها). وربما قبل ذلك يراقبنها في الحمام العمومي حين يذهبن للاستحمام ليعرفن ما إذا كان جسمها حسن التكوين، وهكذا يصفونها لعريس المستقبل، إذ لم يكن بإمكان عروسي المستقبل أن يرى أحدهما الآخر قبل إبداء النية الجادة وقبولها. فالتفاصيل الأخرى تراها إحدى النساء وتصفها، وتراقب أيضًا حين تقوم بخياطة شيء ما، وإذا كان الخيط طويلًا فهي كسولة، لأن ضم الخيط بالإبرة مهارة لا تريد الكثيرات من النساء القيام بها كثيرًا، لذلك إذا كان الخيط قصيرًا معنى ذلك أنها غير مستعجلة وتستطيع القيام بذلك. وهكذا تجري مراقبة جميع هذه الأمور بدقة وتتكون فكرة ما إذا كانت مناسبة للمصاهرة. وتلاحظ النساء أيضا في المرشحة للزواج طريقة تحيتها للناس، وطريقة إلقائها السلام وإبدائها الاحترام. وبالنسبة لبعضهن تلك فرصتهن لإظهار إجادتهن للرقص ولإظهار الرشاقة والمحافظة على الإيقاع، في حركة أجسامهن، وهي طريقة مشروعة في التعبير عن أنفسهن في عرس صديقة عزيزة أو أحد الأقارب. فالكثير يجري وراء الكواليس في تلك الاجتماعات والأعراس.
■ والآن جاء والدك بوالدتك إلى بيت جدك. وأوجدوا لهما مكانًا ليسكنا فيه. هل كان مولدك هناك؟ هل كنت الابن الأول؟
يوسف إيبش:
□كلا، لي أخت أكبر مني، إحسان. وقد ولدت قبلي بعامين في دمشق في منزل العائلة.
■في أي عام ولدت؟
□ أعتقد في عام 1925. أنا ولدت في بيروت لأن جدي عبد الرحمن باشا كان له منزلان في سوق الغرب في لبنان، واعتادوا الذهاب إلى هناك في الصيف. وهكذا كانت العائلة تنتقل. كانت جدتي تذهب هناك و...
■ ما كان اسم جدتك؟
□ فايزة هانم.
■ هل كانت زوجة عبد الرحمن باشا؟
□ كانت ابنة خليل باشا العظم، أخي محمد فوزي باشا العظم، الذي كان آنذاك وزير الأوقاف. وكان خليل باشا والي دمشق.
■ في أية فترة كان الباشا والي دمشق؟
□ خلال الحرب العالمية الأولى.
■ هل كان ذلك في العهد العثماني؟
□ نعم، وكانت جدتي تعود إلى سوق الغرب كل عام، حيث كان لهم بيتان.
■ وهل هذان المنزلان لا يزالان قائمان أم دمِّرا؟
□ لقد دمرا في الحرب الأهلية.
■ وهل كان منزل عائلتك حتى ذلك الحين؟
■ نعم، وأمي وخالاتي المتزوجات كن يذهبن إليه مع أمهن - كانت الجبال اللبنانية منعشة وتطيب الإقامة فيها في الصيف - وكن يذهبن تباعا من دمشق إلى عاليه، القريبة جدًا من سوق الغرب، وينزلن في عاليه ويتوجهن بالعربات أو بأية واسطة للوصول إلى منزليهما. وفي ذلك العام - عام 1927 - حدثت ثورة سورية ضد الانتداب الفرنسي.
■ يوسف العظمة، الخ...؟
□ كلا، يوسف العظمة، كان قبل ذلك، عند دخول الفرنسيين سورية أثناء حكم الملك فيصل.
■ من كان في السلطة في عام 1927؟ من كان رئيس الحكومة السورية؟
□ كان دماد أحمد نامه بيه أحد المعارضين العثمانيين.
■ نعم أعرف ذلك. كان صهر السلطان عبد الحميد الثاني ومتزوجًا من عايشة سلطان.
□ نعم كان هذا الشخص هو المسيطر في سورية. لقد قاوموا الاحتلال الفرنسي وجرى تمرد ضد الفرنسيين، ولم تكن الطرقات آمنة أبدًا وكانت أمي حاملة بي وبأخي، فنحن توأمان، واستقر القرار على أن ينزلن إلى بيروت ويستأجرن بيتًا هناك، وقد قمن بذلك، وولدت هناك.
■ لمَ لم يذهبوا إلى بيت جدك؟
□ يوسف إيبش:
□ كان المنزلان في سوق الغرب واضطررن لترك المنتجع الصيفي والنزول إلى بيروت، إذ إن الإقامة فيهما في الشتاء صعبة جدًا. لذلك اضطررن للحصول على شقة في بيروت. ولذلك السبب ولدت أنا وشقيقي التوأم زياد، هناك.
■ بعد أن ولدتما هل عدتم إلى دمشق؟
□ يجب معرفة أنه في الماضي لم يكن مكان الميلاد مهمًا في التسجيل. فسجلك هو في مكان سجل أبيك وأمك، ولذلك يجب تسجيل المولود حيث يكون والداه مسجلان، وهكذا عدنا إلى دمشق وهناك يوجد السجل، سجل العائلة، أو ما يسمى خانة النفوس.
■ إذن كم كان عمرك حين عدتم؟
□ أعتقد أن عمري كان بضعة شهور. أخذوني إلى دمشق. عادت أمي وعادت جدتي وعاد الجميع إلى البيت، وبيتنا كما حاولت أن أصفه كان منزل العائلة الكبيرة، لذلك في بيت جدي - عبد الرحمن باشا - كان العاملون كثر. كانت صوفي كيكا مربية الأطفال، ولكن كان لديهم أيضًا مطبخ كامل التجهيز وطباخ شهير، وهو شهير بمعنى أنه علَّم الدمشقيين الطبخ الراقي. واسمه حجي نظيف.
■ هل كان طباخ عبد الرحمن باشا؟
□ نعم، كان طباخ عبد الرحمن باشا. وقد أتى من تركيا من مطبخ السلطان حين كان على عبد الرحمن باشا الذهاب إلى الحج، وكان عليه استضافة مهراجا حيدر أباد الشاب، الذي كان سيتزوج من عائلة السلطان. لذلك قال السلطان: «خذ حجي نظيف هذا، وسيطبخ طعامًا جيدًا له» فالطعام الذي يناسب مذاق أمير، أو مهراجا، يجب أن يأتي من إسطنبول، وحجي نظيف - هذا هو السبب في أنه حجي - فقد ذهب مع جدي إلى الحج.
■ هل ذهب معه في الصرة؟
□ نعم، كانا يتوقعان تجهيز المكان لاستقبال هذا الصهر الشاب للسلطان.
■ هل كان صهر آخر الخلفاء، عبد المجيد أفندي؟
□ صهر الخليفة، نعم. وقد عاد معه إلى دمشق حيث بقي فيها، وجدي والعريس الشاب تابعا طريقهما إلى إسطنبول من أجل العرس والاحتفالات بالتحالف بين الرجلين: مهراجا حيدر أباد وخليفة اسطنبول.
■ أكان ذلك في عام 1924؟
□ نعم، 1924. بقي حجي نظيف في دار جدي. كان له مطبخ هائل، وأعني بمطبخ هائل أنه ربما كان بحجم منزل حديث في لندن طوله حوالي 10 أمتار وعرضه 6 إلى 7 أمتار، وكان له الكثير من المساعدين والمتدربين، وكان حجي نظيف رجلًا شديد الوسامة، فهو رجل أبيض طويل. وحين كان يشمر كمية ليتوضأ للصلاة كنت ترى أنه لم يكن كثيف الشعر كشخص عربي. ولسبب ما أعتقد أنه كان فيه عرق شركسي، لأنه لم يكن مثل الأتراك العاديين. كان شديد التدين وشديد الاستقامة. كان دائمًا يذكر اسم الله ويبسمل قبل القيام بأي شيء في المطبخ، مثل تقطيع اللحم وتقطيع الخضار. كان دائمًا يبسمل وجعل الآخرين يفعلون ذلك أيضًا، لأنهم كانوا متدربين على يده وكان يريدهم أن يتعلموا اللغة الصحيحة والأدعية الصحيحة، وكان أحيانًا ينزل بهم العقاب الجسدي بضربهم، ومن الواضح أنه كان ينتمي إلى مهنة هو فخور بها. وفي أيام العيد كان ينهض ليحيي الهانم، ليقول لها عيد مبارك، بارتداء ملابسه التقليدية. وكان له مئزرٌ كبيرٌ مصنوع من الجلد، وله كلاليب يعلق عليها أدواته المطبخية المطلية بالفضة، وكان له قلبق يضعه على رأسه.
■ ما كان لونه؟
□ أسود وله أشرطة حمراء على الجانب.
■ هل كانت الأشرطة على جانب القلبق؟
□ كانت في الداخل، مثبتة عليه. وكان يقف، وفي ذلك الحين كان قد تلقى عدة أوسمة من الأتراك أنفسهم - من العثمانيين - ومن الفرنسيين الذين ذاقوا طعامه.
■ هل حصل على أوسمة بسبب طعامه؟
□ نعم.
■ هذا رائع.
□ وأعطي أوسمة من السوريين. وكان يضع ميدالياته وتتدلى أدواته من المئزر الجلدي البني الغامق. كان شخصًا نابضًا بالحيوية جدًا. وكان لديه فم سيجارة - أظن أنه كان من الكوربا المصرية - ماذا يسمونها؟ - كان فيه اصفرار ويبدو مثل الكهرمان.
■ نعم كهرمان، من النوع السميك.
□ كان يلف سجائره بطريقة غربية، ثخينة جدًا في الطرف الذي يشعله، ويتعجب الناس من الكيفية التي يلفها بها. ويبدو أنه بدأ التدخين في سورية، حين قدم إلى دمشق، وتعلم كيفية لف السجائر من ضابط هرم متقاعد روى له قصة محاكمة فؤاد باشا لأعيان دمشق بعد مذبحة عام 1860. هذا الضابط أرسله إلى دمشق الصدر الأعظم (كبير الوزراء) حين حوكم كثير من الضباط وحُكِم عليهم بالإعدام لإخفاقهم في منع الشغب ومذبحة النصارى في المدينة. واعتاد حجي نظيف أن يروي قصة ضابط كان سيعدم. فقد قدم له شخص يدعى المشير سيجارة قبل أن يصطف الضباط لإطلاق الرصاص عليهم - فهؤلاء الضباط أعدموا رميًا بالرصاص وليس شنقًا - لكن الرجل رفض أن يأخذها. وأصر المشير عليه: «خذها، فقد تكون آخر سيجارة لك». فقال الرجل المحكوم: «كلا، لن أدخن إلا في الجنة، سأنهي صيامي في الجنة. أنا بريء، وإذا شاء السلطان أن يعدمني، فليكن كما يشاء».
■ ثم أصبح لبنان وحدة إدارية مستقلة: المتصرفية؟
□ نعم، هذا صحيح، وحجي نظيف كان فخورًا بأن ذلك الرجل لف السيجارة وتلقى الرفض من ذلك الشخص قائلًا: «لن أدخن إلا في الجنة».
■ إذن الرجل الذي لف السيجارة كان المشير، هل كان صديق حجي نظيف.
□ نعم، علمه كيفية لف السجائر.
■ متى أتى حجي نظيف إلى منزل والدك؟
□ أتى حجي نظيف إلى منزل والدي بعد الثورة السورية. كان الفرنسيون يجعلون البقاء صعبًا بالنسبة لبعض الأتراك المستقيلين، وقد توسط والدي وجاء به إلى منزله.
■ ولكن هل كان جدك على قيد الحياة؟
□ كلا، كان جدي قد توفي عام 1920.
■ فهمت، وهل لم يكن لحجي نظيف أي تغطية؟
□ لم يكن له تغطية كبيرة سوى أن أبي كان يحبه ويحسن معاملته إلى حد كبير. وكان من المشهور أنه يتلقى راتبًا أعلى من راتب وزير دولة، وقد شجعه على إدخال أولاده في مدارس جيدة. والآن أحد أبنائه طبيب أسنان معروف جدًا في دمشق، اسمه حمدي نظيف.
■ وهل لا يزال حيًا؟
□ هو على قيد الحياة وهو طبيب أسنان معروف في دمشق. وابنه الأصغر إسماعيل نظيف أصبح خبيرًا في المتفجرات الكيميائية، وانتهى الأمر به في ألمانيا في شركة في شتوتغارات بصفة خبير مخبري. وقد درس الكيمياء فيما بعد. أرسله الجيش السوري إلى فرنسا لدراسة الكيمياء، وخاصة المتفجرات، وقد سُرِّح من الجيش فيما بعد، ووجد هذه الوظيفة في ألمانيا. وفي آخر مرة قابلته كان قد تزوج امرأة ألمانية شقراء جدًا.
■ هل كان حجي نظيف يقيم في منزلكم، أم كان يسكن في بيت آخر؟
□ كلا، كان له بيت مجاور لبيتنا، منزل صغير.
■ هل كان ضمن المجمع نفسه؟
□ كلا، كان منزلًا مستقلًا.
■ إذن هذه كانت إحدى الأسر - حجي نظيف والمربية اليونانية؟
□ نعم، وكان يوجد كبير للخدم، رجل يخدم على مائدة الطعام؟
■ هل كان يدعى سفرجي؟
□ كان السفرجي يدعى ميشيل - ميشيل معلوف من زحلة - وكان من عادته ارتداء سترة بيضاء وقفازين أبيضين حين يقدم لطعام. وكانت توجد عدد من النساء يعملن. كانت توجد امرأة أرمينية أتت مع اللاجئين الأرمن وربتها جدتي. كان اسمها دكرانوي وكان أخوها ليفان سائق أبي.
■ هل كانا يتكلمان باللغة العربية.
□ نعم، كانا يتكلمان العربية. دكرانوي تعلمت العربية ولكنها لم تنس اللغة الأرمنية.
■ كانا من الأناضول، فهل كانا يجيدان التركية؟
□ نعم، تلك كانت اللغة التي يتحدثان بها في المنزل مع والديّ، ولو كنت ممن يلتقطون اللغات بسهولة لتعلمت ما يكفي من التركية والأرمنية لأنهما كانتا حولنا طوال الوقت.
■ إذن تلك كانت الأسرة. هل كانت والدتك مسؤولة عن هؤلاء الأشخاص؟
□ نعم، كانت ربة المنزل، وهي التي توزع الواجبات والمهمات، الخ...
■ فلننتقل الآن لطفولتك وكيف كانت تربيتك؟
□ لقد ربيت على الاعتقاد أن العلاقات البشرية تستند إلى أخلاق ومعاملات أساسية. كان أبي يقول: «يجب أن تتعلم أصول معاملة الكبار في السن، كيف تعامل الصغار، كيف تعامل أقرانك، كيف تعامل سيدة، كيف تعامل سيدًا». وكان كل شيء هو: «في إسطنبول يفعلون هذا أو ذلك، وفي ألمانيا يفعلون هذا أو ذاك». كانت دائمًا توجد نقطة مرجعية. وقد نشأت بفكرة أن أكثر الناس رقيًا في العالم ويستحقون التقليد والمحاكاة هم الأتراك. الأتراك العثمانيون كمجموعة. من الأفراد بالطبع الأنبياء والصحابة. وفيما عدا ذلك، الآداب العامة - كيفية اللبس، كيفية التحرك، كان من الضروري قول «لطفًا» حتى للخدم. «رجاءً افعل هذا أو افعل ذلك». لا تقول لخادمة: «يا روزا، أعطني هذا». وإنما: «الرجاء يا مدام روزا، هل يمكن أن تقدمي لصديقي شيئًا من الليمونادة». أشياء من هذا القبيل، فمعيار السلوك والتربية كان من إسطنبول - وبالنسبة للسيدات طريقة لبسهن وطريقة تصفيف شعورهن - حيث كن يستخدمن قطعة من قماش الموسلين يربطن بها شعورهن.
■ هل كانوا يسمونها «كوبلو زادة»؟
□ نعم، «كوبلو زادة»
■ هل كانت والدتك تلبس بهذا الشكل؟
□ نعم.
■ هل لديك صورٌ لهذا الزي؟
□ لا، لا يوجد لدي، ولكن لن يكون من الصعب العثور على بعض الصور. عليّ أن أسأل أختي إذا كان لديها أي من صور أمي في هذا النوع من الزي. وأنا متأكد أنها في آخر حياتها كانت تضع «قمطة».
■ لعلك تود التوقف هنا؟ ولعل الأفضل أن نتابع الحديث غدا.
□ إن شاء الله.
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، 503-532. |