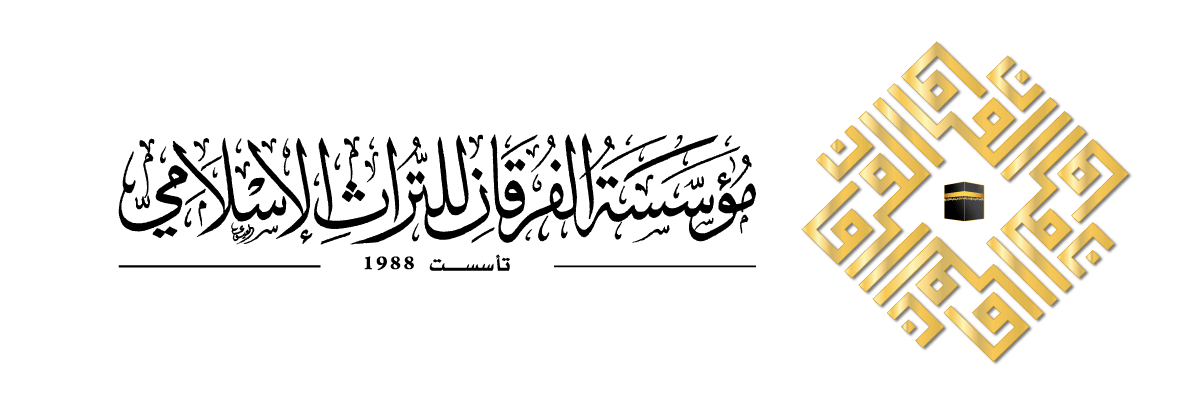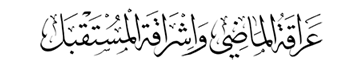قيصر موسى الزين
محتويات المقال
مقدمــة
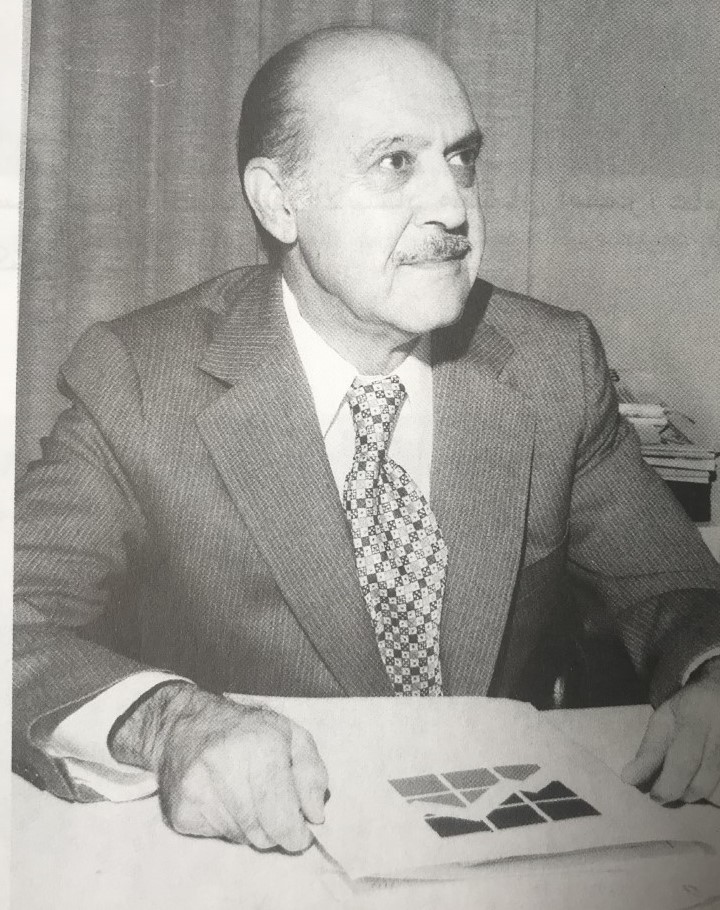
تتناول هذه الدراسة واحدًا من الجوانب العديدة في إنجازات صلاح الدين المنجد العلمية والفكرية، وهو ما يتصل بكتابته للتاريخ الإسلامي الاجتماعي، وذلك في اثنين من أهم ابوابه: التراجم وتاريخ المدن. ولا بد من التنبيه هنا إلى الاتصال والتداخل بين هذين الجانبين، خاصة وأن مدخل المنجد إليهما واحد وهو تحليل المصادر التراثية.
إن منهج هذه الدراسة يقوم على تحليل بعض كتابات المنجد ذات الصلة بالموضوع، وذلك من منطلق مناهج ما يعرف بتحليل «النص»1. ونسبة لأن المنجد يميل في كتاباته إلى الإيجاز فقد جاءت كتبه في شكل مقالات تتميز بوحدة الموضوع في إطار كل مجلد مستقل. لذلك يمكن القول بأن المنجد عالج كتابة التاريخ الإسلامي في شكل مقالات، ومن هنا جاء اختيار عنوان هذه الدراسة.
إن كتب المنجد موضوع الدراسة هنا هي:
(أ) في مجال التراجم: أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب- مقدمة كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي بتحقيق صلاح الدين المنجد.
مقدمة كتاب أمراء دمشق في الإسلام، بتحقيق صلاح الدين المنجد، للصفدي.
(ب) في مجال تاريخ المدن: المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى.
وبالنسبة للأعلام الذين شملتهم التراجم فهم:
1- البلاذري، أحمد بن يحي (ت 279/ 892).
2- الحموي، شهاب الدين عبد الله ياقوت الرومي (ت 626/ 1228).
3- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر (ت 680/ 1281).
4- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748/ 1348).
5- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764/ 1362).
وأما المدن موضوع الدراسة فهي دمشق والقاهرة وبغداد.
وقد اقتضت الدراسة الاستعانة بمؤلفات أخرى للمنجد مثل «الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس» و«بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي» وكذلك بعض المؤلفات الأخرى2. وتسعى الدراسة لتوضيح الجوانب المختلفة الخاصة بفن كتابة المقال التاريخي عند صلاح الدين المنجد. ويلاحظ أن الدراسة تقوم على عدد من الفرضيات، أولها أن كتابات صلاح الدين المنجد في الأبواب المذكورة هنا هي عبارة عن مقالات، تتسم بوحدة الموضوع في كل كتاب مستقل. وثانيها أن صلاح الدين المنجد كان فنانًا متقنًا لفن كتابة المقال التاريخي، شكلًا ومحتوى، وذلك دون أي انتقاص من قدرته الفائقة في الكتابة العلمية الدقيقة.
الخصائص العامة لمنهج صلاح الدين المنجد في تناول موضوعات الدراسة
يلتزم صلاح الدين المنجد في تناوله لكافة الموضوعات بالانطلاق من قاعدته التخصصية، باعتباره محققًا ودارسًا لمخطوطات التراث الإسلامي. ويبدو أن ما كتبه من مقالات في المواضيع المذكورة كان ناتجًا عرضيًّا لعمله المستمر والدؤوب خلال فترة طويلة في مجال البحث عن المخطوطات والعمل في تحقيقها. وهو عمل يقتضي منه بالضرورة التجوال والسفر من مكان إلى آخر في المدن التي كانت مسرحًا للتاريخ الذي تحكي عنه تلك المخطوطات ومسرحًا أيضًا للحياة الفكرية الثرية التي أوجدتها. ومثل هذا النشاط يورث عادة خبرة متراكمة بالحياة الإنسانية وتنوعاتها الثقافية، وكذلك بالحضارة وأشكالها المتعاقبة في الزمان والمتنوعة في المكان- وهي حضارة لازالت تعيش عبر الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة3. لذلك نجد المنجد يشير من وقت إلى آخر إلى مقارنات بين الحاضر والماضي، ويمكن هنا الاكتفاء بالإشارة إلى نصين: الأول عن بعض مظاهر السلوك داخل الدور الدمشقية نقلًا عن المقري عن قاضي إشبيلية أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، والثاني عن البيمارستان في القاهرة، نقلًا عن البلوي.
يقول النص الأول: «وذكر في رحلته عجائب: منها أنه دخل أحد بيوت الأكابر في دمشق فرأى فيه نهرًا جاريًا إلى موضع خلوتهم. قال ابن العربي: فلم أفهم معنى ذلك، حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إلينا فأخذها الخدم ووضعوها بين أيدينا فلما فرغنا، ألقى الخدم الأواني وما معها في النهر الراجع، فذهب بها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدم من تلك الناحية، فعلمت السر وإن هذا لعجيب»4. لقد عقب المنجد على هذا النص بقوله: «والأمر الذي عجب منه ابن العربي ليس بعجيب فالماء وافر في دمشق جدًا، بسبب وجود نهر بردى وفروعه وقد استغل الدمشقيون هذا الماء فأجروه في دورهم ومدارسهم وطرقهم، واستغلوه في شؤونهم البيتية فجعلوه كما رأينا، يأتي بالموائد الغالية، بالمآكل، ويروح بالأواني الفارغة. وقد شهدت انا بنفسي مثل هذا في دور الصالحية التي يخترقها نهر يزيد»5.
أما النص الثاني فيقول: «ولو لم يكن للقاهرة ما تذكر به إلا المارستان وحده لكفاها... وأخبرني العالم المؤرخ شمس الدين الكركي أنه يكمل فيه في كل يوم من المرضى الداخلين إليه، والناقهين الخارجين منه أربعة آلاف نفس. وتارات يزيدون وينقصون. ولا يخرج منه كل من يبرأ فيه من مرض حتى يعطي متوليه إحسانًا إليه، وإنعامًا عليه، كسوة للباسه ودراهم لنفقاته»6.
عقب المنجد على هذا النص بقوله: «وقد سألت أثناء مقامي في مصر أحد أطباء القصر العيني، وهو مستشفى الحكومة، عن عدد الداخلين إليه يوميًا فقال: قد يبلغون المائتين. فلما ذكرت له ما قاله البلوي أعجب ودهش. هذا مع عناية الحكومة اليوم بالشعب واهتمامها به. فانظر كيف كان الاهتمام بالشعب يومئذ أشد وأكثر، بدافع ديني7بحت»8. ولا بد هنا من إثبات جانب مهم في منهجه وهو ميله إلى تقرير الأحكام العامة والقيمية مستخلصًا لها من وثيقته الأساسية وهي النص- المخطوط، مطبوعًا منشورًا كان أو لا يزال في طور المخطوط فقط. والحكم القيمي العام هنا هو ما تحته خط في النص السابق.
يلاحظ أيضًا أن المنجد يهتم بالتدقيق في عرضه لمادة المخطوط، فهو يذكر بدقة تاريخ وفاة الكاتب وتاريخ دخوله للمدينة وأحيانًا تاريخ مغادرته لها، ويذكر الأحداث وغيرها من القرائن التي تعين على معرفة الزمان والمكان بأكبر ما يمكن من تحديد، وهو قوي الوعي بأهمية هذا الجانب في فهم وتحليل المادة التي يسردها. من ذلك قوله عن زيارة ابن جبير لبغداد ومغادرته لها: «ويجب أن نذكر ان ابن جبير دخل بغداد في الثالث من صفر سنة ثمانين وخمس مئة وتركها في الخامس عشر منه. فمقامه فيها كان قصيرًا، وبرغم ذلك فإن ما كتبه عن بغداد فيه كثير من الأصالة والشأن»9. ويلاحظ هنا أيضًا الحكم القيمي العام يطلقه ويقوِّم به مادة ابن جبير، متجاوزًا عامل قصر الزمن ومعتمدًا على معايير أخرى، يراها أكثر أهمية، تتعلق بحقائق مضمون النص الداخلية.
يهتم المنجد أيضًا بنقد النصوص التي يوردها، كذلك بالاستدراك عليها. ويوظف في هذه الناحية معرفته العميقة والأفقية بكافة المصادر والمخطوطات. تأمل قوله في معرض محاولته لبناء سيرة حياة البلاذري: «ومن المؤسف أن طبعة الجهشياري التي بين أيدينا ناقصة، فقد رجعنا إليها لنرى نص الجهشياري الذي ذكره ياقوت فوجدنا خلطًا عجيبًا، قال: «وكان يكتب للخصيب أبو عبد الحميد بن داوود البلاذري المؤلف لكتاب البلدان وغيره من الكتب». وهذه العبارة تخالف في تركيبها ما ذكره ياقوت وتخالف الواقع أيضًا. فمؤلف كتاب البلدان ليس أبا عبد الحميد بن داوود البلاذري»10. ونجده يستدرك على ابن جبير في ما أورده عن دمشق وذكر فيه أن بها عند زيارته لها نحو عشرين مدرسة قال المنجد: «أما قوله أن عدد المدارس فيها كان نحو العشرين فهو على التقريب، والصحيح أنه كان فيها حتى سنة 580هـ، وهي السنة التي زار فيها ابن جبير دمشق، خمس وعشرون مدرسة»11. وقد اعتمد المنجد في هذا الاستدراك على النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس12. وكثيرًا ما ينتقد المنجد المطبوع من كتب التراث، مثل فهرست ابن النديم13، وهو بذلك يطعن ضمنًا في تحقيق بعض هذه الكتب ويطالب بالمزيد من البحث عن المخطوطات من أجل المقارنة وتدقيق التحقيق وتكميل ما هو ناقص.
من خصائص منهج المنجد توخي الدقة والأالمنجد عددًا من الآراء العامة في ثنايا تعليقاته على النصوصمانة وذلك باعترافه بما هو مجهول أو غير مؤكد أو غير واضح من المصادر، ومن ذلك قوله في ترجمة البلاذري: «ولا ندري إذا كان صاحبنا تابع تأديب ابن المعتز في خلافة المهتدي (قتل سنة 256هـ) والمعتمد (مات سنة 279هـ) فنحن لا نجد شيئًا في المصادر يدلنا على ذلك، والغريب أن ابن المعتز لا يذكر أستاذه بشيء من تواليفه حتى في طبقات الشعراء في حين أنه ذكر فيها شعراء أقل منه شأنًا»14.
ومع أن المنجد يتمسك دائمًا بالحكم القائم على ما تقوله المصادر، وهي في الغالب المخطوطات، إلا أنه لا يقف في حدود ما يمكن أن يعتبر جانبًا آليًّا أو إجرائيًّا روتينيًّا في هذا المنهج. ويتجاوز ذلك إلى إعمال العقل والترجيح بين الاحتمالات وما يتصل بذلك من تحليل للأسباب والمسببات، فهو يستخدم كلمة «لعل» أكثر من مرة في ترجمة البلاذري في محاولته لسد فراغات المعلومات في المصادر15 . ويستخدم المنهج العقلي أكثر من ذلك في محاولة استقراء المعلومات المحدودة التي يجدها في المصادر للوصول إلى تسلسل أكثر اكتمالًا ومنطقية لما يريد بناءهُ من سيرةأو غير ذلك. من ذلك ما أورده عن رحلة البلاذري إلى الشام: «ولا ندري على الدقة متى كانت رحلته إلى الشام فهو لم يذكر متى طاف بهذه البلاد ولكننا نرجح أن ذلك كان بعد وفاة المأمون سنة 218هـ، أي في زمن المعتصم. فنحن لا نسمع شيئًا عنه في هذه الفترة، يضاف إلى ذلك أن أبا حفص الدمشقي الذي سمع منه بدمشق توفي سنة 225هـ، فلا بد أنه سمع منه قبل ذلك»16 ومن ذلك تقديره لوقت فراغ البلاذري من كتابه فتوح البلدان: «فهو يذكر المعتز بالله ولا يذكر بعده أحدًا ممن تولى الخلافة مما يرجح أنه أتمه بعد سنة 255هـ وهي السنة التي قتل فيها المعتز»17 .
يستخدم المنجد المنهج العقلي كذلك في تقويم روايات المصادر ورفض بعضها، ومن ذلك رده لبعض روايات الذهبي وابن النديم حول أخبار موت البلاذري. قال المنجد: «ويذكر الذهبي في سير النبلاء أن شرب البلاذري كان للحفظ. وهذا ما يؤكد الشك في الرواية، فماذا يريد أن يحفظ من بلغ الثمانين أو تجاوزها، وألحت عليه الحاجة ولجأ إلى الناس، وإنما يبغي الحفظ من كان ناشئًا في بداءة الشباب، يطلب العلم ويجمعه. ويذكر صاحب الفهرست أنه «شد» في المارستان. وعبارة الذهبي «ربط» والعادة أن يربط أو يشد من تخشى قوته وبطشه من المجانين. فهل عند من جاوز الثمانين مثل ذلك؟ وكيف كان سبب موته ورغم شكوكنا هذه فإننا ما نزال نحتاج إلى نصوص جديدة صحيحة لكتاب الجهشياري وغيره، لتبين لنا كيف مات، وتبين لنا هل كان البلاذري لقبًا له أم لجده»18 . ويمكن ملاحظة أن المنجد هنا عندما يلجأ إلى المنهج العقلي يقيده في النهاية بمعطيات المصادر والروايات ولا يقبل نتائجه بصورة نهائية، معترفًا بالقصور في النتائج الحالية، الناجم عن قصور المصادر.
يستخدم المنجد أيضًا المنهج العقلي، أكثر مما سبق ذكره، في محاولة للاستنباط من المعلومات المحدودة التي يجدها في المصادر تعميمات أوسع، ومن ذلك تعقيبه على قول عبد اللطيف البغدادي أن بمعسكر صلاح الدين الأيوبي بعكا أكثر من ألف حمّام، وقد سعى معتمدًا على معلومة أخرى، هي أن المغاربة كانوا مختصين بالعمل في الحمّامات والإشراف عليها، إلى تقدير عدد المغاربة في الشام عمومًا- وبالطبع تلك محاولة طموحة جدًا. يقول المنجد: «فإذا كان في المعسكر ألف حمام وعلى كل حمام اثنان أو ثلاثة من المغاربة، كان عدد هؤلاء المغاربة وحدهم ألفين أو ثلاثة آلاف، عدا الآلاف غيرهم كانوا يعملون في أمور شتى قصدوا الشام من أجلها»19 .
يميل المنجد في أحيان كثيرة إلى إبداء رأيه حول موضوع النص بل ويستطرد في هذا إلى ذكر آراء أخرى ذات صلة بموضوع النص، وهو لا يقف موقفًا سلبيًا أمام ما يورده مكتفيًا بحدود التحقيق الرسمية. ومن ذلك نقده لما اعتبره تحاملًا من القفطي على ياقوت الحموي، ذكر المنجد «ولا نجد مبررًا لتهجم القفطي على ياقوت في خلقه، وفي الطعن على علمه. كان نبيلًا في رد الجميل إلى القفطي بما صنع وأثنى عليه، وكان القفطي لئيمًا في طعنه ومنه بما كتبه بسوء عليه»20. وقد أورد المنجد عددًا من الآراء العامة في ثنايا تعليقاته على النصوص، تصلح مرشدًا إلى فكره العام، مما سيرد في خاتمة هذه الدراسة.
لا بد أخيرًا من التوكيد ثانية على أن من أهم خصائص منهج المنجد في مقالاته التاريخية، موضع الاهتمام في هذه الدراسة، هو التدقيق والنقد- حتى أنه مدح منهج الشك عند ياقوت- وكان منتبهًا إلى ما يقع من تصحيف أو تحريف في المخطوطات بسبب أخطاء الكُتاب وما يؤدي إليه ذلك من إبهام للمؤرخين وقلب للحقائق. ومن أمثلة ذلك ما كتبه المنجد «قد ذهب دخويه (في مقدمة نشرته) إلى أن صاحب الفهرست محمد بن اسحق النديم كان تلميذه. وهذا خطأ. ومصدره الترجمة التي كتبت بخط السخاوي في أول فتوح البلدان. والصحيح أن الذي أخذ عنه هو يحيى بن النديم. فقد تصحفت يحيى إلى محمد. والمعروف أن صاحب الفهرست لم يدرك البلاذري ومات بعده بما يقارب من مئة سنة، فقد مات يقينًا بعد سنة 375. ويحيى بن النديم هذا هو يحيى بن المنجم، وكان من أسرة كانت ندامى للخلفاء»21.
كذلك فإن دراسات المنجد تقوم على مخطط واضح، قد يتعدل قليلًا من حالة إلى أخرى، فمثلًا في حالة التراجم يهتم أولًا بتحديد مصادره ثم بسيرة المترجم له العامة ثم بحياته العلمية والفكرية ومنهجه في التأليف وما إلى ذلك. وهو كما سلف الذكر قوي الارتباط بمصادره في كل ما يذهب إليه، دون أن يمنعه ذلك من إطلاق آراء احتمالية، يمكن اعتبارها مجرد هوامش تحيط بصلب عمله العلمي التاريخي.
تحليل نص صلاح الدين المنجد عن اللاذري، ياقوت الحموي، ابن خلكان، الذهبي والصفدي
المقصود بالنص هنا جملة النصوص المتعلقة بالأعلام المذكورين التي أتت متصلة أو مبعثرة في كتابات صلاح الدين المنجد المشار إليها في مقدمة هذه الدراسة22 وقد جاءت دراسته عن البلاذري وياقوت الحموي وابن خلكان في مجلد واحد بعنوان أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب- الجزء الأول- وصدرت في بيروت عن مؤسسة التراث العربي عام 1959. أما دراسته عن الذهبي والصفدي فكل منهما عبارة عن مقدمة في تحقيق سير أعلام النبلاء للذهبي، وأمراء دمشق للصفدي. وقد صدر الأول بعد عام 195523، عن معهد المخطوطات العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر، وهي في الجزء الأول من هذا الكتاب. أما كتاب الصفدي فقد صدر عن المجمع العلمي العربي في دمشق عام 1955. ويلاحظ أن الكتب الثلاثة صدرت في فترة متقاربة بين عامي 1955 و1959. وهذا مهم لأنه يدل على أنها تمثل مرحلة واحدة من تطور خبرة ووعي المنجد بهذا المجال.
تمثل دراسة الصفدي أقصر هذه الدراسات غذ تقع في إحدى عشرة صفحة فقط، مقسمة إلى موضوعات داخلية عديدة هي:
- تأريخ التأليف في أسماء وتاريخ أمراء دمشق قبل الصلاح الصفدي.
- تطور الصفدي في كتابة تاريخ أمراء وولاة دمشق ومصادره في ذلك.
- تلخيص حياة الصفدي وصفات كتاباته.
- وصف نسخ الكتاب (عبارة عن رسالة وأرجوزة) بما في ذلك عنوان الرسالة وحجمها بالورقات والسطور وهوامشها وخطها وتاريخ نسخها ونوع المداد الذي استخدم في كتاباتها وألوانه ورسمها.
- وصف الأرجوزة ويشمل عنوانها وعدد ورقاتها.
- وأخيرًا نهج التحقيق مع ملاحظات عن الفهارس والملاحق.
وفرغ من ذلك في القاهرة في مطلع مارس من عام 1955. وجاءت ترجمة الصلاح في حدود صفحة واحدة24، ولكنها عظيمة الفائدة، فقد أوضحت أنه ولد بصفد سنة 697هـ ومات بدمشق سنة 764هـ. وأوضحت تطوره في الوظائف الديوانية في دولة المماليك وموجز حياته العلمية وشيوخه مثل الذهبي وابن كثير.. إلخ وبعض خصائص إنتاجه في الأدب والتاريخ والتراجم.
ونموذج كتابة المنجد عن الصفدي يدل على قدرته على الإحاطة والإيجاز الشديد في نفس الوقت. وحتى يتمكن القارئ من التوسع في المواضيع التي أشار إليها خاصة عن حياة الصفدي، فقد أثبت أهم المراجع القديمة مثل طبقات الشافعية للسبكي والدر الكامنة لابن حجر وشذرات الذهب لابن العماد وكذلك الحديثة مثل دراسات بروكلمان وريتر.
أما دراسة المنجد عن الذهبي فقد جاءت قصيرة موجزة أيضًا وكذلك في شكل مقدمة، ومع ذلك فهي في الحجم والمادة تمثل ضعف دراسته عن الصفدي. وهي شديدة التركيز، وقد فصل فيها في مصادر دراسة الذهبي، وقسمها إلى اربعة أقسام:
- ما كتبه الذهبي نفسه.
- ما كتب عن الذهبي في عصره.
- ما كتب عن الذهبي في عصره في الفترات التاريخية في إطار العصور الوسطى.
- ما كتب عن الذهبي في العصر الحديث.
وهذه التقسيمات للمصادر على أساس تسلسلها الزمني يعكس نظرية المنجد عن تقويم المصادر، وهي من صميم المنهج التاريخي، وتقوم على أن وزن المصدر يزيد كلما اقترب من عصر المترجم له. وعلق على المصادر العصر- أوسطية التي كتبها غير المعاصرين للذهبي بقوله: «وليس في هذه المصادر شيء أصيل وكلها نقلت عن مصادر القرن الثامن، والمفيد في بعضها أنه حفظ لنا بعض النصوص المفقودة»25. وقد تجلت القدرة النقدية للمنجد، المعتمدة على الاطلاع والمعرفة بالمخطوطات التراثية، في تقويمه للتراجم الحديثة عن الذهبي، وهو نقد أدى به إلى القول بضرورة كتابة ترجمة جديدة للذهبي. وقد قام بهذه الترجمة الجديدة في مقدمته هذه، وعلى كل حال فإن المنجد كان يحتاج لمثل هذا القول لتبرير طرق ما هو مطروق قبله، وهو موقف لم يعلنه في حالة الصفدي. وقال المنجد «وترجم بعض المعاصرين للذهبي. نذكر منهم: حسام القدسي في مقدمة تاريخ الإسلام وسعيد الأفغاني في مقدمة نشرته لسيرة ابن حزم. وهاتان الترجمتان ترداد لما يوجد في المصادر السابقة. فلم يحاول واضعاهما الاستفادة من النصوص لكشف نواحي جديدة في حياة الذهبي الخاصة والعامة. وتكلم بروكلمان في تاريخ الآداب العربية على من ترجم للذهبي وسرد بعض ما عرف من مخطوطاته تواليفه. وقد وهِم في ذكر بعض من ترجم له، كالشوكاني في البدر الطالع، وفي الصفحة التي أشار غليها من هذا الكتاب ترجمة الذهبي من علماء اليمن لا الذهبي مؤرخنا. وهناك مخطوطات كثيرة لتواليف الذهبي لم يعرفها، كمخطوطات سير النبلاء مثلًا. وخصّ محمد بن شنب الذهبي بكلمة موجزة في دائرة المعارف الإسلامية لخص فيها ما هو شائع في المصادر، وليس فيها جديد»26.
إن عبارات المنجد السابقة تدل على موقفه، الذي سلفت الإشارة إليه، من تحقيق وكتابات المحدثين المعاصرين له، وهو يكاد بسطر واحد فقط يثير شكًّا عظيمًا في علم وكفاءة واحد من أكبر المستشرقين وهو كارل بروكلمان. غير أنه لا بد من ملاحظة أن الكتاب الأجانب عن العربية من أصحاب النزعة الموسوعية لا يُتوقع منهم الدقة في التفاصيل. هذا بالطبع لا يلغي القيمة العظيمة لأعمالهم، ولا يمنع اعتبارهم روادًا مع العلم بأن في أعمالهم أخطاء قد تكون جسيمة، مما يحتم ضرورة وضعهم في دائرة النقد. ويمكن ملاحظة أن المنجد في ترجمته للذهبي يقع في إسار الفكرة التقليدية الشائعة في عصره على أن المدخل لفهم الشخصية وإنجازاتها العلمية والفكرية هو دراسة عصرها ومحيطها الاجتماعي العام والشخصي. وهي فكرة لا تخلو من منطق ولكن تطبيقها بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من الفهم العميق يقتضي التركيز على تحليل الارتباطات بين العناصر العامة وتفرد الشخصية في التكوين والإنجاز، وهي جوانب لم تكن تجد الاهتمام الكافي في حقبة الخمسينات والستينات من هذا القرن، أي الفترة التي نشط فيها صلاح الدين المنجد.
لقد رسم المنجد في مقاله، المقدمة، صورة واضحة، ليس لتطور حياة الذهبي وحده، ولكن لمدينة دمشق، وحياتها الدينية والعلمية، والأوضاع الفكرية في الشام عمومًا، وحياة بعض أكابر رموزها مثل ابن تيمية، وذلك في القرن الثامن الهجري. وأوضح أن محمد بن الذهبي كان سليل أسرة تركمانية، هاجرت إلى دمشق، في عصر نور الدين زنكي، في أيام جد الذهبي لأبيه. وأنه أخذ العلم وراثة عن أبيه أحمد، الذي عدل عن النجارة إلى صناعة الذهب المدقوق27، فنشأ محمد الذهبي في طفولته، وصباه، في أسرة يهتم عدد من أفرادها بطلب الحديث والقراءات والتاريخ، فتتلمذ عليهم. ومن معالم ذلك ما اقتبسه المنجد عن الحسيني في ذيل الطبقات«ومالت نفس الفتى إلى جمع القراءات، فوجد عند جبريل المصري، نزيل دمشق، ما يشتهي، فقرأ عليه كتاب التيسير للداني، وكتاب حرز الأماني للشاطبي»28.
أما في مجال الحديث فقد ذكرت بعض المصادر أن شيوخه بلغوا ألفًا ومئتين أو تزيد29. ويتعرض المنجد لرحلات الذهبي، بعد أن استوعب علم أهل دمشق، في مدن الشام ومصر والحجاز، ثم عودته إلى دمشق، وظهوره عالمًا حنبليًا من أعظم علماء دمشق30. ويذكر صحبته لابن تيمية31 وانتقاده له لما كان يرى من مواقفه الحادة والعنيفة، مع توقيره له واعترافه بعلمه وإبداء المحبة والود له. وقد نقل المنجد جانبًا مهمًّا من رسالة الذهبي النصيحة الذهبية إلى ابن تيمية32واقتباس المنجد هنا من هذه الرسالة يدل على شيئين مهمين هما: شخصية الذهبي، بوضوحها، وقوة بيانها الذي لا يخلو من حدة وعنف، بالإضافة إلى أجواء دمشق والشام، وما فيها من صراع فكري حاد بين المذاهب والعلماء. ونص الاقتباس هو «مخاطبة مكتوبة يوجهها الذهبي إلى ابن تيمية يقول فيها: «إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجِذْع في عينيك؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتتبَّع عورات الناس..؟ يا رجل! بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليهم اللسان لا تقر ولا تنام.. صرنا ضحكة الوجود فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا..؟ كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما. وإلى كم تصادق نفسك وتعادي الأخيار.. إلى كم تعظمها، وتصخّر العباد.. إلى متى تمد كلامك بكيفية لا تمدح بها، والله، أحاديث الصحيحين. يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك. أما آن لك أن ترعوي؟ اما حان لك أن تتوب وتنيب وأنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلى والله ما أذكر أنك تذكر الموت، بل تزدري بمن يذكر الموت. فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات.. فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الوادّ فكيف يكون حالك عند أعدائك.. وأعداؤك فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة.. وقد رضيت منك أن تسبّني علانية وتنتفع بمقالتي سرًا، فإني كثير العيوب غزير الذنوب»33.
إن هذا الاقتباس في غاية الأهمية، وهو يدل على أن الوصف الذي وصف به صلاح الدين المنجد الإمام الذهبي بأنه «يعرف ما ينتقي»34 ينطبق على المنجد نفسه، غير أن ذلك في فن آخر، وهو فن اختيار ونظم وترتيب النصوص لتقول ما يريده المنجد على النحو الذي يريده. وتتضح عبقرية المنجد هنا في سوق نص آخر يكاد يتهم الذهبي بما اتهم به الذهبي ابن تيمية، أما صاحب النص فهو صلاح الدين المنجد نفسه، يقول النص: «كان الذهبي يزن الناس بميزان آرائه ومعتقده. وهو لا يرضى عن الكيمياء مثلًا، فيقول عن صاحبه وشيخه علي بن أحمد الواسطي «صاحبناه، وكان يدخل في الكيمياء والهذيان»، وهو لا يرضى عن الصوفية فيقول عن شيخه عبد المحسن عبد العديم «كان يدخل في ترهات الصوفية»، وهو لا يحب الفلسفة فيقول عن صاحبه الحسن بن احم بن زفر «كان مظلمًا في دينه ونحلته متفلسفًا» ولكنه يثني عليه في أمور أخرى وينصفه. وهذا شانه في غير ذلك من التراجم، فقد يغمز المترجم له فيما يرى أنه أحسن فيه. وترجماته لابن تيمية أحسن دليل. فهو يثني عليه في أمور أحبها فيه، ويأخذ عليه أمورًا أنكرها عليه، في حياته وبعد مماته»35.
إن الجانب الإيجابي في منهج الذهبي الذي ذكره المنجد هو جزء من منهج المنجد نفسه، خاصة وأن المنجد يهتم كثيرًا بالأحكام القيمية وجانب المناقب والمثالب، سواء أكان ذلك بالنسبة للأشخاص أو الشعوب أو المدن. وقد مدح المنجد الذهبي كثيرًا ومع ذلك فقد أثبت عليه أقوال منتقديه والقادحين فيه ثم قام بعد ذلك بإنصافه بالرد عليهم. ذكر المنجد: «ولا بد من الإشارة إلى أنهم أخذوا عليه أمرين: الأول أنه كان لا يلتزم الحيدة عند الترجمة لمن يخالفه في العقيدة.. أما الأمر الثاني فهو ما انفرد بذكره ابن الوردي. فقد ذكر أنه تعجّل فترجم للأحياء في عصره، وأنه اعتمد فيما كتبه عن هؤلاء على أحداث كانوا يترددون إليه»36 . وقد أجمل المنجدرده على الاتهامين بقوله: «والذي نراه أن الذهبي لم يكن من التعصب بالدرجة التي صورها بها معاصروه، وأنه أوتي في تراجمه، رغم حنبليته، الكثير من الإنصاف، لا الإنصاف كله. وهذا شيء ليس بقليل، إذا قيس بمؤرخين آخرين، كالسخاوي، كانوا يتعصبون لهوى في النفس، لا لعقيدة أو رأي. ويبتعدون عن الإنصاف ولا يقتربون منه.. وابن الوردي عاش في مصر ثم في حلب ومات بها بعد سنة من وفاة الذهبي.فلم يكن يعرف الذهبي عن قرب. كما عرفه البرزالي، والصفدي، والحسيني، وابن شاكر، وابن كثير، والسبكي، ولم يتهمه أحد من هؤلاء، وقد عاشوا معه بدمشق، بما اتهمه به ابن الوردي في أنه اعتمد على الأحداث. أما تراجمه للأحياء في عصره فهي في نظرنا ميزة كبرى له، وما كتبه عن عصره في كتبه، سواء الترجمات أو الحوادث، فهو ما نجد فيه الأصالة عنده. وقد علمنا أن الذهبي كان حجة في الجرح والتعديل والنقد، فمن كان هذا شأنه لا يمكن أن يعتمد على أحداث دون أن يتثبت من أقوالهم، وتصح عنده»37.
إن التحليل السابق في إنصاف الذهبي يدل على خاصية أساسية في كتابات المنجد، هي التوازن والاعتدال والموضوعية. وكما هو واضح من النص أنه لم يبرئ الذهبي تمامًا من الاتهام الأول ولكنه خفف منه كثيرًا.
تعرض المنجد في ختام مقاله، في تقديم كتاب سير أعلام النبلاء، لآثار الذهبي وذلك تحت عنوان متواضع هو: «بعض آثاره المعروفة». وقد قدم في هذا المنحى إضافة متميزة، فهو قد انصرف عن إثبات ما ورد في الكتب عن أعمال الذهبي، لأن مصادر القرن الثامن وبعض المعاصرين، مثل سعيد الأفغاني في مقدمة لسيرة ابن حزم، قد فعلوا ذلك وهو يتجنب التكرار. أما ما أثبته فهو ما هو موجود فعلًا الآن في مكتبات العالم من مخطوطات الذهبي، وقد فعل في ذلك ما وسعه عمله، معترفًا بصورة ضمنية بأن المعرفة الكاملة بذلك غير ممكنة، ولكنه على أي حال تمكن من إضافة الجديد على أعظم محاولة في هذا الاتجاه، وهي قائمة بروكلمان «منبهين أن قائمة بروكلمان ناقصة، فأضفنا إليها ما عرفناه»38.
وبالنسبة لترجمة البلاذري وياقوت الحموي وابن خلكان والذهبي، فإن كلًا منها يختلف عن ترجمة الصفدي الموجزة. وذلك لأن هذه التراجم الأربع قد أخذت شكل المقال الطويل نسبيًا. وقد جاءت ترجمة البلاذري في حوالي خمسين صفحة وترجمة ياقوت في حوالي خمسين صفحة أيضًا، أما ترجمة ابن خلكان فقد جاءتفي حوالي أربعين صفحة. ولكن لا بد من ملاحظة أن هذه الصفحات من القطع الصغير بينما صفحات ترجمة الصفدي (إحدى عشر) والذهبي (ثلاثة وعشرون) هي من القطع الكبير. وهناك فارق أساسي بين ترجمة الذهبي والصفدي، والتراجم الأخرى، ففي حالة الذهبي والصفدي كان الغرض الأساسي هو التقديم لكتاب أما في حالة الثلاثة في الجزء الأول من كتاب أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب فقد كانت الترجمة هي الغاية. لقد انعكس هذا الفارق على التناول بعض الشيء، خاصة في حالة ترجمة الصفدي، حيث اكتفى المنجد بالأقل من القليل. غير أن الاختلاف لم يكن كبيرًا فقد التزم المنجد دائمًا بتطبيق نموذج محدد في هيكله لكل دراسة وتحديد موضوعاتها، أهم فقراته هي: مصادر الترجمة- خلفية المترجم له وملخص سيرة حياته- نشاطه وإنجازاته العلمية، ويتضمن ذلك تناول ثقافته وأساتذته وتلاميذه- سرد آراء المعاصرين وغيرهم عنه- منهجه ومزاياه والنقد الموجود له. وفي حالة البلاذري وياقوت الحموي وابن خلكان، ختم الذهبي الترجمة بإثبات نصوص منتقاة من مؤلفاتهم.
لقد اتسمت كل المقالات بطابع الإيجاز والاتجاه نحو الانتقاء في تناول تفاصيل المواضيع، وذلك بدلًا عن اتجاه الدراسة الشاملة الواسعة المفصلة، مثلًا نجد المنجد في حالة البلاذري يركز على تناول كتابه فتوح البلدان وليس أنساب الأشراف وفي حالة ياقوت يركز على معجم البلدان وليس معجم الأدباء. وربما ارتبط هذا الاختيار بتحديده لجانب التاريخ والجغرافيا في أعمال أولئك الأعلام، غير أن التداخل القوي لمجالات المعرفة في موضوعات أولئك المؤرخين والجغرافيين يقلل من أهمية هذه الناحية. وعلى وجه العموم فإن الانتفاء والإيجاز يمثلان خاصية أساسية في فن الكتابة عند المنجد، ويتناسب ذلك مع شكل المقال الذي اختاره. وما ذكره المنجد عن الذهبي من أنه «يعرف ما ينتقي. وفي تراجمه لمن سبقه ومن عاصره يحاول أن يقدم لك ترجمة واضحة شاملة، فيها ما تجده في كتب كثيرة مفرقًا. واختياره الأخبار يدل على علم وفهم وضبط»39ينطبق على المنجد نفسه ويحاول المنجد عادة أن يقدم ما هو جديد، متجنبًا اجترار الدراسات السابقة له، لذلك نجده في حالة الموضوعات المطروقة مثل ترجمة الذهبي والبلاذري، يستخدم عنوان «سيرة جديدة للذهبي» «سيرة جديدة للبلاذري».
تتسم مقالات المنجد المشار إليها بالانضباط المنهجي الصارم والتنظيم الدقيق، والتوافق بينه وبين من يؤرخ لهم واضح. وهو لم يركز إلا على القمم العلمية والفكرية في التراث الإسلامي، مع ملاحظة تركيزه الواضح على الشام ودمشق مكانًا والقرون السادس والسابع والثامن الهجرية زمانًا، والعلاقة هنا بين المكان والزمان واضحة- لأن هذه القرون تمثل فترة الازدهار الحضاري والمركزية السياسية للشام (ومصر كذلك) بعد تراجع العراق وبغداد وطغيان الإقليمية على المركزية في الإمبراطورية الإسلامية40. وبالرغم من أن البلاذري وياقوت وابن خلكان قد اهتموا بالأقاليم الإسلامية المختلفة، وكان نصيب العراق مثلًا والقرون الهجرية الأولى كبيرًا، إلا أن المنجد عند إثبات النصوص في نهاية التراجم يركز على ما يتعلق بالشام ودمشق. وأول نص أثبته من كتاب فتوح البلدان للبلاذري كان بعنوان «فتح مدينة دمشق وأرضها»41، أما النص الثاني الذي أثبته من هذا الكتاب فكان بعنوان «أمر الجراجمة»42 وهم قوم من الشام كانت لهم أخبار أيام فتح المسلمين لها. أما النصوص التي اختارها من أنساب الأشراف فتتعلق بحكام الشام من الأمويين، واختار يزيد بن معاوية43 وعمرو بن سعيد بن العاص44، وما أورده عنهما يدخل في أخبار الشام. وقد اختار نصًّا واحدًا من كتابات ياقوت الحموي وهو بعنوان: «دمشق»45، واختار عن كتابات ابن خلكان ترجمة ابن الأثير46 الذي أصبح عالمًا دمشقيًّا رغم أصله العراقي. ولم يخرج ممن اختارهم المنجد ليثبت عنهم النصوص من نطاق الشام سوى أبو فيد47، الذي أورد له ابن خلكان ترجمة، لم يأخذ منها المنجد سوى صفحات ثلاث من القطع الصغير، وأخباره تتصل بالعراق في عهد الأمين والمأمون. يضاف هذا غلى أن الذين ترجم لهم المنجد في هذه الدراسة. باستثناء البلاذري، كانوا من علماء الشام، وكل منهم كان متصلًا بدمشق أو دمشقيًّا. حتى البلاذري كان قد اتصل بالشام في مرحلة مهمة من حياته48.
يوجز المنجد، متتبعًا المصادر، حياة البلاذري49 في أنه كان متصلًا بالبلاط العباسي منذ عهد المأمون (ت 218) حتى عهد المعتز، الذي أوكل غليه تأديب ابنه عبد الله. وبعد المعتز بدأ يفقد صلته بالخلفاء وتدهورت أحواله المالية حتى توفي في آخر خلافة المعتمد سنة 279، وقد مدح المأمون وهو في العشرين من عمره. أما حياته العلمية فقد ذكر المنجد أنها كانت خصبة مثمرة، أخذ العلم أولًا عن علماء العراق، مثل القاسم بن سلام والمدائني وابن سعد. ثم توجه إلى الشام فأخذ العلم عن هشام بن عمرو أبي حفص الدمشقي وزار مدن حلب ومنبج وإنطاكية وثغور الروم والجزيرة والرقة وتكريت50. وأشار المنجد إلى جمع البلاذري بين علم أهل العراق وعلم أهل الشام والثقافة الفارسية، التي كان عارفًا بلغتها، لكن المنجد لم يستطع أن يحدد ما إذا كانت معرفة البلاذري بالفارسية تعود لكونها لغة أجداده أو لأنه قد تعلمها. وقد استنتج المنجد أن اتصال البلاذري بالثقافة الفارسية منحه ثقافة حضارية «أهلته أن يكون عالمًا مؤلفًا، وأن يكون نديمًا للخلفاء وأن يأخذ عنه كثيرون»51.
ويذكر المنجد تلميذ البلاذري مثل وكيع القاضي، ويذكر كتاب عهد أردشير الذي ترجمه البلاذري من الفارسية إلى العربية شعرًا، وهو مفقود، ثم يتناول كتبه الأخرى، وعلى رأسها فتوح البلدان ثم أنساب الأشراف، متعرضًا لآراء ابن النديم وحاجي خليفة وغيرهما في معرض التدقيق حول عناوين هذه الكتب وما تعرضت له من تحريف. يذكر المنجد «وألف أحمد بن يحيى كتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير. أما الكبير فلم يتم. ويظن بعض العلماء أن كتاب فتوح البلدان الذي بين أيدينا هو كتاب البلدان الصغير. ولا يذكر حاجي خليفة كتاب فتوح البلدان. على أن ابن النديم يذكر ان له كتاب الفتوح إلى جانب كتابيه في البلدان. وقد نقل هذا عنه ياقوت والصفدي. ولا يوجد اسم كتاب الفتوح في المطبوع من ابن النديم. ونرجح أن يكون كتاب الفتوح هذا هو فتوح البلدان الذي وصل إلينا.. ونعتقد أن كتابيه في البلدان هما على نمط كتب البلدان التي ظهرت في القرن الثالث فكان منها كتاب اليعقوبي وكتاب البلدان لابن الفقيه الهمداني»52.
يلاحظ أن ترجمته للبلاذري تنطوي على فراغات كبيرة، لأن المصادر لا تمده بالكثير. وهذا النقص أكبر في حياة البلاذري العامة منه في نشاطه العلمي وكتاباته، بالرغم من أن الغموض لا يزال يحيط تحقيق مؤلفاته الأصلية، كما يشير النص السابق، بالرغم من استنتاجات المنجد وترجيحاته.
كما سلفت الإشارة، فإن المنجد يقود عادة الحيثيات والمعلومات التفصيلية التي يسردها إلى تقريرات عامة، بعضها ذو طابع تفسيري. من ذلك قوله عن البلاذري «وقد كان لأساتذته وثقافته ورحلاته وتردده على قصور الخلفاء أثر في إنتاجه وفي نوع هذا الإنتاج»53. وهو هنا يربط بين الإنتاج العلمي والفكري وبين سيرة حياة المؤلف العامة. وتلك قاعدة مهمة في تحليل النصوص، التي لا يمكن فهمها وتفسير أبعادها بدون تناول الملابسات الواقعية التي أحاطت بإنتاجها. وهي قاعدة يتبعها المنجد في كل دراساته في مجال التراجم.
إن من ميزات كتابة المنجد ما تتصف به من نزعة نحو الإجمال المحيط والتحديد الواضح والغاية المحددة في سوق وترتيب المعلومات، تأمل مثلًا ما لخص به تطور كتابة التاريخ والأنساب وسط المسلمين من خلال سرده لمصادر البلاذري «فقد استفاد بطريق ابن سعد جميع روايات الواقدي في الفتوح. واستفاد من المدائني نفسه رواياته في كتبه الكثيرة في الفتوح والبلدان. وأخذ بطريق حفيد ابن الكلبي ما رواه جده في الأنساب وأخذ عن القاسمي بن سلام أمور العشر والخراج»54. وبعد هذا السرد الذي يمثل زبدة الكلام، لا ينسى المنجد ضرورة تحديد الهوية العلمية والفكرية للبلاذري، الذي تنوعت اهتماماته «فكان بعد ذلك مؤرخًا للبلدان، وكان نسابة وراوية شاعرًا»55.
ويلجأ المنجد أيضًا إلى الإشارة الذكية دون القول المباشر عن طريق ما يحدده من اختيارات بالاقتباس أو الإفادة عمومًا عن تراث البلاذري وغيره. وهو نفس نهج البلاذري، كما يدل النص التالي من أنساب الأشراف: «وقد بدأ البلاذري كتابه بسيرة النبي وسيرة الصحابة، ثم أورد العباسيين بعد العلويين، وبني عبد شمس بعد بني هاشم، وذكر الأمويين من بني عبد شمس لكنه لم يفرد لهم مكانًا خاصًا. ثم تحدث عن بقية قريش وبطون أخرى من مضر. وشغل الجزء الأخير من كتابه عن قيس. وخص بالذكر منهم ثقيفًا واستفاض في سيرة الحجاج»56. ويفيد تحليل هذا النص أن الموقف الفكري السياسي للبلاذري كان مؤيدًا للعلويين ضد الأمويين وذلك دون محاباة للعباسيين بل وتفضيل العلويين عليهم في الترتيب، مما يرمز إلى خصهم بأهمية أكبر. ذلك بالرغم من أن البلاذري كان يكتب تحت ظل العباسيين ويسعى لكسب ود خلفائهم من أجل لقمة العيش. أما الاستفاضة في سيرة الحجاج وأهله فهي دليل قوي على أن البلاذري يسعى على نحو غير معلن لإبداء مثالب الأمويين وربطهم بالظلم الذي هو من أهم صفات الحجاج. ويدل على ذلك أيضًا وضع الأمويين في إطار بني عبد شمس أي وضعهم في إطار الوثنية والجاهلية- خلافًا لبني هاشم الذين أفرد لهم مكانًا مستقلًا. وأشار المنجد إلى ملاحظات الأستاذ دخويه من أن البلاذري لم يسمِّ أحدًا من خلفاء بني أمية باسمه سوى عمر بن عبد العزيز57. وهو لم يبالغ في مدح الخلفاء العباسيين ولكنه كان يسمي الخلافة العباسية بـ «الدولة المباركة»58، ولا يلحق هذا الوصف بالدولة الأموية. وهذه التعقيبات التي أبداها المنجد عن موقف البلاذري الفكري والسياسي تؤكد ميله للعلويين ولكن باعتدال لا يمنع موالاة العباسيين، ربما لأسباب نفعية- وربما تقية- خاصة إذا كان البلاذري علويًا بالفعل. وربما كان هذا مستبعدًا نسبة لتشبع البلاذري في مروياته المختلفة بالروح السنيّة المعتدلة.
بالرغم من أن المنجد لم يفرد عنوانًا مستقلًا لتناول منهج البلاذري، كما فعل مع ياقوت، إلا انه تناول هذا الموضوع بوضوح59 وأثبت أن من معالم هذا المنهج : تتبع الفتوح تاريخيًا، الانتقاء الجيد لما يسرده من روايات من مادة أصلية ضخمة، عدم الخروج عن وحدة الموضوع كليًّا وجزئيًّا، يتخلل سرده للروايات إشارات قيمة عن التاريخ الحضاري والنظم المالية والإدارية في الدولة العباسية، النزعة النقدية وإبداء الترجيحات عند عرض الروايات، الإيجاز. ويجعل المنجد من نزعة البلاذري النقدية فارقًا بينه وبين بعض مؤلفي كتب الفتوح مثل الواقدي وابن عبد الحكم، ولكنه يشير إلى أن إيجاز البلاذري يدفع الدارسين إلى عدم الاكتفاء به وحده والبحث عن التفاصيل في كتب أخرى60. إن معظم الملاحظات عن منهج البلاذري التي جاء بها المنجد تنحصر إلى حدٍ كبير في حدود دراسته لفتوح البلدان. ولفهم منهج البلاذري بصورة أكثر تكاملًا يحتاج الدارس إلى الرجوع إلى الدراسات التي اهتمت بأنساب الأشراف، ومن بين أهمها دراسة محمدقاسم حمادي المشهداني عن موارد البلاذري.61
بخلاف البلاذري فإن ياقوت الحموي (ت 626) وان خلكان (ت 680)، يقعان في صلب الفترة والإقليم الذي انصب عليه تركيز المنجد، وهي القرن السادس، السابع، والثامن الهجري في الشام، أما ابن خلكان فقك كان أصلًا من إربل، منحدرًا من أسرة فارسية الأصل، هاجر في الثامنة عشر من عمره إلى حلب وتتلمذ فيها على ابن شداد وابن الأثير بدرجة أقل وكذلك على علماء آخرين مثل ابن الخباز وابن الصايغ. ثم اتجه ابن خلكان في سنة وفاة شيخه ابن شداد عام 632 إلى دمشق وتتلمذ فيها على ابن الصلاح، وفي سنة 635 توجه إلى القاهرة وتزوج بها ولقي علماءها مثل الموفق البغدادي. واشتغل فيها بجمع الكتب، وفي سنة 645 بدأ في تأليف كتابه وفيات الأعيان، في الوقت الذي كان مهتمًا فيه بكتابه الآخر فصل القضايا الشرعية والأحكام الدينية وأصبح قاضيًا على المحلة، حتى عاد إلى الشام مع الملك الظاهر بيبرس المملوكي الذي ولاه قضاء الشام. وكانت عودته إلى دمشق بعد غيبة عنها دامت ثلاثة وعشرين عامًا وتولى بها منصب قاضي القضاة حتى عام 664، عندما غير الظاهر بيبرس نظام القضاء وجعل لكل مذهب قاضيًا وولى ابن خلكان قضاء الشافعية، ثم عزله عن القضاء ابن حنا، وزير الملك الظاهر، فعاد إلى القاهرة بعد أن غاب عنها عشر سنوات. وظل بها سبع سنوات مشتغلًا بجمع الكتب والكتابة، مبعدًا عن أي منصب رسمي. وعاد إلى دمشق عام 676 حيث تولى القضاء مرة أخرى ولكن لفترات متقطعة، بسبب الاضطراب السياسي في الدولة، وتوفي عن ثلاثة وسبعين عامًا ودفن بسفح جبل قاسيون عام 681.
تمثل الفقرة السابقة موجزًا لسيرة حياة ابن خلكان كما لخصها المنجد62، معتمدًا في ذلك على عدد من المصادر- من بينها وفيات الأعيان لابن خلكان نفسه والفقرة تلخيص لتلخيص المنجد، وتتضح من ذلك أبعاد شخصية ابن خلكان الثلاثة: العالم الباحث، القاضي، السياسي. ويتضح كذلك موضوع علمه الرئيسي وهو التراجم وتاريخ الأعلام عن طريق تتبع وفياتهم مع اهتمامات أساسية أخرى مثل الفقه الذي يتصل بمهنته في القضاء. ويتضح الفارق الأساسي بينه وبين البلاذري الذي لم يحترف السياسة أو الأعمال الرسمية، رغم اتصاله القوي بالبلاط، والذي اتجه في تخصصه العلمي نحو التاريخ العام أكثر من ابن خلكان. أما سيرة ياقوت الحموي الرومي فتدل على نمط آخر من أعلام العلماء، فهو أقرب من الاثنين إلى طبقة العامة بل وكان رقيقًا في الأصل. وهو لم ينشأ في بيئة العلماء والشيوخ ذات التاريخ العريق، وإنما كان عصاميًّا اكتسب كثيرًا من علمه من الكتب والحياة العملية المباشرة. وقد سجل المنجد عن هذا ملاحظة مهمة في حديثه تحت عنوان «ثقافة ياقوت»: «الملاحظ أن ثقافة ياقوت كانت ثقافة شخصية، أي أنه لم يتلقها من أفواه الشيوخ، وإنما أخذها مباشرة من كتب العلماء، بالمطالعات المستمرة، وقد أتاحت له ظروفه الخاصة- من النسخ، والمتاجرة بالكتب، والتطواف في الآفاق ورؤية خزائنها وكتبها، وعلمائها، من جيحون إلى النيل.. أن يطلع من الكتب على ما لم يطلع عليه أحد»63.ولا شك أن نوع خبرة ياقوت وتطوره الشخصي قد أثرتا بصورة مباشرة على تخصصه العلمي، فهو جغرافي بصفة أساسية، خلافًا للبلاذري وابن خلكان مع أنه يلتقي معهما في كونه مؤرخًا. ويركز المنجد هنا في تحليل منهجه في الكتابة وإيراد المعلومات الغزيرة التي جمعها في كتابه معجم البلدان.
يوجز المنجد سيرة ياقوت64 في أنه ولد في بلاد الروم، وتاريخه هناك مجهول حتى أُسِر صغيرًا في الحروب بين المسلمين والروم. واشتراه في بغداد تاجر من حماة يسمى عسكر، كان أميًّا فعلّم عبدَه الصغير، ياقوت، القراءة والكتابة واستعان به في ضبط تجارته. ولما كبر ياقوت اهتم بالنحو واللغة ثم اشتغل بالنسخ. وكان في أثناء هذه الفترة يعمل بتجارة سيده ويسافر برًّا وبحرًا، واتصل في سفره بالخوارة في عمان وغيرها فتأثر بأفكارهم ولكن إلى حين محدود. واعتقه سيده عندما بلغ الحادية والعشرين وذلك في سنة 596، فاستقل بتجارته، وحصرها في تجارة الكتب. وفي سنة 609 اتصل بالقفطي في حلب اتصالًا عابرًا، واتجه بعد ذلك إلى دمشق حيث وقعت له مشكلة كبرى، كاد أن يُقتل فيها بسبب ما أبداه من آراء الخوارج حول أحد الصحابة، فهرب إلى خراسان، وركّز فيها على المطالعة والكتابة وجمع الكتب واتصل ببلاد ما وراء النهر. وكانت هذه فترة مثمرة علميًّا وفكريًّا في حياته، ولكنه ترك تلك البلاد بسبب تهديد التتار لها وتدهور أوضاعه المعيشية. وعاد عبر العراق إلى الشام ثانية. ولجأ إلى القفطي بسبب الفقر، وكان القفطي وزيرًا لحلب. وكتب كل منهما عن الآخر فكان رأي ياقوت في القفطي إيجابيًّا عكس رأي القفطي في ياقوت. واستفاد من إقامته مع القفطي في لقاء علماء الشام والاطلاع على المزيد من الكتب، واشتغل بنسخ وبيع الكتب حتى تجمع له مال فسافر بالتجارة إلى مصر وعاد منها إلى حلب. وفي حلب فرغ من المسودة الأولى لكتاب معجم البلدان، وبدأ بتبييضه سنة 625، وتوفي بحلب سنة 626. أرخ لذلك القفطي في إنباه الرواة، وأورد أن أولاد سيده قد ورثوه، ومعظم الإرث كان كتبًا- بعضها كان عند ابن الأثير الذي تصرف فيها تصرفًا غير صحيح، إذ حاول الاستيلاء على بعضها لمنفعته. والرواية تتضمن طعنًا من القفطي في ابن الأثير ساقه إلى جانب طعنه في ياقوت نفسه.
تمثل الفقرة السابقة تلخيصًا لموجز سيرة حياة ياقوت كما أوردها صلاح الدين المنجد، وقد استخلصها من مصادر عدة، مثل تاريخ إربل للمستوفي الإربلي، وإنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وكتب الذهبي الثلاثة: تاريخ الإسلام، وسير النبلاء، والعبر في خبر من غبر، والوافي بالوفيات للصفدي، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، ومعجم المطبوعات لسركيس، بالإضافة إلى بعض الدراسات الأوربية الحديثة.
يلاحظ أن المنجد قد أفرد مساحة واسعة، نسبيًّا، في ترجمة ياقوت لما دار بينه وبين القفطي. وهذا ينسجم مع نزعته نحو الاهتمام بالمناقب والمثالب. وهو ليس مجرد اهتمام بدون مغزى علمي، فذلك بأن من أركان علم تقويم الرواة وبالتالي الروايات. ويرى المنجد دائمًا ان الإنصاف والتوازن في الأحكام من أهم واجباته العلمية. وقد أنصف في هذا السياق ياقوتَ قائلًا «ولا بد أن نقرّر هنا أن ياقوت كاننبيلًا كل النبل فيما ذكره عن القفطي في معجم الأدباء، وفي إهدائه معجمه إلى خزانته. في حين لا نجد مبرّرًا لتهجم القفطي على ياقوت، في خلقه وفي الطعن على علمه. كان نبيلًا في ردّ الجميل إلى القفطي بما صنعه وأثنى عليه، وكان القفطي لئيمًا في طعنه ومنِّه بما كتبه بسوء عليه»65. ولا يكتفي المنجد بتناول ما دار بين ياقوت والقفطي في الجزء الخاص بحياة ياقوت بل يعود إلى الموضوع في حديثه عن ثقافة ياقوت. يقول المنجد «فقد زعم في إنباه الرواة أن ياقوتًا كان عسر الفهم. ونعتقد أن من ألّف مثل هذه التواليف وأوتي مثل هذه الثقافة الواسعة لا يكون عسر الفهم. ويذكر الذهبيأنه كان ذكيًّا. وزعم القفطي أنه كان يلفق الكتب. والملفق من يجمع فيعوزه المنهج والفهم والصوغ الخاص. ونحن نجد من تواليف ياقوت منهجًا يتبعه، وند أسلوبًا علميًّا ظاهرًا أشبه شيء بالأساليب العلمية الحديثة في الاستقراء والتنظيم. وقد شهد له الذهبي والصفدي بالبلاغة والتبحر بالعلم. وزعم القفطي أيضًا أنه كان قليل الأنسة بالعربية، وأنه كان يعرِّفه مواضع الخطأ فلا يرعوي ولا يسمع. والعجيب أننا نجد في معجم البلدان إشارة تنفي هذا الخلق عنه. فهو يقول في آخره ولا أدّعي أنني لم أغلط، ولا أشمخ بأنني لم أك عشواء أخبط. والمقرّ بذنبه يسأل الصفح، فإن أصبت فهو بتوفيق الله، وإن أخطأت فهو من عوائد البشر66.
نلاحظ هنا أن المنجد لا يكتفي بالبرهان العقلي في الدفاع عن ياقوت ولكنه يعتمد كذلك على إفادات وشهادات العلماء الراسخين مثل الذهبي والصفدي، المعاصرين لياقوت. وذلك جزء من منهجه في التوثيق. وأخيرًا يلجا المنجد إلى التحليل النفسي لتفسير أسباب نقد القفطي لياقوت، مضمنًا ذلك قاعدة مهمة في تحقيق الروايات تجعل المعاصرة سببًا في القدح وعدم قبول بعض نقد الرواة لمعاصريهم. يقول المنجد «فمزاعم القفطي إذًا لا تثبت للنقد. وإنما هي مطاعن لا نبل فيها. وأغلب الظن أنه داخله الحسد من رجل رومي، فقير، ناسخ، يتجر بالكتب، رآه يؤلّف فيحسن التأليف وينشئ فيحسن الإنشاء، وياتي بما لم يأتِ به من سبقه من المؤلفين فأراد أن يضع من شأنه. وكثيرًا ما يحدث هذا بين العلماء المتعاصرين، وقد قيل: المعاصرة حرمان»67.
وكما سلفت الإشارة تحدث المنجد عن منهج البلاذري ضمنًا دوت أن يضعه تحت عنوان مستقل. وقد فعل ذلك مع ابن خلكان وذلك في ضمن حديثه عن مصادره، وذكر في هذا نقاطًا مهمة مثل قوله «اتبع في تأليفه منهجًا واحدًا واضحًا، يتلخص فيما يلي:
1- لم يذكر فيه أحدًا من الصحابة ولا التابعين إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة الناس إلى معرفة أحوالهم.
2- لم يذكر أحدًا من الخلفاء اكتفاءً بالمصنفات الكثيرة في هذا الباب.
3- ذكر كل من له شهرة من الماضين يقع السؤال عنه بين الناس.
4- ذكر إلى ذلك جماعة من الأفاضل الذين شاهدهم أو نقل عنهم، أو كانوا في زمانه ولم يرهم.
هذا من حيث اختيار المترجم لهم. أما نهجه في مادة الترجمة نفسها، فهو ما يلي:
1- أثبت وفاة المترجم له، إن قدر عليه ورفع نسبه.
2- ذكر من محاسن كل شخص ما يليق به.
3- قيد من الألفاظ في آخر كل ترجمة، ما لا يؤمن تصحيفه.. وعلى الجملة فهو يحاول في تراجمه أن يقدم لم، بقدر ما تمده به المصادر، أو بحسب معرفته، صورة تامة شاملة للمترجم له. «فليست الترجمة عنده مواد تجمع وتسرد، بل تجمع وتغربل وتصاغ وتنقَّى»68. ويضيف المنجد إلى ذلك تحديد ابن خلكان الدقيق لمصادره، فيذكرها بأسمائها وعندما لا يعرف المؤلف «نجده ينقل من رسائل مجهولة المؤلف، فنراه يقول أحيانًا رأيت في بعض الرسائل، ولا أتحقق الآن صاحبها، ... أو... وجدت في بعض تعاليق بخطي وما أدري من أين نقلته.»69
ذلك عن منهج ابن خلكان والبلاذري أما عن منهج ياقوت فيصير اهتمام المنجد أكبر، ففي حديثه عن ثقافة ياقوت يقول «على أن الذي يبصر في هذه الثقافة التي تجلّت في معجم البلدان هو التنظيم والمنهج. فعندما يتحدث عن البلدان يبدأ دائمًا بضبط اسم البلد، ويذكر اشتقاقه، وعرضه وطوله، وأثر الكواكب فيه، وخواصهالطبيعية، ومعادنه، وسكانه، والحوادث التاريخية التي جرت فيه ويذكر الأعلام الذين خرجوا منه إلا في البلاد التي لا شان لها»70. وتحدث المنجد بتوسع عن اعتماد ياقوت على منهج الشك والنقد، ووضع لذلك عنوانًا مستقلًا، بدأه بعبارة تدل على أن المنجد نفسه يستخدم هذا المنهج «الشك سبيل الباحث إلى الحقيقة.. ومنقذه من الفوضى التي تلحق بالأخبار والاضطراب الذي يعتري الروايات.. وهو دليل على يقظته وتثبته»71
ويوضح المنجد اهتمام ياقوت بنقد الكتب المخطوطة ونقد من سبقه من المؤلفين ونقد الرواة. ونقد الروايات. وهو يورد الخبر ثم يصححه، ولا يقطع بصحة الخبر حتى يسأل، ويورد الخبر وينبه إلى بطلانه، وأحيانًا يورد الخبر ويتبرأ منه تمامًا، ويورد الروايات المختلفة حول الموضوع الواحد، ويذكر الخبر مسندًا إلى قائله. إن تتبع المنجد لهذه النقاط وتفصيله حولها يدل على أنه قد قام بدراسة. وهذا يعود أساسًا إلى طبيعة عمل ياقوت، خاصة في معجم البلدان، فهو بشموله ودقة تنظيمه واعتماده على المصادر الشفاهية والكتابية والمشاهدة، يوفر للدارسين فرص الدراسةالمنهجية أكثر من الأعمال التي تقوم على الأخبار فقط أو تركز عليها دون غيرها من مصادر البحث.
وفي ختام مقالات المنجد عن الأعلام الخمسة، لا بد من إثبات أنه كان قوي الارتباط وثيق الصلة، علميًّا ونفسيًّا، بهؤلاء العلماء المفكرين، يقترب منهجه من منهجهم- خاصة وأن عمل التحقيق يجمع بين المنجد وبينهم، على اختلاف ميادين التخصص. ومع ذلك لم يكن الارتباط النفسي والإعجاب، إلى درجة الانبهار، يمثل أساسًا ذاتيًا لاختيار المنجد للمترجم لهم أو للمؤلفات التي ينتخبها من أعمالهم لتمثلهم في دراساته. وذلك لأنه كان مدركًا تمامًا وقاصدًا أهم القمم في الفكر والتراث الإسلامي، خاصة ما ارتبط بالشام. لقد ذكر عن فتوح البلدان للبلاذري «ولا نعرف مؤلفًا في الفتوح بعد أحمد بن يحيى، فهو كما قيل خاتمة مؤرخي الفتح.. كتاب البلاذري هذا هو أهم مصدر من المصادر التاريخية وأكثرها صحة عن الفتوح العربية»72. ويذكر عن معجم البلدان لياقوت «وقد عرف ياقوت نفسه شأن معجمه فذكر أنه بالنسبة لما ألف قبله أوحد في بابه، مؤمَّر على جميع أضرابه وأترابه.
وذكر المستشرق الفرنسي كاراده فو في كتابه مفكرو الإسلامأن معجم البلدان من المؤلفات التي يحق للإسلام أن يفخر بها كل الفخر»73. ويقول عن وفيات الأعيان لابن خلكان: «يعتبر كتاب وفيات الأعيان أجود كتاب في التراجم عرفه تراثنا التاريخي. فلا نعرف مثله كتابًا أفرد للتراجم اشترطت فيه شروط خاصة مثله، ولا نعرف بعده كتابًا مثله بلغ درجة إتقانه وتحريره وتنقيحه وتثبته. فهو يمثل ذروة من الترجمة في التاريخ العربي»74. ولا شك أن سير أعلام النبلاء للذهبي يمثل إنجازًا ركنيًّا في أعمال التراث الإسلامي. أما كتاب الصفدي أمراء دمشق فله أهمية نسبية أساسية بالنسبة لتاريخ دمشق، وهي من حواضر الإسلام الكبرى، وتجد عند المنجد وضعًا خاصًا.
تحليل نص المنجد حول مدن دمشق والقاهرة وبغداد
تتبع المنجد ما كتبه الرحالة المغاربة والأندلسيين الذين زاروا المدن الثلاث المذكورة منذ ايام الفاطميين في مصر والشام حتى عام 1301/ 1884. ومع ذلك فإن كتابات معظم أولئك الرحالة تعود إلى الفترة من القرن السادس إلى الثامن الهجري. وكما ذكر سابقًا فإن هذه الفترة تمثل انتقال الثقل الثقافي والسياسي من العراق إلى الشام ومصر، ويرى المنجد أن دمشق في القرن السادس الهجري سبقت القاهرة في كونها عاصمة المشرق العربي: «دمشق أصبحت في القرن السادس، وقبل القاهرة، مركزًا علميًا للشرق العربي كله. فقد بعث فيها نور الدين السنّة، وقضى على المذهب الشيعي، وأقام فيها المدارس واستحضر العلماء. فازدحم بها الطلبة وقصدوها من كل صوب. ثم قويت هذه النهضة أيام صلاح الدين وأخلافه من الملوك الأيوبيين»75. وللمنجد كتاب مستقل عن دمشق صدر في بيروت عام 1959 بعنوان دمشق في القرن السادس الهجري سبق كتابه، الذي نحن الآن بصدده، عن رحلات المغاربة إلى المشرق والذي صدر أيضًا في بيروت عام 1963م.
لا بد من ملاحظة أن انحصار مصادر المنجد في المؤلّف المذكور عن المدن الثلاث في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين، يمنح المادة المذكورة صفة تخصصية تبعدها عن أن تكون المصدر الأساسي لتاريخ هذه المدن العام. وذلك لأن كتابات المشارقة هي الأساس في هذا الشأن، ومن بين أهمها ابن عساكر (ت 571/ 1176) عن دمشق، والمقريزي (ت 845/ 1441) عن القاهرة، والخطيب البغدادي (ت 463/ 1071) عن بغداد. وقد استأنس المنجد ببعض هذه المؤلفات المشرقية. مثل تاريخ دمشق لابن عساكر والخطط للمقريزي، في التعليق على نصوص الكُتّاب المغاربة والأندلسيين عن المدن المذكورة. ومع الطابع التخصصي والانحصاري للروايات المغربية والأندلسية، فإنها تمثل مصادر أساسية عن هذه المدن في الفترات التي تلت وفاة المؤرخين المشارقة الثلاثة المشار إليهم. يضاف إلى هذا أنها تحمل طابعًا هامًّا يتمثل في كونها كتب رحّالة أجانب عن هذه المدن، مما يتيح لهم فرصة الملاحظة بصورة أفضل من الذين اعتادوا على الحياة فيها. وفيها بجانب كل هذا ميزة الكتابة على أساس المشاهدة، القائمة على قصد البحث والتحري. غير أن من عيوب هذا النوع من الكتابات، ولم ينوه المنجد بذلك، هو طابعها الانطباعي الذي قد لا يخلو من تسرّع في حالة قِصر إقامة المؤلف الرحّالة في المدينة، وفي بعض الأحيان يرتبط بهذا الجانب الانطباعي المتسرّع نزعة للتحامل على أهل هذه المدن، إذا لم يجد الغريبُ الزائرُ ما يتوقّعه من حفاوةأو مساعدة أو غذا وجد العَنت وسوء المعاملة من البعض، أو إذا شعر بالغربة والوحشة وقويت فيه نزعة التعصّب لأهله ودياره. ولعل من الأمثلة الواضحة هنا ما كتبه العبدري عن أهل القاهرة في أواخر القرن السابع الهجري، مما سيرد ذكره. ولا بد أن نلاحظ هنا أن المنجد لم يبذل جهدًا كافيًا لتفنيد ما كتبه العبدري عن القاهرة، بل وأظهر بعض الموافقة له بصورة ضمنية أو صريحة. وهذا يخالف ما فعله مع ابن جبير عندما وجّه انتقادًا لطيفًا وخفيفًا لبعض عادات أهل دمشق، فتصدّى له المنجد بالنقد الرقيق وردّ بعض ما قاله لكونه غريبًا عن المنطقة يشاهد ما لم يألفه، وبالتالي أخفق في فهم الأبعاد الحقيقية لما شاهده من مظاهر السلوك الدمشقي. ولكن لا بد من ملاحظة أن من صميم منهجه هو النقل الأمين لكل الروايات بجانب التعليق عليها، وقد وجه فعلًا إشارة نقدية طفيفة للعبدري76.
كتب المنجد حواي خمس وثلاثين صفحة عن دمشق، وخمسين صفحة عن القاهرة، وثمانية صفحات عن بغداد، كلها من القطع المتوسط. أي ان كتاباته عن هذه المدن جاءت في شكل المقال المتوسط أو القصير.
اعتمد المنجد في المرويات التي ساقها عن دمشق على عدد من الرحّالة والمؤلفين، أهمهم ستة، وهم: أبو بكر بن العربي، وقد زار المدينة عام 491 في فترة الفاطميين. وهو قاضي إشبيلية، وقد ضاعت المخطوطة التي تضمنت أخبار رحلته واعتمد المنجد على نُقول منها في بعض المصادر، من أهمها كتاب المقري نفح الطيب. وقد علم المنجد بوجود قطعة صغيرة من هذه المخطوطة في خزانة مدينة الرباط العامة بالمغرب، ولكنه لم ير77 هذه القطعة. والقطعة الوحيدة التي أثبتها المنجد للقاضي ابن العربي، في رحلته إلى دمشق، تتعلق بطريقة وضع مائدة الطعام واستخدام الماء الجاري في نقل وإرجاع الأواني في الدور الدمشقية، وقد سبقت الإشارة إليها. ويأتي الشريف الإدريسي، في كتابه نزهة المشتاق في ارتياد الآفاق المصدر التالي زمنيًّا الذي ينقل عنه المنجد بعد ابن العربي. وقد زار الإدريسي دمشق سنة 510، وذكر المنجد أنه اضاف «إلى ما نقله من ابن حوقل أشياء جديدة انفرد بها»78. ومن ذلك وصفه للمصنوعات الدمشقية الحريرية وغيرها من النسيج. وذكر عن النسيج الدمشقي: أنه «يضاهي ديباجها ديباج الروم، ويقارب ثياب تستر، وينافس أعمال أصبهان ويسمو على طُرز نيسابور»79. وأشار الإدريسي إلى خصب أرض دمشق وما تنتجه من الحبوب والفواكه وإلى ازدهار التجارة فيها80. وقد كتب الإدريسي تلك الملاحظات في فترة حكم السلاجقة لدمشق.
ينقل المنجد بعد الإدريسي من بنيامين التطيلي، من يهود الأندلس، وذكر انه «جاء إلى دمشق قبل أن يدخلها نور الدين سنة 54981. وقد كتبها بالعبرية، ووصف ازدهار التجارة في دمشق، كما فعل الإدريسي. وتميز بكتابته عن أوضاع اليهود في دمشق مع ذكر بعض الإحصاءات عن ذلك. ذكر بنيامين (ويقيم بدمشق نحو ثلاثة آلاف يهودي، بينهم العلماء وذوو اليسار. وفيها نحو المائتين من القرائين، ومن الكوتيين (السامريين) نحو الأربع مئة. وهذه الجماعات على صفاء فيما بينها، لكن أفرادها لا يتزوجون بغير بنات نحلتهم)82. ويدل هذا النص على أوضاع التسامح والتعايش بين المسلمين واليهود. وقد أوضح بنيامين عظيم اتساع دمشق وطبيعتها الجميلة المخضرة وكثرة المجاري المائية فيها من نهر بردى ومحيطها الريفي الواسع إضافة إلى فخامة جامعها الكبير، «ودمشق مدينة كبيرة وجميلة يدور بها سور، وتحيط بها قرى فائقة الحسن تمتد نحو 15 ميلًا. وحدائقها وبساتينها تبلغ من الجمال حدًا قلّما يوجد مثله في الدنيا. يخترقها نهر أبانا (بردى) الذي تُحمل مياهه إلى دور كبار الناس في أنابيب، كما تنقلها القساطل إلى الشوارع والأسواق.. وتجارتها واسعة.. ويقيم بها تجار من جميع الأقطار، وجامعها قلّما يساويه بناء آخر فخامته.»83
ويأتي بعد بنيامين ابن جبير، الذي زار دمشق أيام صلاح الدين الأيوبي سنة 581. ويقرر المنجد أن نص ابن جبير عن دمشق «يعتبر من أغنى النصوص التي تفيد في التأريخ لدمشق في القرن السادس»84، وأن ابن بطوطة عندما زار دمشق بعد حوالي خمسة وأربعين عامًا من زيارة ابن جبير لها لم يأت بشيء جديد «بل وكد الملاحظات العامة التي سجلها قبله ابن جبير. لكنه لم ينتقد أهلها»85.
وصف ابن جبير دمشق جغرافيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. ووصف الجامع الأموي، فوضح مساحته وأبعاده «وعدد بلاطاته، ونوافذه الزجاجية المذهبة الملونة (شمسياته) ومقاصيره وصوامعه وأبوابه وساعاته العجيبة التي كانت على يمين الخارج من باب جيرون ووصف ما يحيط به من الأسواق»86. وقد قارن المنجد بين وصف ابن جبيرللجامع الأموي (581) ووصف المهلبي الفاطمي له قبل حريق المسجد أيام الفاطميين سنة 461 بما يقارب المائة عام، ووجد المنجد اختلافًا قليلًا بين الوصفين، استنتج منه ما بذله السلاجقة ونور الدين من جهود لإعادة البهاء والجمال إلى هذا المسجد بعد حرقه. وصف ابن جبير حلقات العلم والدراسة في الجامع الأموي ومدارس دمشق وكثرة أوقافها على العلم والمساجد، «حتى أن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه. وكل مسجد يستحدث بناؤه أو مدرسة أو خانقاه يعين لها السلطان أوقافًا تقوم بها وبساكنيها والملتزمين لها. وهذه من المفاخر المخلدة87. والجزء الأخير من هذا النص يدل على أن ذلك، بهذه الدرجة، مما تنفرد به دمشق. وقد ركز ابن جبير على إبراز دور أميرات دمشق في إنشاء الأوقاف فقدّمهن في الترتيب على الأمراء «ومن النساء الخواتين (أي الأميرات) ذوات الأقدار من تأمر ببناء مسجد، أو رباط، أو مدرسة وتنفق فيها الأموال الواسعة، وتعين لها من مالها الأوقاف ومن الأمراء من يفعل مثل ذلك، لهم في هذه الطريقة المباركة مسارعة مشكورة»88. وتشمل الأوقاف بجانب المساجد والمدارس والمستشفيات. ووصف ابن جبير بيمارستان نور الدين، وهو أكبر مستشفيات دمشق عند زيارته لها. ذكر عنه «بناه نور الدينوجعله وقفًا على الفقراء دون الأغنياء، ووقف عليه أوقافًا كثيرة. كان التمريض فيه مجانًا، وكانوا يقدمون فيه للمرضى الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل إنسان. وكان يطبِّب فيه كبار الأطباء وفيهم أطباء السلطان. فإذا فرغوا من معالجة المرضى ألقوا في إيوانه الكبير دروس الطب على التلاميذ. فكان هذا المكان مدرسة للطب ومستشفى للمرضى»89.
ووصف ابن جبير كذلك تجارة دمشق وأسواقها وأوضح أن هذه التجارة لم تتأثر بالحروب بين المسلمين والصليبيين التي كانت دائرة في هذه الفترة «واختلاف القوافل من مصر إلى الشام، على بلاد الإفرنج غير منقطع. واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك. وتجار النصارى أيضًا لا يُمنع أحد منهم ولا يُعترض. وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم.. وتجار النصارى أيضًا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم. والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال. وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافية، والدنيا لمن غلب»90. علق المنجد على هذا النص بقوله «وهذه ملاحظات ذات شأن كبير لمعرفة الحالة الاقتصادية في دمشق والشام أيام صلاح الدين والحروب الصليبية، تبين أن الخلاف السياسي والديني بين المسلمين والصليبيين لم يمنعهم من التبادل التجاري، وأن دمشق كانت مركزًا سياسيًّا حربيًّا، وفي الوقت نفسه مركزًا تجاريًّا مهمًّا»91. وهذا مثال آخر على قدرة المنجد على استخلاص التعميمات التاريخية من النصوص ذات الموضوع المحدود. ويمكن أن يضاف هنا إلى ملاحظات المنجد أن نص ابن جبير السابق يدل على تعمق الروح المدنية في مجتمع الحاضرة الإسلامية، حتى أن الحرب لا تؤثر عليها ولا تؤثر على نظم الحرية الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بذلك من ازدهار. ولا شك أن عبارة ابن جبير السابقة «وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافية والدنيا لمن غلب» تدل على عمق التفكير وقدرة على الاستبصار عند ابن جبير.
ركّز المنجد على عرض ما أورده ابن جبير عن حسن معاملة أهل دمشق للمغاربة. ومقابل ذلك ما سيأتي ذكره لاحقًا عن تركيز المنجد على عرض سوء معاملة أهل القاهرة للمغاربة. ومن مظاهر إكرام الدماشقة للمغاربة92. أن الأموال كانت تجري على طلاب العلم والعلماء منهم ويتم بذل المال لافتداء أسرهم عند الصليبيين ويتزاحم الناس للصلاة خلفهم ويبالغ الناس في إكرام الضيوف منهم، حتى ولو كانوا فقراء، حتى أن ابن جبير يدعو طلاب العلم في المغرب إلى الرحيل إلى دمشق «فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد، ويتغرب في طلب العلم. فيجد الأمور المعينة كثيرة وأولها فراغ البال من أمر المعيشة»93.
وانتقد ابن جبير ما اعتبره ما لا يليق من عادات التزلف وإهانة النفس عند التحية والسلام، دوت تفرقة بين تحية عظيم أو صغير. يقول المنجد «ولقد سخر ابن جبير من عمائم أهل دمشق وأنها تهوي بينهم في سلامهم هويًّا»94. وردّ المنجد دفاعًا عن عادات الدمشقيين التي انتقدها ابن جبير إلى درجة الحدة عندما قال عن ركوع الدمشقيين في السلام «كنا عهدناه لقينات النساء وعند استعراض رقيق الإماء. فيا عجبًا لهؤلاء الرجال كيف تحلّوا بِسمات ربات الحجال»95. قال المنجد «لعل سبب هذا النقد أن ما رآه كان مخالفًا لعادات الأندلسيين فما نسبه إلى الدمشقيين لا يعدو المجاملة في السلام والتخاطب. والمجاملة أثر من آثار الحضارة ونتيجة للتجارب التي يمر بها الإنسان. ولقد ألِف الدمشقيون الحضارة. ومر بهم في تاريخهم الطويل من النكبات والتجارب ما جعلهم يجاملون. في حين ظل في أخلاق الأندلسيين لأسباب شتى جفاء من جفاء البداوة وجفاء البربر. ثم إن الأندلسيين تأثروا بالفرنجة في تعظيم ملوكهم والخضوع لهم. في حين ظلت المساواة بين الرئيس والمرؤوس- وهي التي ينص عليها الإسلام- قائمة عند الدمشقيين، وخاصة في عصر نور الدين وصلاح الدين»96، وبالرغم من هذا الدفاع الحار النابع من حساسية خاصة، فإن المنجد لا يتخلى عن الموضوعية فيعترف بأن مجاملة الدمشقيين لا تخلو من مصانعة لأصحاب القوة، نتيجة تجارب القهر في تاريخهم، وهو لم يقل هذا بصريح العبارة لكنه واضح في ما تحته خط من النص السابق.
بعد هذه الإفادة الأساسية من ابن جبير عن دمشق، تأتي إفادتان أساسيتان أخريتان، هي لابن بطوطة وقد زار دمشق سنة 726 والمقري الذي زارها سنة 1027. غير أن المنجد أشار قبل تناوله لإفادة ابن بطوطة إلى بعض الرحّالة المغاربة والأندلسيين، ممن وجد أخبارهم في كتب مثل معجم البلدان لياقوت ونفح الطيب للمقري، مثل عبد المنعم عمر الجلياني، الذي ركّز على مدح دمشق وذكر فضائلها من كونها مقامًا للصالحين مع ذكر طبيعتها الجميلة. وعبد المنعم هذا معاصر لابن جبير. ذكر المنجد كذلك ثلاثة من الأندلسيين زاروا دمشق بصفة عابرة وسجلوا إشارات عنها97، أوردها المقري، ولكنهم في القرن السابع الهجري، وهم أبو العباس أحمد الشريشي، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد، ومحمد بن عمر بن محمد بن رشيد. ولم يخرج ما ذكروه وحفظته المصادر الموجود حاليًا كثيرًا عن ما ورد ذكره سابقًا. وهذا ينطبق على ابن الحاج الغرناطي، وهو من الأندلسيين الذين زاروا دمشق بعد ابن بطوطة في القرن السابع الهجري ومخطوطته مفقودة، لكن المقري أخذ جزءًا منها في كتاباته ويرى المنجد أنها تميل إلى مدح دمشق وعلمائها98.
يرى المنجد أن ابن بطوطة لم يخرج عن الخطوط العامة التي كتبها ابن جبير في وصف دمشق، غير أن دقائق وصفه تختلف عن دقائق وصف ابن جبير99. وقد وصف ابن بطوطة جمال طبيعة دمشق وفخامة الجامع الأموي، لكن وصفه لهذا الجامع أقل دقة من وصف ابن جبير100، وتحدث عن عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد ونشاط العلماء فيها- خاصة في الفقه، ومن ذلك مشاهدته لابن تيمية ووصفه له «أنه من كبار الفقهاء الحنابلة، يتكلم في الفنون، إلا أنَّ في عقله شيئًا»101. وأثبت ابن بطوطة إكرام أهل دمشق للمغاربة وأتى بتفصيلات إضافية عن الأوقاف في دمشق وأنواعها مما لم يأت به ابن جبير، «فذكر أن منها ما هو للعاجزين عن الحج، ومنها أوقاف لتجهيز البنات إلى أزواجهن، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تزويجهن، ومنها أوقاف لفكاك الأسرى، وأوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويردون إلى بلادهم، ومنها أوقاف لتعديل الطرق ورصفها، وأوقاف للأواني المكسورة فإذا كسرت الأواني حملت شقفها لصاحب أوقاف الأواني، فيدفع ثمنها ليشتري به بدل عنها. وهذه الأوقاف توجد كلها إلى جانب الأوقاف الفخمة على المدارس والعلم»102. وهذا النص مهم جدًا، ولم يجد حظه من التحليل عند المنجد، وهو يدل على نظام الرعاية الاجتماعية في تلك الحقبة وعلى مفاهيم مهمة عن النظم الحضرية، تجاوزت ما تأمر به النصوص الفقهية التقليدية.
وإذا كان ابن بطوطة رحّالة محترفًا يزور البلدان بقصد التعرف عليها والسياحة والكتابة عن ذلك، فإن المقري، صاحب نفح الطيب، كان من علماء الحديث والأخبار، يسافر لهذا الغرض المختلف، وقد زار دمشق في القرن الحادي عشر (1027) واستوطن فيها مدة «وأملى صحيح البخاري بالجامع الأموي، تحت قبة النسر بعد صلاة الصبح، فلما كثر الناس ضاق المسجد، على سعته. فخرج إلى صحن المسجد. وحضر غالب علماء دمشق. وعندما ختم الصحيح اجتمع الألوف من الناس، وعلت الأصوات بالبكاء. وأُتي له بكرسي الوعظ فصعد عليه وأشرف على الناس وازدحم الحاضرون على تقبيل يده»103. وهذا مشهد مهم يدل على بعض مظاهر النشاط الديني العلمي في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر الهجري، يعكس لنا اتصال المشارقة بالمغاربة. وقد ركز المقري على التغني بمحاسن دمشق وصفات أهلها. وذكر أن من أسباب تأليفه لكتابه العظيم نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب أهل الشام، فقال في مقدمة ذلك الخطاب «إن الداعي لتأليفه أهل الشام، أبقى الله مآثرهم.. وأن الفاتحين للأندلس هم أهل الشام ذوو النجدة والشوكة، وأن غالب أهل الأندلس من عرب الشام الذي اتخذوا بالأندلس وطنًا مستأنفًا وحضرة جديدة»، وأن «غرناطة نزل بها أهل دمشق وسموها لشبهها بها في القصر والنهر، والدوح والزهر، والغوطة الفيحاء»104. وهذه الصلة بين الشام والأندلس، قد أبرزها المنجد بوضوح في معرض تفسيره للارتباط بين المغاربة والدمشقيين105. وهو يضع الأندلسيين ضمن المغاربة ويخرج منهم المصريين.
إن الصورة التي يبرزها المنجد لدمشق من خلال تتبع المصادر في غاية من الإشراق والبهاء؛ فهي مدينة منظمة، نظيفة، متحضرة، يتصف أهلها بالتهذيب والكرم ولها نظمها المالية والإدارية الحسنة واقتصادها التجاري المزدهر، أما طبيعتها فهي أشبه شيء في الدنيا بالجنة. وتلك صورة مخالفة إلى حد كبير عن الصورة التي أبرزها المنجد للقاهرة، المعاصرة لدمشق، مع أن عظمة القاهرة أيضًا واضحة في النصوص التي اختارها المنجد- بجانب مثالبها ومثالب أهلها.
* * *
زار القاهرة من المغاربة والأندلسيين الذين أورد المنجد كتاباتهم عنها ثمانية، هم: أبو الصلت أمية وكانت زيارته في 510، ابن جبير في 581، العبدري في 688، ابن سعيد الأندلسي في القرن السابع (دون تحديد سنة)، البلوي في القرن السابع(دون تحديد زمن، توفي بعد 736)، ابن بطوطة في 725، العياشي في 464، محمد بيرم الخامس في (1296 و1302).
وقد كتب أبو الصلت أمية الرسالة المصرية، وابن جبير الرحلة، وكتب العبدري كذلك الرحلة وقال عن ذلك المنجد «وما تزال رحلته مخطوطة، وهي مما ينبغي نشره. وقد اختصرها ابن قنفد صاحب الوفيات»106. أما وصف ابن سعيد للقاهرة فقد حفظه المقري في نفح الطيب ولم يصل كتابه الأصلي. وأما البلوي فكتابه مخطوطة لم تنشر، حسب إفادة المنجد، بعنوان: تاج المفرق في تحلية أهل المشرق. وكتب ابن بطوطة عن القاهرة في كتابه تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وأشار المنجد إلى المقري الذي زار القاهرة عام 1028وتزوج بها، ولكن لم يتم إثباته هنا لأنه لم يرد عنه شيء يذكر. وكتب العياشي كتابه عن القاهرة ونشر باسم رحلة العياشي. وأخيرًا كتب محمد بيرم الخامس إفادته عن القاهرة في كتابه صفوة الاعتبار، وهو منشور.
يلاحظ أن الكتابة بواسطة المغاربة عن المشرق، تمتد باتجاه العصر الحديث عن القاهرة بخلاف دمشق. كما نلاحظ أن ابن جبير وابن بطوطة فقط مشتركان في الكتابة عن دمشق والقاهرة معًا، إذا استبعدنا المقري الذي زار المدينتين.
عند مقارنة الإفادات المختلفة تبرز وجوه الشبه بين دمشق والقاهرة، ففي الحالتين اهتم الرحّالة بوصف المساجد والمدارس والبيمارستانات وازدهار التجارة والنشاط العلمي الإسلامي والأحوال المتصلة بالحرب مع الصليبيين في فترتي الأيوبيين والمماليك. أما وجوه الاختلاف بين المدينتين فتبرز في تركيز المصادر على الازدحام الشديد في القاهرة، مما يدل على ارتفاع الكثافة السكانية، وما يصحب ذلك من فوضى في الحركة (انظر وصف ابن سعيد) وتردٍّ في مستوى النظافة في الطرق والأسواق- وذلك بخلاف دمشق في ما يبدو، التي لم يذكر عنها سوى النظام والجمال. ويظهر اختلاف كبير بين مظاهر السلوك والأخلاق العامة في المدينتين، وقد أبدى معظم الرحّالة المغاربة والأندلسيين سخطهم على طرق معاملة المسؤولين لهم، خاصة عند أخذ الضرائب والمكوس، واستنكروا بعض عاداتهم مثل تناول الطعام في الطرقات وبذاءة اللسان، وعدم الاهتمام بالنظافة والبخل والاحتيال والتأثر بالمشعوذين والتفسخ الأخلاقي.. إلخ. وقد ركز المنجد على إبراز هذه الجوانب وكل ما وجهه من انتقاد تمثل في ضرورة ذكر المحاسن بجانب المساوئ، وقد جاء في تعليقه على ما ذكره العبدري لقد وصف العبدري القاهرة وأهلها وصف ناقد، حاذق، وكان قوي الملاحظة، فسجل ما رآه من العيوب التي أحسها هو عند المصريين، من مثل سوء الخلق، وقلة الوفاء، والعقوق والزعارة، والنفاق، واتباع كل ناعق، والوسخ، وقلة النظافة، والعبودية، وبغضهم للغريب، وقلة الحياء، والبخل، والجبن والبعد عن الشجاعة، وتضييعهم للعرض، وكذلك الحسد، والغش، والمهانة والذل، ورقة الدين. فقارئ الرحلة يخيل إليه أن العبدري جمع عيوب أهل الأرض كلها في مصر. ولقد كان مولعًا بالعيوب لا المحاسن، ولكل أناس عيوب ومحاسن، إذ لا شك في أن عند أهل مصر محاسن ومناقب، ذكرها بعض الرحّالة. فشأن العبدري أنه سجل العيوب وحدها كما رآها. في حين أغفل الآخرون تسجيلها، وذكروا ما رأوه من جميل وحسن»107. والقول الأخير من المنجد غير دقيق لأن آخرين مثل أبو الصلت أمية ركز على مثالب المصريين، ومن ذلك قوله في الرسالة المصرية عن المصريين «أما أخلاقهم فالغالب عليهم اتباع الشهوات، والانهماك في اللذات، والاشتغال بالترهات والتصديق بالمحالات»108. وقال أيضًا «وأما زماننا هذا فقد دثر منها كل علم وامَّحى رسمه، وجهل اسمه، ولم يبق إلا رعاع وغثاء وجهلة دهماء، وعامة عمياء، وجلهم أهل رعانة، ولهم خبرة بالكيد والمكر، وفيهم بالفطرة قوة عليه، وتلطف فيه، وهداية إليه، لما في أخلاقهم من الملق والسياسة التي أربوا فيها على كل من تقدم وتأخر، وخصوا بالإفراط فيها دون جميع الأمم، حتى صار أمرهم في ذلك مشهورًا، والمثل بهم مضروبًا»109.
ويبدو أن اكثر مما يسبب الاندهاش للرحّالة المغاربة والأندلسيين عند زيارتهم للقاهرة ما يرونه من مظاهر التحرر الاجتماعي الغريبة على مجتمعاتهم المحافظة، وقد أظهر هذا واحد من المعتدلين وهو ابن سعيد الأندلسي، فقال «ووجود السماع والفرج في ظواهرها ودواخلها، وقلة الاعتراض فيما تذهب إليه نفسه، ويحكم فيها كيف شاء من رقص وسط السوق، أو تجريد أو سكر من حشيشة، أو صحبته مردان وما أشبه ذلك، بخلاف غيرها من بلاد المغرب.. وعامتها يشربون المزر الأبيض المتخذ من الحنطة، حيث أن الحنطة يطلع سعرها بسبب ذلك، فينادي المنادي من قبل الوالي بقطعه وكسر أوانيه، ولا ينكر فيها إظهار أواني الخمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار، ولا تبرج النساء العواهر، ولا غير ذلك مما ينكر في غيرها من بلاد المغرب، وقد دخلت في الخليج الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فيما يلي القاهرة فرأيت فيه من ذلك العجائب وربما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب»110 أورد المنجد تعقيبًا على قول ابن سعيد هذا «وقد قرأ المقريزي ما ذكره ابن سعيد عن المزر وأواني الخمر، وتبرج النساء العواهر، مما ينكر في غيرها من بلاد المغرب، وما يقع في الخليج من القتلى بسبب السكر، فقال: في هذا تحامل كثير. لكن المقري عقب عليه فقال: «ومن نظر بعين الإنصاف علم أن التحامل في نسبة الحامل إليه»111. وهكذا يبدو أن المقري كفى المنجد مؤونة الرد.
بجانب اللهو الحرام أشارت بعض المصادر إلى اللهو البريء في القاهرة، ومن ذلك اللعب بالحيوانات في الطرقات مما ذكره العياشي في وصفه لمنظر أمام القلعة «وهناك خلق من المصريين يلعبون في سائر الأيام كأنواع المشعوذين وأصحاب القرود، ومن ضاهاهم من أصحاب اللعب بأنواع الحيوانات كالدب والحمير والتيوس والكلاب.. وبالجملة فأهل مصر لهم ذكاء زايد وحيل غريبة، فقد سخرت لهم أنواع الحيوانات فقليل من أصناف الحيوانات ما لا يوجد عندهم مسخرًا»112، وأشارت المصادر المتمثلة في كتابات الرحّالة المغاربة، إلى آثار مصر مثل الأهرامات وجمال النيل واتساع العمران، يقول العبدري «وأما أرض مصر ونيلها وعجائبها وخصبها واتساعها فأكثر من أن يحصرها كتاب أو يحيط بها حساب... ونيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعًا وغاية وانتفاعًا. وقد وضعت عليه المدائن والقرى فصار كسلك انتظم دررًا»113. ويقول العبدري أيضًا عن خصوبة أرض مصر وعمرانها «وما ظنك أخرى، ولا بستان إلا وهو يسامي آخر، ولا مدينة إلا وهي تشير إلى أختها»114. ويذكر ابن بطوطة في مستهل حديثه عن القاهرة: «ثم وصلت إلى مدينة مصر. هي أم البلاد، وقرارة فرعون ذي الأوتاد المتناهية في كثرة العمارة، المتباهية الحسن والنضارة، مجمع الوارد والصادر ومحط رحل الضعيف والقادر، وبها ما شئت من عالم وجاهل، وجاد وهازل، وحليم وسفيه، ووضيع ونبيه، وشريف ومشرف، ومنكر ومعروف، تموج موج البحر بسكانها، وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها، قهرت قاهرتها الأمم، وتمكنت ملوكها من نواحي العرب والعجم»115. ويبدو أن نص ابن بطوطة هذا أكثر تمثيلًا لحقيقة القاهرة في القرن الثامن الهجري، وهي حقيقة لم تتغير كثيرًا منذ وصولها إلى أوج ازدهارها في العصور الوسطى أيام الفاطميين.
إن مظاهر العمران والفخامة والتجارة الغزيرة والأسواق، بجانب الأزهر وغيره من الجوامع وحلقات العلم والعلماء ووجود الأضرحة- مثل الحسين والسيدة نفيسة وغيرهما من آل البيت وقبر الشافعي وغيره من العلماء، إضافة إلى رواج اللهو والتسلية، مما ذكرته المصادر موضوع البحث، كان من عوامل جذب الزائرين والمهاجرين من شتى بقاع العالم الإسلامي. وقد قصدوها لأغراض مختلفة مثل طلب الثراء أو طلب العلم أو السياحة والفرجة أو تبركًا بالمشاهد أو تواصلًا بين أهل الطرق الصوفية. وقد خص ابن بطوطة القاهرة- دون دمشق- بوصف دقيق لزوايا الصوفية بها وكيف أنها تستقبل المريدين من المسافرين وتمدهم بالمأوى والمأكل والمشرب وتعد لهم مناخًا صالحًا للذكر والعبادة، وذلك في نسق جماعي له آدابه وطقوسه «وأما الزوايا فكثيرة، وهم يسمونها الخوانق، واحدتها خانقة. والأمراء بمصر يتنافسون في بناء الزوايا. وكل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء. وأكثرهم أعاجم. وهم أهل ادب ومعرفة بطريقة التصوف. ولكل زاوية شيخ وحارس. وترتيب أمورهم عجيب. ومن عوائدهم في الطعام أنه يأتي خديم الزاوية إلى الفقراء صباحًا فيعين له كل واحد ما يشتهيه من الطعام. فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه ومرقه في إناء على حدة، لا يشاركه فيه أحد وطعامهم مرتان في اليوم. ولهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف، ومرتب شهري من ثلاثين درهمًا للواحد في الشهر إلى عشرين، لهم الحلاوة من السكر في كل ليلة جمعة. والصابون لغسل أثوابهم. والأجرة لدخول الحمام والزيت للاستصباح، وهم أعزاب، وللمتزوجين زوايا على حدة»116.
ومن المؤسسات المهمة المارستان، وصفه ابن جبير «وهو قصر من القصور الرائعة حسنًا واتساعًا» وذكر ما فيه من مقاصير وأسرَّة للمرضى، وما يقدّم فيه من الأغذية والأشربة والعقاقير وأردف أن بمصر- القديمة- «مارستان آخر مثل هذا»117. وقد فصل البلوى أكثر في وصف المارستان بالقاهرة «ولو لم يكن للقاهرة ما تذكر به إلا المارستان وحده لكفاها. وهو قصر عظيم من القصور الرائعة حسنًا وجمالًا واتساعًا، لم يعهد مثله بقطر من الأقطار أحسن بناء ولا أبدع إنشاء ولا أكمل إنهاء في الحسن والجمال.. يكمل فيه كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناقهين الخارجين منه أربعة آلاف نفس..»118 وفصل البلوي في تكاليف الإنفاق على المرضى مما وردت الإشارة إليه.
أورد البلوي إحصاءات عدة عن المراكب الجارية على النيل بالقاهرة «المعدة لإيساق الزرع خاصة، فألفوها تنيف على المئة ألف مركب، ما عدا الزوارق الصغار التي للصيد والركوب وغير ذلك فإنها أكثر من أن تحصى»119. وعن جِمال الروايا ودكاكين السقائين، ذكر البلوي أيضًا «أحصيت الجِمال الداخلة إلى القاهرة بالماء في كل يوم فبلغت إلى مائتي ألف جمل، ما عدا البغال..» وأحصى «دكاكين السقائين المعدة للسقي بالقاهرة، فبلغ ستين ألف دكان، ما عدا السقائين بالأكواز والأكواب في الطرق والأسواق وغيرها»120. أما ابن بطوطة وهو معاصر للبلوي، فيذكر أرقامًا أقل مما ذكره البلوي- ولكنها على أي حال مرتفعة جدًّا «ويقال إن بمصر (يعني القاهرة) من السقائين على الجمال اثني عشر ألف سقّاء، وأن بها ثلاثين ألف مُكار، وأن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفًا للسلطان»121.
علق المنجد على إحصاءات البلوي ذاكرًا أنها «مفيدة جدًّا في التأريخ لمصر، وتقدير عدد سكانها، ومعرفة جوانب من الحياة الزراعية والاقتصادية بها، أيام الناصر بن محمد بن قلاوون»122.
يوضح لنا ابن سعيد التباين الكبير في القاهرة بين قصورها الفخمة وحاراتها الشعبية المزدحمة المتسخة «الهمة السلطانية ظاهرة على قصور الخلفاء بالقاهرة، وهي ناطقة إلى الآن بألسن الآثار.. وقد عاينت فيه إيوانًا يقولون أنه بني قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن، وكان يجلس فيه خلفاؤهم، ولهم على الخليج الذي بين الفسطاط والقاهرة مباني عظيمة جليلة الآثار.. ولو كانت القاهرة كلها كذلك لكانت عظيمة القدر كاملة الهمة السلطانية، ولكن ذلك أمد قليل، ثم تسير منه إلى أمد ضيق، وتمر في ممر كدر خرج بين الدكاكين، إذا ازدحمت فيه الخيل مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور وتسخن منه العيون.. وأكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة، كثيرة التراب والأزبال، والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة، قد ضيقت مسالك الهواء والضوء بينها، ولم أر في جميع بلاد المغرب أسوأ منها حالًا في ذلك، ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري، وتدركني وحشة عظيمة حتى أخرج بين القصرين»123.
ويوضح ابن سعيد ما لمسه من فروق بين القاهرة وهي مدينة السلطان الرسمية وبين الفسطاط إلى جوارها، وهي المدينة الشعبية فيقول «والقاهرة هي أكثر عمارة واحترامًا وحشمة من الفسطاط لأنها المخصوصة بالسلطنة، لقرب قلعة الجبل منها، فأمور السلطنة كلها فيها أيسر وأكثر، وبها الطراز وسائر الأشياء التي يتزين بها الرجال والنساء»124. كما أن الفسطاط اختصت بمصانع (أو مطابخ) السكر والصابون وغيره «لأن القاهرة اختصت بالجند»125. والفسطاط أرخص أسعارًا لقربها من النيل فلا تكون هناك نفقة في نقل البضائع من المراكب126، كما لا توجد بها مشكلة عطش كما هو الحال في القاهرة لبعدها عن النيل127.
إذا عدنا إلى ابن جبير، نجد وصفه للقاهرة شاملًا ومهمًّا وقد سجل لنا ملاحظتين أساسيتين الأولى أن أسارى الروم هم الذين بنوا قلعة صلاح الدين وقد شهد بنفسه بناء القلعة128 والثانية أن حقيقة من بنى الأهرامات لم تكن معروفة آنذاك، قال بعد وصف دقيق لتلك الأهرامات «للناس في أمرها اختلاف: فمنهم من يجعلها قبورًا لعاد وبنيه، ومنهم من يزعم غير ذلك لا يعلم شأنها إلا الله عزّ وجلّ»129. وذكر ابن جبير أيضًا أن السلطان جعل مسجد ابن طولون مأوى للغرباء من المغاربة وأجرى عليهم الأرزاق130. وهذا يشير إلى ان المغاربة لم يكونوا دائمًا يعاملون بصورة سيئة كما أشارت مصادر أخرى من قبل.
لا شك أن المنجد أحسن صنعًا عندما ختم اقتباساته باقتباس من محمد بيرم الخامس التونسي الذي زار مصر في العصر الحديث، في أواخر القرن التاسع عشر، وتحليل كتابات بيرم يشير إلى تحول نوعي في تطور القاهرة من ناحيتي المنشآت والسلوك الاجتماعي، أهمية مظاهره تغلغل مظاهر الحضارة الغربية والتأثر بالعمران الأوربي. غير ان بيرم ذكر بعض مظاهر الاستمرار التاريخي في القاهرة، التي أشار إليها الرحّالة السابقون مثل بؤس المساكن «لكن ديار الأهالي ليس منظرها من الخارج مما يسر النظر»131، وميل المصريين للسباب العنف وحب الطرب وعدم الاهتمام بنظافة الملابس والمساكن «إلا بعض الأعيان ومن نحا النحو الفرنجي»132. وكذلك مظاهر التحرر الاجتماعي «وعلى الإجمال فأهل مصر لهم الحرية الشخصية فيما يرجع إلى الديانات وشعائرها، حتى صارت المنكرات جهرًا، ولا يقدر الأب على منع ابنته من مثل ذلك بالحكم إذا بلغت سنًّا معلومًا»133، وقد سجل بيرم، كما لاحظ قبله الرحّالة المغاربة والأندلسيين في العصور الوسطى، قهر السلطان وقوة حضوره في القاهرة حتى أن «القدح في تصرفات الحكومة فهو ممنوع». ومن ذلك الشدة في الجباية وأخذ الأموال، مما أوضحه ببلاغة رائعة ابن سعيد، من قبل، حين قال عن القاهرة/ الفسطاط «وهي مستحسنة للفقير الذي لا يخاف طلب زكاة ولا ترسيمًا ولا عذابًا، ولا يطالب برفيق له إذا مات، فيقال له: ترك عندك مالًا، فربما سجن في شأنه أو ضرب أو عصر»134. ويصف محمد بيرم في نهاية القرن التاسع عشر معاملة رجال الجمارك في الإسكندرية للمسافرين «فنظروا إلى رحالنا وأرادوا التشديد في تفتيشها وقلب عاليها على سافلها متطلبين الإحسان إليهم، فلم يسعني إلا التخلص من الظلم بدفع شيء من المال ارتكابًا لأخف الضررين من الخوف من تشتيت رحلي والسرقة منه مع التعب»135. ويمكن أن ننظر إلى شكوى مماثلة من ابن جبير في القرن السادس الهجري136، عندما وصل في رحلته إلى الإسكندرية: «ضمن أول ما شاهدناه فيها (الإسكندرية)يوم نزولنا أن طلع أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها، لتقييد جميع ما جلب فيه، فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدًا واحدًا، وكتب أسماؤهم وصفاتهم وأسماء بلادهم، وسئل كل واحد عما لديه من سلع... ... لتؤدي زكاة ذلك كله.. فاستدعوا واحدًا واحدًا، وأحضر ما لكل واحد من الأسباب، ما دق منها وما جل، واختلط بعضها ببعض، وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم بحثًا عما عسى أن يكون فيها.. ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزي عظيم».
وصف محمد بيرم الخامس بعضًا من معالم القاهرة الحديثة، مثل حديقة الأزبكية، ذاكرًا انها من محاسن القاهرة «وهي ذات مماشي ورياض وأشجار وأنوار ومقاعد وقهاوي، تنتابها الموسيقى الرسمية كل يوم عشية، لكنها لا يحضرها غالبًا إلا الإفرنج»137. ووصف كذلك قصور أسرة محمد علي «وقصور الخديوي وأقاربه الرسمية وحواشيه مالئة الحارات الجديدة، ومبهجة لها برونقها. وأهمها قصر عابدين. أما القصور التي حول القاهرة فهي كثيرة، مضاهية أو فائقة على قصور ملوك أوربا. وجمعت ما للأوربيين من التحسين وما للشرقيين من التزويق والإسراف، لكل منها حدائق وعيون وحيوانات غريبة.. وهي منتدى أهل التمشي والتنزه بعجلاتهم وخيلهم لما له من البهجة بالأشجار العظيمة، ومن ورائها البساتين والقصور المؤنقة لأهل الترف والبذخة من الأوربيين والأمراء والوزراء، وعلى جانبه ترعة النيل، وهكذا حارات الإفرنج والحارات الجديدة في تأنق البناء والقصور وبهرجتها من الظاهر فضلًا عن الداخل»138.
وهكذا تمكن المنجد عن طريق الاقتباس المنظم المتسلسل القائم على الانتقاء الدقيق من رسم صورة واضحة لتطور القاهرة عبر العصور الإسلامية، دون أن يفارق تخصصه وعمله الأساسي في دراسة المخطوطات الإسلامية التراثية.
* * *
كان نصيب بغداد من دراسة المنجد حول المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين ضئيلًا لا يتعدى ثمان صفحات، وعلل المنجد ذلك بقوله«ما وصل إلينا عن بغداد من المغاربة والأندلسيين قليل، وأنه يتصف بوصف المدينة نفسها وأخلاق أهلها وعلمائها، على أنه لا يشفي غلة»139. استدرك المنجد قائلًا أنه عندما كتب الجزء الحاص عن بغداد لم يكن بين يديه رحلة بنيامين، لذلك لم يستشهد بما قال ونبّه إلى أهمية النص والرجوع إليه.
اعتمد المنجد على كتابات أربعة من الرحّالة، سبق أن استخدم مادتهم عن القاهرة ودمشق، وهم: ابن جبير الذي زار بغداد سنة 590 في خلافة الناصر لدين الله وضمن مشاهداته في كتابه المنشور باسمه رحلة ابن جبير، وابن سعيد، وابن بطوطة الذي ضمن مشاهداته في كتابه عن رحلته، المسمى تحفة الأنظار. أما ابن سعيد فلم ترد عنه عن بغداد سوى سطور قليلة، ذكر فيها أن مباني بغداد من القصب والطوب والكلس والجبس140 وأن الهواء فيها يفسد المباني ويتشقق الرخام من الحر. ثم تحدث عن الواردات إلى أسواق بغداد بقوله «أرخص ما فيها التمر، الذي يجلب من البصرة والأرز وقصب السكر، ويجلبان من البطائح وجهات واسط، وأن فيها التفاح القراطيسي، والعنب الزرافي والليمون اليعقوبي، والورق البغدادي والأقلام الواسطية، وأن بضائع الهند تصل إليها في دجلة»141. وهذا النص بالطبع عن القرن السابع الهجري، وهو يدل على بقاء بغداد عامرة رغم التدهور والتراجع في أوضاع ودور العراق آنذاك.
يوضح ابن جبير (القرن السادس الهجري) أن الحرب قد عم الجانب الغربي من دجلة في بغداد، وقد كان في الماضي كثير العمران. ويقرر أن الجانب الشرقي من المدينة حديث العمارة، يضم سبع عشرة محلة ويضم دار الخلافة، ويصف قصورها وبساتينها الجميلة كما يصف منظرًا للخليفة الشاب الناصر لدين الله، وهو يسير بزورقه إلى قصره142. ويذكر أن بالجانب الشرقي من بغداد أحد عشر جامعًا ونقل عبر رواة أن عدد الحمامات به يبلغ ألفين والمدارس ثلاثين، كلها عظيمة ولكن أعظمها المدرسة النظامية. كما يصف مجالس الوعظ التي كان يتحدث فيها كبار الوعاظ، مثل رضي الدين القزويني وابن الجوزي143. وقد أعجب ابن جبير بعلماء بغداد من فقهاء ووعاظ، لكنه لم يعجب ببعض طبائع أهلها، فوصفهم بالغرور والرياء واحتقار الغرباء والغش في البيع.144
زار ابن بطوطة بغداد عام 727، وأورد في وصفه ما ذكره ابن جبير لكنه أوضح أن الجانب الغربي من بغداد رغم تعرضه للخراب فقد كان به بعض العمران، ينقل عنه المنجد عن الجانب الغربي «وهو الآن خراب أكثره.. وقد بقي منه ثلاث عشرة محلة، كل محلة كأنها مدينة بها الحمامان والثلاثة»145. وذكر ابن بطوطة أيضًا أن ببغداد أحد عشر مسجدًا تقام فيها الجمعة. ثمانية بالجانب الشرقي وثلاثة بالجانب الغربي وأن بها جسرين يعبرهما الناس ليلًا ونهارًا146. وقد أورد وصفًا لحمامات بغداد، التي لم ير أكثر منها إتقانًا في أي بلد زاره147، وأوضح كذلك نشاط حلقات العلم في مساجد بغداد والأضرحة والمشاهد الخاصة بأئمة الفقه، مثل أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والصوفية مثل الشبلي والسقطي والحافي والجنيد، وقبور الخلفاء العباسيين في الرصافة. ووصف كثرة الأسواق وازدهارها في بغداد الشرقية- مثل سوق الثلاثاء- وكذلك المدارس، ومن أهمها المدرسة النظامية في وسط سوق الثلاثاء والمستنصرية في آخره148، وأشار ابن بطوطة إلى أن ببغداد زاوية واحدة فقط، وذلك خلافًا للقاهرة التي أسهب في وصف زواياها149، وهذا مهم لأنه من الدلائل على أن القاهرة أصبحت في هذه الفترة المركز الأساسي للحركة الصوفية في المشرق العربي، خاصة وأن ابن بطوطة لم يذكر كثرة وجود الزوايا بدمشق. وذكر في النهاية السلطان الذي كان يحكم بغداد، مما يدل على انعزالها السياسي بعد أن كانت العاصمة المركزية ليس للعراق وحده ولكن للمشرق العربي كله مع مناطق واسعة أخرى. غير أن من المهم أن وصف ابن بطوطة لبغداد في القرن الهجري الثامن يدل على أنها كانت لا تزال تحتفظ بكثير من مظاهر الازدهار والأهمية الاقتصادية والثقافية وأن قلة ما أورده المنجد عنها، بحكم انحصار مصادره في الرحّالة المغاربة والأندلسيين، لم يعكس ذلك.
وهذا الانحصار قد قاد المنجد إلى عدم تناول القرون الأولى من الثاني حتى منتصف السادس الهجري، التي مثلت فترة عظمة بغداد. قال ابن عبد الحق (ت 739) عن بغداد في مراصد الاطلاع (وهو معاصر لابن بطوطة): «... حتى جاء التتر إليها فخرب أكثرها وقتلوا أهلها كلهم فلم يبق منهم غير آحاد كانوا نموذجًا حسنًا وجاءها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلها وهي الآن غير التي كانت وأهلها غير من عهدناهم والحكم لله تعالى»150. وذلك مما لم يوضحه المنجد، لكنه يعرفه تمامًا فقد درس هذه الفترة العباسية الأولى من تاريخ العراق وانعكس ذلك على كتابيه بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي، والظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس. وقد أوضح الكثير عن حياة الطبقات الشعبية البغدادية وكذلك الأحوال الاجتماعية في البلاط العباسي، وقد كان مبدعًا في طرقه لمواضيع جديدة في حقبة خمسينات القرن العشرين، مثل أحوال وأخبار النساء والسجون والملاهي والاحتفالات151.
خاتمة
أوضحت الدراسة أن صلاح الدين المنجد قد درس المجتمعات الإسلامية وإنتاجها الثقافي، متقيدًا بالمنهج الذي تخصص فيه، وهو تحقيق ودراسة مخطوطات التراث الإسلامي. غير ان خبرته في هذا المجال قد فاضت وقادته إلى تسجيل ملاحظاته في شكل مقالات موجزة، اتسمت بدقة الملاحظة، عن مظاهر حضارية واجتماعية مختلفة تتعلق بسيرة حياة كبار المؤلفين، والمدن الإسلامية، ومظاهر الحياة الشعبية، وحياة القصور. وكان المنجد في هذا المجال مؤرخًا من طراز خاص، له رؤيته وفكره الخاص، إضافة إلى منهجه المتميز. وقد وازن بين دقة المحقق ومرونة المفكر، ومن ذلك بعض أثر من منهج العلماء الذين ركّز على دراستهم، والذين وازنوا إلى حدٍّ كبير بين النقل والعقل، مع اختلاف المقام والمجال بين المنجد وبينهم.
لقد كان المنجد شديد الإعجاب بمن ترجم لهم، وبمدينة دمشق بصفة خاصة، وكان منصفًا لغيرها من المدن. وهذا الإعجاب يمثل جزءًا من إعجابه بحضارته الإسلامية. ومع ذلك فغن هذا الإعجاب الذي وصل حد الانبهار، لم ينتقص بأي درجة من موضوعيته، وهو قوي التحكم في الموازنة بين هذه الموضوعية ومقتضيات المنهج العلمي وبين منهجه في انتقاء الروايات بدقة وسوقها نحو ما يريد بناءه من نتائج.
إن كتابات المنجد عظيمة القيمة، ليس على صعيد الشكل والمنهج، وإنما كذلك على صعيد المضمون والمادة المعرفية الغنية- من معلومات وأفكار- التي مثلت وجودًا مستقلًا وموازيًا لعمله في التحقيق والمقارنة والترجيح. وهي مفيدة بالنسبة للعاملين في مجال التاريخ كما هي مفيدة للعاملين في مجال منهجية الكتابة التاريخية وكذلك في مجال نقد المصادر، خاصة أنه يتعامل مع المخطوطات قبل طباعتها، وليس مع المطبوع منها فقط. من ناحية أخرى فإن مادة صلاح الدين المنجد المتوفرة الآن تصلح للاستخدام في مزيد من الدراسات المتقدمة، خاصة في مجال التاريخ الحضري الإسلامي.
وذلك لأن انصرافه نحو تتبع المخطوطات والكتب فرض عليه اتجاهًا كاد يجعل من المصادر، وليس الموضوعات ذات الطابع المفهومي المعقد، موضوعه الرئيسي، بالرغم من إشاراته المتفرقة لمثل هذه الموضوعات. وما تركه من إشارات في ثنايا كتاباته يصلح للتطوير لتكون دراسات مطولة ومتعمقة في مجالات تخصصية، يمكن أن تعتمد على المزيد من التحليل الداخلي والخارجي للنصوص التي اقتبسها من المخطوطات بمنهج معين وأوردها منسقة على نحو خاص.
المراجع
- إبراهيم مدكور «الحياة الثقافية بين القاهرة وبغداد»، مقال بمجلد أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة، القاهرة، 1970.
- ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد، تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، القاهرة، 1964.
- ابن جبير، أبو الحسين محمد، رحلة ابن جبير، تحقيق د. حسين نصار، القاهرة، بدون تاريخ.
- ابن خلكان، أبو العباس أحمد، وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1948.
- ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي البجاوي، القاهرة، 1954.
- ابن عساكر، علي بن الحسين، تهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر بن أحمد الحنبلي، بدون مكان أو تاريخ للطبع.
- أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، دمشق، 1939.
- البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان، تحقيق عبد الله أنيس وعمر أنيس، بيروت، 1957.
- التطيلي، بنيامين، رحلة بنيامين التطيلي، ترجمة عزرا حداد، بغداد، 1945.
- حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، إسطنبول، 1944.
- الحموي، ياقوت الرومي، معجم البلدان، بيروت، 1957.
- معجم الأدباء، القاهرة، بدون تاريخ.
- الذهبي، القاهرة، بدون تاريخ.
- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، دمشق، 1953.
- صلاح الدين المنجد، أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب، بيروت، 1959.
- بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي، بيروت، 1957.
- الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس، بيروت، بدون تاريخ.
- المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى، بيروت، 1963.
- قواعد تحقيق المخطوطات، ط3، دار الكتاب الجديد، القاهرة، بدون تاريخ.
- محمد قاسم حمادي المشهداني، موارد البلاذري، ج1، ج2، بغداد، بدون تاريخ.
- مصطفى جواد وأحمد سوسة، دليل خارطة بغداد المفصل، بغداد، 1958.
- المقري، احمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، القاهرة، 1936.
- المقريري، تقي الدين أحمد، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة، 1325/ 1907.
- مجلة المورد، عدد خاص عن بغداد، عدد 4، مجلد 8، 1979، بغداد.
- النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، تحقيق جعفر الحسني، المجمع العلمي العربي، بدون تاريخ.
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: مقالات ودراسات مهداة إلى الدكتور صلاح الدين المنجد،2002، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن. ص 59-110. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني |