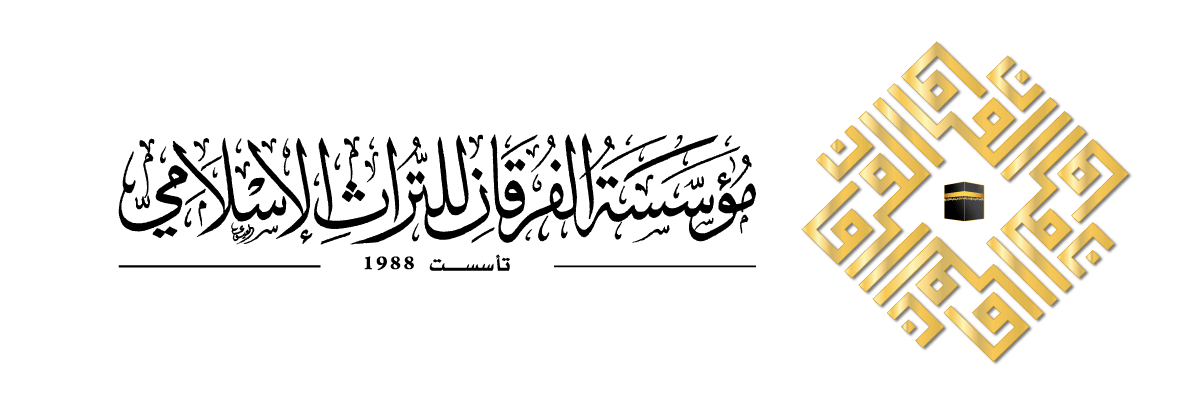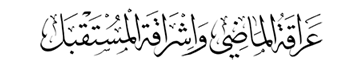محمد عدنان البخيت
اتّسمت مدينة دمشق الشام – شأنها في ذلك شأن بقية الحواضر العربية الإسلامية الكبرى – بظاهرة التعدّد السكاني والتنوّع الثقافي، إذ وفد إليها أناس من مختلف أنحاء العالم الإسلامي فاستطاعت أن تتحوّل بالجميع إلى لسان عربي وإلى الإنتماء إلى الإسلام، ولكنها لم تحاول أن تُجبر فئة أو أكثر على التخلّي عن لسانها وعاداتها مادامت منسجمة مع العرف العام السائد، وتسامحت دمشق مع بقية الجماعات من المسيحيين على مختلف كنائسهم ومثل ذلك مع اليهود، واستقبلت باستمرار المهاجرين واللاجئين وآوتهم جميعًا وأصبحوا من خلَّص أبنائها، ومن هنا عرفت دمشق الشام إحدى جنّات الدنيا الأربع وما يُحيط بها من قرى في الغوطة والمرج تشكيلاً سكانيًا متنوعًا أيضًا وتآلف الجميع بالانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية، وأصبحت دمشق الواحة المحروسة شمالاً بجبل قاسيون الذي يحميها من غضب الطبيعة ومن غوائل الزمن ومن على قمته يشرف الإنسان منها على دنيا الشام فيرى الماء ينساب في أنهارها، والتي بفضلها أصبحت دمشق الشام وجوارها «دار قرار ومعين» وقد عمرتها المساجد والمدارس والتكايا والبيمارستانات والكنائس والكنس وجرت إليها جميعًا المياه. ومن هذا التقليد التاريخي المتراكم اعتادت مدينة دمشق احتضان السكان الجدد فيما بعد من العرب والأتراك والتركمان والأكراد والشراكسة والششن والبشناق والأرناؤوط والطاغستان والفرس والمصريين والجزائريين والمغاربة والأفغان والهنود والأرمن والروم، بالإضافة إلى استمرار تدفق العرب عليها وعلى محيطها من الجزيرة العربية ومن البادية الشامية منذ أن أدار شؤونها معاوية بن أبي سفيان (تولى ربيع الأول 41هـ/ تموز/ آب 661م، وتوفي 60هـ/ نيسان/ أبريل 680م) واختارها لتكون عاصمة لدار الإسلام. ولاحظ المؤرخون والرحالة هذه الظاهرة، مثل الرحالة العثماني كاتب أوليا جلبي (ت 1095هـ/ 1683م) الذي زار دمشق وترك لنا وصفًا ماتعًا عنها. وبالرغم من أنّ شمس عزّ الشرق قد بدأت بالغروب بعد نقل مركز الخلافة منها إلى بغداد إلا أنّ أنوارها عادت وأشرقت من جديد، بعدما اتخذها تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان (471 - 488هـ/ 1078 - 1095م) عاصمة لفرع الأسرة السلجوقية في بلاد الشام ونقش حضوره فيها بتشييد مسجد يحمل اسمه فيها مرسيا بذلك تقليدًا استمر لعدة قرون لمن جاء من بعده من الحكام في دمشق في بناء العمائر الخيرية فيها. واتجهت إليها أنظار العشائر التركمانية والتركية من الغُزّ وغيرهم في أعقاب الانتصار الحاسم الذي أحرزه السلطان السلجوقي ألب أرسلان على الإمبراطور البيزنطي (Romanus Diogenes) في معركة ملازكرد في سنة 463هـ/ 1071م. وخاصة بعد أن أجهز سليمان بن قتلمش السلجوقي صاحب الروم يوم الجمعة 15 صفر 478هـ/ 12 حزيران 1085 م على أقوى وجه عربي حاكم من إمارة العقيليين أبي المكارم شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي أمير حلب والموصل وديار ربيعة وبلاد ري الفرات وسليل الإمارة العربية في شمالي بلاد الشام والعراق؛ وعلى إثر ذلك انحسر النفوذ العربي مفضيًا بالبلاد للأتراك حيث تدفقت عشائر الترك والغُزّ وغيرهما على بلاد الأناضول ومنها إلى بلاد الشام. ولاحظ المؤرخون الذين سجّلوا لنا أسماء سلاطين دمشق وأمرائها منذ تلك المرحلة أن غالبيتهم العظمى كانت من الأتراك والأكراد مما فسح المجال واسعا لمثل هذا النزوح إلى دمشق في عهد الأسرة البورية (497هـ/ 1104م - 549هـ/ 1154م) والأسرة النورية الزنكية تركية الأصل، ومن ثمّ في عهد الأسرة الايوبية الكردية التي نهضت بمشروع الجهاد الذي بدأه الزنكيّون ضد الفرنجة الذين هدّدوا دمشق أكثر من مرة، فجاء الحشد والتجمع والمرابطة في دمشق الشام وبلادها للدفاع عنها وعن بقية بلاد الشام. وكان من نتاج ذلك أن عناصر جديدة من المحتشدين أخذت تستقر في دمشق الشام التي قصدها أيضًا المهاجرون من نابلس وما جاورها من القرى الذين أووا إلى إحدى ضواحي مدينة دمشق التي عُرفت فيها بعد باسم الصالحية، بقعة صالحين التي أفرد لها مؤرخ دمشق شمس الدين محمد بن طولون (ت: 953هـ/ 1546م) كتابًا سمّاه «القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية»؛ وإضافة إلى هؤلاء المهاجرين أَمَّها العلماء والأدباء وكُتّاب الإنشاء والدواوين للعمل في معيّة سلاطينها الأيوبيين ومن تلاهم من نواب السلطنة المملوكية الذين قرنوا مع الجهاد ضد الفرنجة وضد المغول المبادرة بإقامة العمائر الكبرى من مساجد ومدارس وتكايا ومستشفيات، مما استدعى استقطاب أعداد كبيرة من المهندسين والصُنّاع والبنّائين وأهل صنعة العمار فاستقر بعضهم في المدينة، مضيفين بذلك إلى سكانها عناصر إضافية من أصحاب الحرف والمهن.
وعرفت بلاد الشام درجة متقدمة من نظام الوقف الإسلامي الواسع، فكانت المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس وبيمارستانات وخوانق التي قام على خدمتها عدد كبير من الفقهاء وأهل التفسير وحفاظ الحديث وأقطاب الطرق الصوفية، يؤازرهم جهاز إداري وخدمتي لكل مؤسسة كما توضح لنا ذلك سجلات الدولة العثمانية، وامتدّت الخدمات لتشمل بشكل خاص قافلة الحج الشامي الشريف مع ما يقتضيه ذلك من تعمير المنازل والبرك والقلاع وشحنها بالجنود وحماية القافلة في الذهاب والإياب خوفًا من اعتداءات البدو بالدرجة الأولى عن طريق القوة العسكرية التي كانت ترافق القافلة في الذهاب أو تستقبلها عند الإياب، بالإضافة إلى «الصرة» المالية السنوية التي تدفعها الدولة لشيوخ العشائر لكسب ولائهم ولتأمين سلامة القافلة. وكانت قافلة الحج الشريف مناسبة دينية واجتماعية وتجارية لمدينة دمشق التي كانت محطة تجمُّع للحجاج المسلمين في بلاد الشام وبلاد الأناضول، وفيما بعد من بلاد الروملي وبلاد العراق وفارس، عندما كانت تُحوَّل قافلة العراق إلى الشام لأسباب أمنية، مما أدى إلى اتّساع المدينة وظهور أحياء جديدة مع مطلع القرن الثامن عشر كحي الميدان في جنوبي مدينة دمشق الذي سكن فيه التركمان والحلبيون والحوارنة والتيامنة والحماصنة من الوافدين على دمشق. وكان في حي الميدان الأكراد أيضًا ولهم مسجدهم، بالإضافة إلى زقاق المسيحيين وزقاق للنَوَر والزط. ونلاحظ من خلال كتب التراجم التي تناولت علماء المدينة وتاريخها مثل ما خطّه لنا حمزة بن راشد التميمي المشهور بابن القلانسي (ت: 555هـ/ 1160م)، وما جاء في الموسوعة الكبرى لـ «تاريخ دمشق الشام» لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشافعي (ت: 571هـ/ 1176م)، وما تلا ذلك من سلاسل كتب التراجم التي استمرّت إلى يومنا هذا، أنّ أدبيات مدرسة التراجم هذه تناولت أخبار مدينة دمشق وأخبار من حلّ بها أو وردها من العلماء والطلاب والرحالة الذين وفدوا إليها واستقروا فيها، ومن علَّم وتعلَّم فيها تحت قبة النسر بجامع بني أمية، أو توزّعوا في مساجدها التي عدّدها لنا المؤرخ الدمشقي يوسف بن عبد الهادي (ت: 909هـ/ 1503م) فزادت على ثمانمائة غالبها عامرٌ، تطلّ عليها جميعًا قبة النسر من أعالي جامع بني أمية، وتحرسها من الشرق قلعة المدينة بطارمتها الرابضة فوقها كالأسد. ومن أجل تصوّرٍ أكمل لهذا المشهد الحضاري الكبير علينا استذكار عدد مدارس القرآن الكريم ودرر الحديث النبوي الشريف والفقه على المذاهب الأربعة كما فصّلها لنا عبد القادر بن محمد النعيمي (ت: 927هـ/ 1521م) مؤرخ دمشق ومحدّثها في كتابه الذي وصلنا مختصرًا تحت عنوان «الدارس في تاريخ المدارس»، ولا شك في أنّ عدد المدارس والمساجد والتكايا قد ارتفع في العهد العثماني الذي امتد نحو أربعة قرون، وخصصت الدولة العثمانية التي أدخلت نظام التيمار العسكري إلى بلاد الشام في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي قرى ومزارع وبساتين وقطع أراضٍ ومسقفات وعقارات ومرافق خدمات عامة كالمعاصر والحمامات وغيرها من بلاد الشام لأفراد القوة العسكرية العثمانية من الأتراك والتركمان والانكشارية. وفي بعض الأحيان لبعض شيوخ العشائر العربية والكردية وبقايا أجناد الحلقة المملوكية التي أُدرجت ضمن نظام «التيمارات»؛ وكان قسم من هذه القوات العثمانية قد رابَط في القلاع الموزعة في بلاد الشام على امتداد الساحل وعلى أعالي الجبال وعلى محاذاة البادية، وبخاصة على امتداد طريق الحج الشريف بدءًا من قلعة حلب شمالاً مرورًا بقلعة دمشق التي كانت تأوي سنة 933هـ/ 1527م (612) نفرًا من الانكشارية، وانتهاءً بقلعة أجياد بمكة المكرمة جنوبًا؛ ورافق ذلك نقل قسم من العشائر التركية مثل الدوكرية (DÖğer) والتركمان للسكن في المناطق الموازية لطريق قافلة الحج أو في مناطق بحاجة لأيدٍ عاملة زراعية مثل مرج بني عامر. وتشير دفاتر الطابو عند استعراضها لمقاطعات ولاية الشام ما بين سنة 969هـ/ 1562م - 974هـ/ 1567م، إلى عوائد أغنام التركمان والأكراد في ولاية الشام فجاءت بمقدار (398486) آقجة سنويًا، مما يدلّ على دوره في تربية الأغنام. والملحوظ أن دفتر طابو (476) قد جاء على محصول، أي دخل، السباهية التركمان وعددهم (33) نفرًا بمقدار (117000) آقجة سنويًا.
وتزودنا سجلات الدولة العثمانية والمعروفة بـ «الطابو»، ودفاتر المهمة والمالية المدورة، ومثل ذلك سجلات المحاكم بدمشق الشام، بأسماء الأفراد الذين أوكلت لهم مهام عسكرية أو أمنية أو إدارية من عساكر الدولة في بلاد الشام، وتزيد سجلات المحاكم الشرعية على ذلك فتذكر لنا أسماء الجنود الذين استقروا في بلاد الشام وتعاطوا مختلف المهن وشكّلوا، فيما بعد، جماعات ضغط خاصة بهم أصبحت تزاحم في دمشق القيادات التقليدية من الأعيان والعلماء وشيوخ العشائر وكبار التجار والمُلاّك، حتى أصبح هؤلاء– في مراحل معيّنة – مصدر تحدٍّ لسلطة الدولة العثمانية أو من يمثّلها، وعُرف هؤلاء أحيانًا باسم «اليرلية» أي العناصر العسكرية المستوطنة مثل عائلة المهايني بحي الميدان في القرن الثامن عشر، إلى أن حلّ محلها في زعامة حي الميدان في مطلع القرن التاسع عشر محمد آغا عقيل وولده طالب (ت: 1816م)، أو «القابي قول» – أي عبيد الأعتاب السلطانية – وكثيرًا ما كانت تقع المناوشات بين تلك الفئات والجماعات.
وعندما تراخى جهاز الإدارة العثمانية المترهِّل في الحواضر، ومنها دمشق، لاحظ الباحثون ظهور بعض القوى المحلية التي ملأت الفراغ، واستقطبت هذه القوى العناصر العسكرية المتقاعدة أو الهاربة من الخدمة لتبني من خلالها قوّاتها الخاصة بها. ونلاحظ هنا دخول عناصر من البوسنة والهرسك وألبانيا وبلاد الأرناؤوط إلى المشهد الشامي، بالإضافة إلى المغاربة، أما العبيد الأفارقة فكانوا في الغالب يخدمون في البيوت.
واحتفت بلاد الشام بكاملها عام 1271هـ/ 1855م بالأمير الكبير السيد عبد القادر بن محيي الدين الجزائري (ت: 19 رجب 1300هـ/ 26 - 5 ـ 1883م)، عندما اختار دمشق الشام للإقامة فيها مفضلاً إياها على بورسة، بعد أن أفرج عنه الملك نابليون الثالث (1852 - 1870م) وأطلق سراحه من معتقله في مدينة أمبواز (amboise) بمنطقة وادي اللوار (LOIRE) بوسط فرنسا. والذي يعنينا هنا أن عددًا كبيرًا من المهاجرين الجزائريين، بعد تعثّر حركة الجهاد ضد الفرنسيين، سبقوه أو لحقوا به للهجرة إلى بلاد الشام وأصبح لهم، ومن تبعهم فيما بعد، دورٌ كبيرٌ في التاريخ الاجتماعي والسياسي لبلاد الشام، حتى أن أحدهم، وهو الأمير سعيد الجزائري كان أول من رأس وزارة في تاريخ سورية الحديثة في 27/ 9/ 1918م، وقد عمّرت لبضعة أيام. وإلى هذه الأسرة العريقة أصهر يوسف إيبش فيما بعد. وانتشر المهاجرون الجزائريون في حواضر بلاد الشام من حلب وحماة وحمس ودمشق وعكا وغيرها، وأصبحوا يُشكلون حضورًا بشريًا متجدَّداً، فأصبحت لهم أحياؤهم الخاصة بهم، وصارت عناصر الجالية الجزائرية مطلوبة لمزاياها العسكرية وخصائصها في تحمُّل المشاق لتوكل إليها المهام الإدارية العسكرية.
وعرفت دمشق خلال هذه المسيرة من تاريخها الطويل العديد من الأسر الكردية التي تحمل اسم (الأيوبي) وأسرة آل بوظو وأسرة (كرد علي) التي هاجرت إليها من السليمانية وأسرة بدرخان؛ وإذا ما نظرنا في مجموع التراجم التي يوردها الشيخ عبد الرزاق البيطار (ت: 1335هـ/ 1916م)، «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر»، نجد العديد من أسماء الشخصيات العلمية الكردية التي كانت قد برزت في مدارس دمشق ومساجدها وانتسبت إلى الطريقة النقشبندية التي انتشرت مابين الأكراد، خاصة بعد ما انتقل إليها من السليمانية واستقر بها سنة 1236هـ/ 1821م مُجدِّد القرن الثالث عشر ضياء الدين خالد (بن أحمد) النقشبندي دفين مقبرة الأكراد بدمشق (ت: 1242هـ/ 1826 - 1827م)، وله مسجد يحمل اسمه فأصبحت دمشق بفضله من أهم مراكز الطريقة النقشبندية، وكان تلاميذه يحملون لقب «النقشبندي الخالدي». ولكن الذي يهمنا هنا أسر ثلاث، هي: أسرة آل شمدن [تُذكر أحيانًا «شمس الدين»] والأسرة اليوسفية وأسرة آل الإيبش، وارتبطت هذه الأسر الثلاث بالمصاهرة مع بعضها البعض وتكاملت في أداء المسؤوليات الإدارية التي أُنيطت بها على مستوى ولاية سورية، وبخاصة وظيفة محافظة دمشق الشام؛ كما تولت إمارة الحج الشريف مرافقةً واستقبالاً. واستمدّت هذه الأسر الثلاث قوّتها أيضًا من علاقتها الطيبة مع مسؤولي السلطنة العثمانية ورجالها، وكذلك تواصلها الودي مع الزعامات المحلية في ريف دمشق، ومع الأسرة الشهابية في جبل لبنان، بحيث اشترت أسرة آل اليوسف أرضًا لها في بلدة عنجر بالبقاع، كما أنّها تعاطت التجارة وسعت إلى تملُّك العقارات والقرى والأراضي وابتنت القصور الكبيرة في دمشق فشغلت منزلة متميزة في مجتمع المدينة، بل ربما في كل بلاد الشام، بعد أن أغدقت الدولة العثمانية الألقاب والرتب على زعماء هذه الأسر. وعندما انهارت الدولة العثمانية ودخلت جيوش الحلفاء من الإنجليز والفرنسيين وجيش الأمير فيصل بن الحسين إلى بلاد سورية لم تتضعضع منزلة هذه الأسر، إذ استطاعت الاحتفاظ بموقعها الاجتماعي والمالي وفي زمن هذا التحول الكبير أخذت مبكرةً بأسباب الحياة المدنية الحديثة وتحولاتها فأرسلت أبناءها إلى المدارس الرسمية والأجنبية ومن ثم إلى الجامعات، وتواءمت مع مرحلة الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان.
كنا قد أشرنا أعلاه إلى أسرة بني شمدين، من سكان حي الأكراد بدمشق، والتي تشير المصادر المتوافرة لدينا إلى أن كبيرها كان قد توفي خلال حوادث الستين بدمشق، وأن أحد أبنائه الستة، محمد سعيد باشا شمدين، كان قد تولى إمارة الحج الشريف وشغل منزلة رفيعة في مجتمع دمشق الشام، وكان قبل وفاته سنة 1319هـ/ 1901م، قد أنشأ مسجدًا بحي الأكراد في 1309هـ/ 1891 - 1892م. ومن المفيد هنا أن نذكر أن محمد سعيد باشا هذا قد توفي دون ولدٍ ذكر يخلفه، وأن ابنته كانت قد تزوّجت من محمد بن أحمد اليوسف، من العائلة الكردية الرئيسة الثانية بدمشق والتي تنحدر أساسًا من عشائر الزرقليّة الكردية المشهورة في بلاد ديار بكر، وكان محمد هذا قد تولّى عددًا من المناصب الإدارية في مناطق: البلقاء وحوران وطرابلس الشام وحماة، وتولى – كوالده الذي كان يحمل لقب مير ميران – مأمورية جردة الحج الشامي، وتنقل في مختلف المواقع الإدارية إلى أن توفي سنة 1314هـ/ 1896 - 1897م ليخلفه في هذا الموقع من المسؤولية ابنه عبد الرحمان باشا اليوسف سبط محمد سعيد باشا شمدين، فآلت إليه ثروة جدّه هذا من جهة والدته، وأقبلت عليه الدنيا وتولى إمارة الحج ومحافظة مدينة دمشق. وفي مطلع عهد الانتداب شغل رئاسة مجلس الشورى في حكومة علاء الدين الدروبي التي شكّلها في 25/ 7/ 1920م، إلا أنهما لقيا معا حتفيهما على يد الثوّار في خربة الغزالة، وما جاورها من القرى في هضبة حوران التابعة لدرعا في 5 ذي الحجة 1338هـ/ 20 - 8 - 1920م، عندما هاجم الثوار القطار الذي كان يقلّهما مع عطا بك الأيوبي الذي شكّل الحكومة مرتين فيما بعد في دمشق عامي 1936م و1943م والذي نجا من الموت، وبطشوا بهما وبعدد من الركاب، وبذلك فشلت مهمتهما في التوافق والتوفيق مع الثوار من بقايا الموالين للحكم العربي الفيصلي في بلاد الشام.
ونلاحظ من خلال قراءة البيانات العسكرية الاستخباراتية التي كان يصدرها الفرنسيون برئاسة المندوب السامي الفرنسي الجنرال (Goybet) والتي أوردتها جريدة العاصمة السورية، أن الحركة كانت منتشرة في حوران، وأن أفرادها كانوا مسلحين بالرشاشات والمدافع، واضطرت الدولة الفرنسية إلى تحريك سرية عسكرية إلى حوران، وأن تستخدم أيضا الطائرات في قصف القرى ومطاردة تجمعات البدو، واستمرت المناوشات بين الطرفين إلى أن شكِّلت الحكومة بدمشق، بتوجيه من المندوب السامي الفرنسي، لجنتين لمعالجة موضوع المنهوبات وبيان الديات لأسر الضحايا ودفعها لهم، ولتحديد الأضرار التي لحقت بسكة الحديد بعد نزع قضبانها، كل ذلك بقصد إغلاق الملف، خاصة بعد أن بدأ الزعماء المحليون في قرى حوران بالاستسلام.
ولقد بلغت هذه الأسرة شأوًا بعيدًا في تاريخ دمشق، فإن قُدِّر لأسرة آل العظم في القرن الثامن عشر أن يدوِّن أخبارها أحمد البديري الحلاق (ت: حوالي 1175هـ/ 1761م) تحت عنوان «حوادث دمشق اليومية (1154 - 1175هـ/ 1741 - 1761م» فإن آل اليوسف قد حظوا بالشيخ الفقيه عبد القادر بن أحمد بدران (ت: 1346هـ/ 1927م)، مُدرِّس أبنائهم وأنجالهم، حيث أرّخ لهم مُعرِّفًا بأصولهم ومواقعهم التي شغلوها، في كتاب سمّاه «الكواكب الدُريّة»وصف فيه تراجم مشاهير رجال الأسرة.
والمعروف لدينا أن حسين إيبش، وهو وجيه الأسرة الكردية الثالثة ببلاد الشام، كان قد تزوّج من السيدة وجيهة [وجيها] هانم بنت عبد الرحمان باشا اليوسف، وكانت والدتها من عائلة العظم الحموية – الدمشقية المشهورة. والجدير بالذكر أن ابنها يوسف أهدى لذكراها عام 2000م كتاب «رحلات الإمام محمد رشيد رضا»عندما جمعه وحقّقه. فمن هي أسرة الإيبش - التي كان أبناؤها يُعدون من «أغوات»الأكراد بدمشق، والتي تمتّ أيضًا إلى أسرة بدرخان بصلة المصاهرة والقربى - التي أنجبت لنا أستاذنا المرحوم يوسف حسين إيبش؟
تنتمي هذه الأسرة الكردية أساسًا إلى بلدة ماردين الواقعة اليوم ضمن حدود الجمهورية التركية وبالقرب من الحدود السورية على مقربة من جبل ماردين الذي اشتهر «بجواهر الزجاج»،وكان عدد أهاليها ثلاثة آلاف بيت عندما زارها عام 1766م الرحالة الدانماركي كارستِن نيبور (carsten Niebuhr) (ت: 1815م)، وكانوا خليطًا من مختلف الأعراق، ولاحظ عدد آخر من الرحالة الذين زاروا البلدة فيما بعد أن سكّانها كانوا خليطًا من العرب والأكراد والأرمن والمسيحيين اليعاقبة والشمسية، وهي إحدى الأقليات قديمة المعتقد والتي اعتنقت المسيحية. ويذكر الرحالة أن السيادة اللغوية كانت للعربية والكردية والأرمنية.
ومن مثل هذا المحيط متعدّد التشكيل هاجر فرع من الأسرة إلى دمشق الشام برئاسة حسين الإيبش الذس توفي أثناء أدائه فريضة الحج أيام كان محمد سعيد باشا شمدين أميرًا للحج الشامي، وكان برفقة حسين في مكة المكرمة ولداه بلال وأحمد، فعاد ابنه بلال إلى ماردين حيث لا يزال يوجد هناك فرع من الأسرة. أما ولده الأكبر أحمد فاستقرّ في دمشق وتعاطى تجارة الخيول التي كان يشتريها من ماردين وجوارها من مناطق الجزيرة ويجلبها إلى دمشق الشام، ثم ينقلها إلى مصر حيث كان المسؤولون فيها من أسرة محمد علي يرغبون في إنشاء سلاح للفرسان على غرار سلاح الفرسان الفرنسي. وتُبينُّ الوثائق البريطانية أن الإنجليز بمصر كانوا يشترون منه أيضًا. ولقد خلفه ولداه في زعامة الأسرة، نوري بك الذي درس الزراعة في إنجلترا، ورأس الغرفة الزراعية بدمشق (1930 - 1951م) وشارك في وزارة حسني بك البرازي سنة 1942م وفي وزارة محمد جميل بك الألشي سنة 1943م، وكان مع شقيقه حسين أول من أدخل لعبة كرة القدم إلى دمشق الشام حيث كانا يلعبانها في مرحلة الحشيش. أما شقيقه حسين الذي وُلد في عام 1888م بدمشق فالتحق بالمدارس الرشدية الحكومية فيها، حيث تعلّم العربية والتركية والفرنسية ثم انتقل منها إلى مدارس الآباء اللعازرين، ومن ثم التحق بالكلية السورية البروتستانتية (الجامعة الأمريكية ببيروت، تأسست سنة 1866م) التي تخرج فيها بدرجة البكالوريوس بتخصص التجارة عام 1908م. وبعد تخرجه تولى أعمال العائلة في تجارة الخيول مع مصر، مما أتاح له الفرصة لإقامة صلات مع أرفع الأسر بمصر، وبخاصة مع الأمير يوسف كمال باشا بن أحمد كمال رفعت بن إبراهيم باشا الذي اشتهر بحبه للرحلات وللصيد، فرافقه حسين إيبش في عدد من رحلاته خارج مصر إلى إفريقية وبلاد الهند والتبت وكشمير؛ وبذلك أقام علاقات واسعة مع زعماء القبائل في جنوبي الصحراءالكبرى واتسعت اتصالاته لتصل إلى جنوبي إفريقيا، وكانت تصله الهدايا، ومن بينها الأنعام فأقام لها حديقة في جوار بيت الأسرة الكبير الواقع على مساحة ستة آلاف متر مربع في حارة عبيد بشارع ساروجة. وكان أهالي دمشق يشيرون إلى هذه الضاحية المزدهرة باسم «إسطنبول الصغرى». ومن حسن الحظ، فلقد ثم مؤخرًا في أبو ظبي نشر الجزء الأول من أخبار هذه الرحلات ومنها الرحلة المعنونة باسم «سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير (1913 - 1914م»، ويشير الأمير يوسف كمال في العديد من المواقع إلى حسين أفندي إيبش. وليس هناك ما يدل، على ضوء ما جاء في نصوص رحلة الأمير يوسف سنة 1915م إلى بلاد التيبت الغربية وكشمير، أن حسين إيبش قد شارك في الرحلة الثانية.
واستكمالاً لسيرته، فقد التحق بإحدى المدارس العسكرية بألمانيا وعاد ليخدم في سلاح الإشارة في الجيش العثماني، وقُدِّر له أن يُشارك في معركة غاليبولي (Gallipoli) سنة 1915م، ثم نُقل إلى الجيش الرابع بقيادة جمال باشا الكبير (قُتل على يد الأرمن في تبليس في 21/ 7/ 1922م) ليخدم في منطقة السويس حيث جُرح في إحدى المعارك، ووقع أسير حرب بأيدي القوات البريطانية التي نقلته إلى الداخل في مصر حيث عولج وأُتيح له أن يُجدِّد اتصالاته بأصدقائه بمصر. وعندما انتهت الحرب أُطلق سراحه فسافر إلى إسطنبول، ومن هناك عاد إلى دمشق عبر حلب ورياق ليبدأ حياته الدمشقية الشامية من جديد فتزوج من السيد بهيجة هانم بنت عبد الرحمان باشا اليوسف وحفيدة آل العظم من ناحية الأم. ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى دور السيدة بهيجة في إدخال لمسات نوعية على حياة الأسرة الإيبشية بعد أن استقرت في بيت العائلة الكبير الذي أشرنا إليه أعلاه، فقد كانت على إلمام بعدد من اللغات منها العربية والكردية والتركية والفرنسية، وحتى اليونانية التيتعلّمتها من مربيتها اليونانية صوفيا كيكا، وكانت معروفة بتذوّقها للموسيقى وبخاصة العزف على البيانو. أما مطبخ العائلة الإيبشية الجديد فكان يقف على خدمته الطباخ «نظيف أفندي»من المطبخ السلطاني بإسطنبول، وكان يساعده في خدمة الضيوف ميخائيل المعلوف من زحلة، أما سائق السيارة فكان أرمنيًا.
من كل هذا نلحظ التنوع في البيئة المحيطة مباشرة التي نشأ فيها المرحوم يوسف إيبش وشقيقه التوأم زياد. فلقد وُلد يوسف في سوق الغرب بلبنان عام 1925م، ولكن تسجيله تأخر إلى حين عودة العائلة من هناك إلى دمشق بسبب ظروف الثورة السورية، إلى 29/ 3/ 1926م حيث قُيِّدت حالة الولادة في «النفوس خانة»بدمشق التي تلقّى فيها تعليمه الابتدائي، ومن هناك نقله الأب حسين سنة 1938/ 1939م إلى المدرسة الابتدائية ببيروت، حيث التقى بصديقه، وزميله فيما بعد، كمال الصليبي الذي يُشير إلى تجربة اللقاء الأولى بينهما، مؤكدًا دماثة أخلاق يوسف بقوله: «وهو الذي جعلني أشعر... أن في الشخص ما هو أهم من المظهر»، وتابع يوسف دراسته في مدرسة برمانا، والتقى من جديد مع كمال عند التحاقهما بالقسم الاستعدادي التابع للجامعة الأمريكية ببيروت عام 1943م، وبعد تخرج يوسف من ذلك القسم، التحق بدائرة العلوم السياسية بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية، ليتخرج منها بدرجة البكالوريوس عام 1950م. وتابع دراسته لدرجة الماجستير في العلوم السياسية فبحث في موضوع «الأقليات في سورية»مقتفياً آثار ألبرت حوراني (ت: 1993م) الذي أصدر عام 1947م دراسته بالإنجليزية عن الأقليات في العالم العربي، ليُفتح بذلك الباب على مصراعيه لمزيد من الدراسات التي تطالعنا اليوم عن المجموعات العرقية والدينية والاجتماعية في البلاد العربية، وأشرف على رسالته المُربي المقدسي المعروف أحمد سامح الخالدي (ت: 1370هـ/ 1951م)، والد وليد صديقه وزميله في العمل في المستقبل، حيث أصدرا معًا الوقائع العربية والوثائق العربية عن الجامعة الأمريكية ببيروت. وبعد أن عمل لعدد من السنوات (1953 – 1956م) معيدًا بالجامعة الأمريكية، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتحق بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد وكتب رسالته للدكتوراه في الفكر الإمامي عند القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي (ت: 403هـ/ 1013م) تحت إشراف المستشرق الإنجليزي المشهور السير هاملتون جب (Sir Hamilton Gibb) (ت: 1971م)، وهناك في منطقة كمبردج أسّس جمعية هارفارد الإسلامية للتعريف بالإسلام عقيدةً ورسالةً وتاريخًا وفنًا وإنجازًا. وكان يوسف إيبش قد حمل هذا الطموح وأعطاه من فكره وماله كل ما يستطيع بنيَّة تقديم الإسلام إلى الناس، كل الناس، والأخذ بأيديهم للاطلاع على إنجازات الحضارة الإسلامية، ودعوة هؤلاء لتذوق الفنون الإسلامية من موسيقى وخط وزخرفة وتجليد وعمارة ونميات وسكة وتنظيمات اجتماعية على مستوى الحرف والأصناف والطرق الصوفية، وأصبح بذلك، بِلا غرابة، المرجع فيها بل «مسند»الشام الكبير نظرًا لعلمه الموسوعي، ولإحاطته بعادات وتقاليد المجتمع الشامي بما في ذلك تنظيمات الحرف والأصناف التي أولاها عنايته وكتب حولها وحاضر في موضوعها مستكملاً بذلك جهود إلياس بن عبده المقدسي (ت: 1926م) صاحب «نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية»التي قدّمها لمؤتمر الاستشراق بمدينة ليدن، 1883، ونشرت سنة 1885م، ومتتبعًا أيضًا للعمل الموسوعي الكبير الذي نهض به كل من محمد سعيد القاسمي (ت: 1317هـ/ 1900م) وجمال الدين القاسمي (ت: 1332هـ/ 1914م) وخليل بن مصطفى بن محمد حافظ بن عبد الله باشا العظم (ت: 1352هـ/ 1933م) أصحاب «قاموس الصناعات الشامية»الذي حقّقه ونشره الأستاذ المحامي ظافر القاسمي بدمشق سنة 1988م، بتشجيع من المستشرق الفرنسي المشهور لويس ماسنيون (ت: 1961م) والأستاذ جاك بيرك (Jacques Berque).
لقد عرف الناس يوسف إيبش بشمائله ودماثة أخلاقه وخصائله السخية بالعطاء، يُزين كل ذلك عفّة ورفعة فيسعى القارئ إليه وكذلك السامع لتذوّق مداعباته اللمّاحة ومفاكهاته المرحة وطريقة التعبير عنها التي تُذكِّرنا بطريقة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 255هـ/ 869م) فيما كتب وألّف من قبل.
وكان المرحوم يوسف متنوّع الاهتمام، واسع الاطّلاع بجانب إنتاجه العلمي، فهذا الاهتمام يفسّر لنا تلك المجموعات الثرية التي تركها لنا من قطع العملة، ومجموعة الصور والرسومات لأحياء دمشق وحاراتها ومحالاتها، وكذلك المجموعة المتميزة من الأسطوانات والتسجيلات لعمالقة الموسيقى وأساطين الغناء بدءًا من سيد درويش (ت: 1342هـ/ 1923م) وانتهاءً بكبار الفنانين الذين طاولوا الأهرام بقاماتهم، ولامست أيديهم ذرى قاسيون، والذين غنّوا تحت ظلال الأرز فرحلوا بنا إلى جوزاء الفن والذوق. ولقد وظّف هذه الميزة من الاطلاع والثقافة عندما شارك في الإعداد سنة 1976م لمشروع مهرجان العالم الإسلامي بلندن (The World of Islam Festival) الذي كان ربما أكبر نشاطٍ حضاري إسلامي في الغرب في القرن العشرين، فتم إنتاج ستة أفلام عن حضارة الإسلام والمسلمين، كذلك ساهم في اختيار عدد من الحواضر الإسلامية كصنعاء وفاس وقبة الصخرة الشريفة والمسجد الأقصى بالقدس وغيرها، لتصدر أمانة المهرجان من كل واحدة منها مطبوعات علمية من مستوى رفيع خاصة بها. واتسعت دائرة اهتماماته فكان يقضي جزءًا من وقته في الإبحار بأعالي مدارات الحرف العربي لعلمه أن الفن الإسلامي ماهو إلا هبة الخط العربي وما تفرّع عنه من الخط الفارسي والخط التركي والخط الأوردي، فجاءت مجموعته نادرة في مضمونها وتعدد اهتماماتها، والأمل أن تجد هذه المدونة من ينشرها ويعرّف بها في مجموع خاص بها.
وبعد عودته مباشرة من هارفارد عام 1960م، التحق بدائرة العلوم السياسية بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية ببيروت، مُفضلاً العمل الجامعي على الانخراط في العمل السياسي في بلده سورية التي أصبحت تشكّل الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة؛ ولم تعمّر الوحدة بين الإقليمين طويلاً. وفي رحاب الجامعة، عرف الطلاب عطاءه ونجابته وعرفته الهيئات العلمية في بيروت على تعدد مذاهبها السياسية والفكرية، فأسّس فيها المركز الثقافي الإسلامي ورأس مجلس أمنائه، وشارك في تأسيس عدد من المجامع والجامعات في البلاد العربية والإسلامية، كما أعطى من جهده الوقت الكافي لمسح المخطوطات اليمانية في العالم، وذلك عندما رأس لجنة من اليونسكو - لهذا الخصوص - وامتد مثل هذا السخاء من خلال مشاركته في أعمال مركز دراسات الحج بالمملكة العربية السعودية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية بلبنان، وما تبع ذلك من اجتياح همجي لجيش الدولة العبرية لبيروت، سافر إلى الولايات المتحدة حيث عمل في العديد من جامعاتها مثل الجامعة الأمريكية بواشنطن وجامعة ويسكونسين (Wisconsin) وجامعة أمهرست (Amherst) وجامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة. وخلال هذه المسيرة العلمية الزاخرة والثرية، نشر نحو (24) كتابًا وما لا يقل عن (75) دراسة أكاديمية منشورة في مجلات علمية مفهرسة ومتخصّصة. وعندما شرع الشيخ أحمد زكي يماني، صديق المرحوم، في تأسيس مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن سنة 1991م، كان من أعضاء اللجنة التأسيسية ومن ثم في مجلس خبرائها، إلى أن تمّ اختياره مديرًا عامًا لها في 1/ 10/ 1998م فقادها بكفاية واقتدار، ونشط النشر بها، وأدار عددًا واسعًا من الندوات العلمية فيها، بالإضافة إلى حلقات بحثية حول تحقيق المخطوطات وقواعد نشرها حرص على نشر نتائجها بأسلوب علمي معهود في تقاليده الأكاديمية الدقيقة المعروفة عنه، وعُني بجريدة«المنار»وبمؤسسها الشيخ محمد رشيد رضا (ت: 1935م) مشفوعًا بتلك المحاضرات العامة التي نظمها لجمهور المعنيين بالعالم العربي والإسلامي في مقر المؤسسة. ولم ينس مدينته الأم دمشق وحكوماتها منذ سقوط الدولة العثمانية بدءًا من الوزارة الأولى التي شكّلها الأمير سعيد الجزائري بتاريخ 27/ 9/ 1918م وانتهاءً بالوزارة الخامسة والستين التي شكّلها صبري العسلي بتاريخ 31/ 12/ 1956م واستمرت في الحكم حتى قيام الوحدة بين سورية ومصر بتاريخ 21/ 2/ 1958م. وأضاف لهذا العمل ثلاثة ملاحق شملت الدساتير والخطب والبيانات والأحداث والمراسيم والقرارات.
إنّ اهتماماته بصقل الذوق والعروج في مدارس العرفان دفع به إلى العناية بشيوخ الصوفية وأقطابها، فاهتم بشهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الشافعي المعروف بالسهروردي المقتول (587هـ/ 1191م) واعتنى بآثار الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (ت: 638هـ/ 1240م) دفين دمشق الشام. ولأنّه حمل الإسلام في وجدانه وجوانحه، بذل جهدًا كبيرًا لبعث الاهتمام بجهود المصلح الكبير شكيب بن حمود أرسلان (ت: 1366هـ/ 1946م) فنشر سيرته، كما نشر مذكرات شقيقه الأمير عادل أرسلان (ت: 1373هـ/ 1945م). وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة التي بذلها، فقد أولى تفاسير آيات القرآن الكريم كل اهتمام، فوضع لها كشّافًا صدر في 814 صفحة ببيروت عام 1997م فكان خير معين للباحثين والدارسين. وتوّج عطاءه عام 1998م بأن أهدى مكتبته بمختلف اللغات (1925 عنوانًا) إلى مكتبة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول.
لم يتوقّف المرحوم يوسف عن العطاء وعن المثابرة في تتبع كل جديد في عالم الإسلام والمسلمين أو في العالم ككل، وساعده في ذلك إتقانه لعدد من اللغات، إلى أن التحق بالرفيق الأعلى بالمستشفى في بلندن يوم الأحد 19/ 1/ 2003م ليُوارى جثمانه الطاهر الثرى بمقبرة (Putney Vale) جنوبي مدينة لندن يوم الجمعة بعد أن صلّى عليه زملاؤه وتلاميذه وأصدقاؤه ومحبوه الكثر من عامة الناس وودّعوه الوداع الأخير، تاركًا وراءه الذكرى الطيبة التي سيحملها عنه كل من: ابنته سونا ووالدتها رمزية الجزائري (ت: 1997م)، وابناه حسين الذي يدافع اليوم عن المسلمين وعن المضطهدين بأمريكا، وابنه الثاني كريم وحفيده باسل إيبش. وبعد كل هذه الرحلة الطويلة للمرحوم يوسف من دمشق إلى أصقاع الدنيا، وبغضّ النظر عن مكان الولادة ومسقط الرأس في لبنان، تبقى الحضارة العربية الإسلامية بموروثها الحضاري في بلادنا، بعد سقوط دولة الأمة والخلافة، هي الوطن، وبلاد الله الواسعة هي عنوان الإقامة.
يذكر صديقه كمال الصليبي أنّه في سنة 1966 - 1967م كان يوسف أستاذًا زائرًا بكلية دارتموث (Dartmouth College) التي أسّست سنة 1769م بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أعقاب هزيمة حزيران قررا العودة معًا مرورًا بأوربا فزارا قصر الحمراء وجنة العريف وجناح الأسود في غرناطة، وكانا يتذاكران أحوال الأمة العربية وتقلّب الزمان عليها، شغلهما حديث الهموم هذا عن شعر لسان الدين بن الخطيب (ت: 776هـ/ 1375م) ومحمد بن يوسف بن زمرك الصريحي (ت: ح 794هـ/ 1391م)، ورئيس الكتاب أستاذ لسان الدين الخطيب، علي بن محمد بن الجيات (ت: 749هـ/ 1348م) الذين وشموا جدران القصر وملحقاته بشعرهم فلم يستوقفهما شعر الصنعة و«زخرف القول» عند هؤلاء الشعراء وغيرهم في مدح السلطان في زمن الاحتضار السياسي للوجود العربي الإسلامي في غرناطة، بل استقر بصرهماعلى الحكمة الخالدة من علامة أمير المسلمين، الغالب بالله محمد بن يوسف الأحمر (629 - 671هـ/ 1232 - 1273م) الذي نقش علامته على طوبة في جدار القصر استقرت من بعده في مكانها، ونصّت على ما يلي: «ولا غالب إلا الله»، فقال يوسف: «تأمل عظمة الإسلام، تغلب المسلمون في زمانهم على العالم فلم يتغطرسوا كما يتغطرس الذين يتحكمون بمقادير العالم اليوم ولم يقولوا غلبنا بل قالوا: «ولا غالب إلا الله».
رحمك الله أيها الأستاذ المُعلِّم يوم وُلدت ويوم مُتَّ ويوم تُبْعثُ حيًا، فلقد كنتَ، بعلمكَ وعملكَ، الأمين الواعي اليقظ الساهر على وجدان الأمة الإسلامية وعقيدتها ضد كل غلو أو قنوط أو جحود، ورحمك الله كلما قرأ قارئ في مُنزل تحكيمه ﴿إِن يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ﴾ (آل عمران) صدق الله العظيم.
ربّنا اغفر لنا خطايانا ولا تخذلنا فوق ما نحن فيه، فلا ناصر لنا سواك، وإنّنا عليك من المتوكّلين.
مصادر ومراجع مختارة
- أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن الأحمر (ت: 771هـ/ 1369م)، كتاب مُسْتَوْدِع العَلامة ومُستبدِع العَلاَّمة، حقّقه محمد التركي التونسي ومحمد بن تاويت التطواني، منشورات كلية الآداب والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، المطبعة المهدية، تطوان (المغرب)، 1384هـ/ 1964م.
- أحمد الإيبش وقتيبة الشهابي، معالم دمشق التاريخية، دراسة تاريخية ولغوية عن أحيائها ومواقعها القديمة، تراثها وأصولها واشتقاق أسمائها، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1996م.
- الأمير يوسف كمال:
- سياحتي في بلاد الهند الإنجليزية وكشمير 1913 - 1914م، حرّرها وقدم لها جمال ملحم، دار السويدي للتوزيع، أبو ظبي، 2003م.
- سياحتي في بلاد التيبت الغربية وكشمير (1915م)، حرّرها وقدّم لها جمال ملحم، دار السويدي للتوزيع، أبو ظبي، 2004م.
- برجيت مارينو، حي الميدان في العصر العثماني، ترجمة: ماهر الشريف، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 2000م.
- حبيب الزيات (ت: 1954م)، الخزانة الشرقية، مجلة أدبية تاريخية متخصصة بالمشرقيات، 4م، فيها مجموعة متميّزة من التحقيقات والدراسات عن مدينة دمشق وأحيائها وحاراتها وحمّاماتها وأسواقها ط2، مكتبة السائح طرابلس، لبنان، 1999.
- خليل ساحلي أوغلي، من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني - بحوث ووثائق وقوانين، منظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إريسكا)، إسطنبول، 2000م.
- خير الدين الزركلي (ت: 1976م)، الأعلام، قاموس تراجم، 8ج، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م.
- شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت: 681هـ/ 1282م)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 8ج، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1968 ـ 1972م.
- شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي (ت: 953هـ/ 1546م).
- إعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، حققه محمد أحمد دهمان، دمشق، 1383هـ/ 1964م.
- حوادث دمشق اليومية 926 - 951هـ من كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، تحقيق: أحمد إيبش، دار الأوائل، دمشق، 2002م.
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق: محمد أحمد دهان، دمشق، 1949 - 1956م..
- صلاح جرار، ديوان الحمراء - الأشعار العربية المنقوشة في مباني قصر الحمراء وجنَّة العريف بغرناطة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1، 1999م.
- صلاح الدين خليل بن ايبك، الصفدي (ت: 764هـ/ 1363م)، أمراء دمشق في الإسلام، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 1955م.
- صلاح الدين المنجد، معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1978م.
- عبد الرزاق البيطار (ت: 1335هـ/ 1917م)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، 3ج، حققه محمد بهجت البيطار، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، 1963م.
- عبد القادر بن محمد النعيمي (ت: 927هـ/ 1527م)، الدارس في تاريخ المدارس، 2ج، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 1948 - 1951م.
- كمال الصليبي، طائر على سنديانة – مذكرات، دار الشروق، عمان، 2002م.
- مجلة العاصمة، جريدة الحكومة الرسمية 1338هـ/ 1920م إشراف: محمد عدنان البخيت، جمع وإعداد: هند أبو الشعر، محمد الأرناؤوط وسلطي الشخاترة، جامعة آل البيت، 1998، الأعداد: 150 - 162.
- محمد أديب آل تقي الدين الحصني (1292هـ/ 1874م - 1358هـ/ 1940م)، كتاب منتخبات التواريخ لدمشق، 3ج، قدّم له كمال سليمان الصليبي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1979م.
- محمد بن جمعة المقار الحنفي (ت.ح 1156هـ/ 1743م) ومعه كتاب الباشات والقضاة، نشرهما صلاح الدين المنجد، دمشق، 1949م.
- محمد كرد علي (ت: 1953م)، خطط الشام، 6ج، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1971م.
- مقالات كل من دمشق، ديار بكر وماردين في الموسوعة الإسلامية، الطبعة الثانية باللغة الإنجليزية.
- ياقوت الحموي، شهاب الدين بن عبد الله الرومي، (626هـ/ 1228م)، معجم البلدان، 5ج، دار إحياء التراث العربي بالاعتماد على ما حقّقه فرديناند وستنفلد ليزج (1866 - 1870م)، بيروت، 1979م.
- يوسف بن عبد الهادي (ت: 909هـ/ 1503م)، ثمار المقاصد في ذكر المساجد، تحقيق: أسعد طلس، ط2، المعهد الفرنسي بدمشق، مكتبة لبنان، بيروت، 1975م.
- Linda schatkowski schilcher, families in politics, damascene fac - Tions and estates of the 18 th centuries, franz steiner verlag wies - Baden gmbh Stuttgart, 1985.
- Philip s.khoury, urban notables and arab nationalism – The Politics of Damascus 1860 – 1920, Cambridge university press,cam - Bridge, 1983.
- Stephen B.L. PENROSE? JR.,that they may have life: the story of the American University of Beirut 1866 – 1941, Beirut, 1970.
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، . ص*32-*11 |