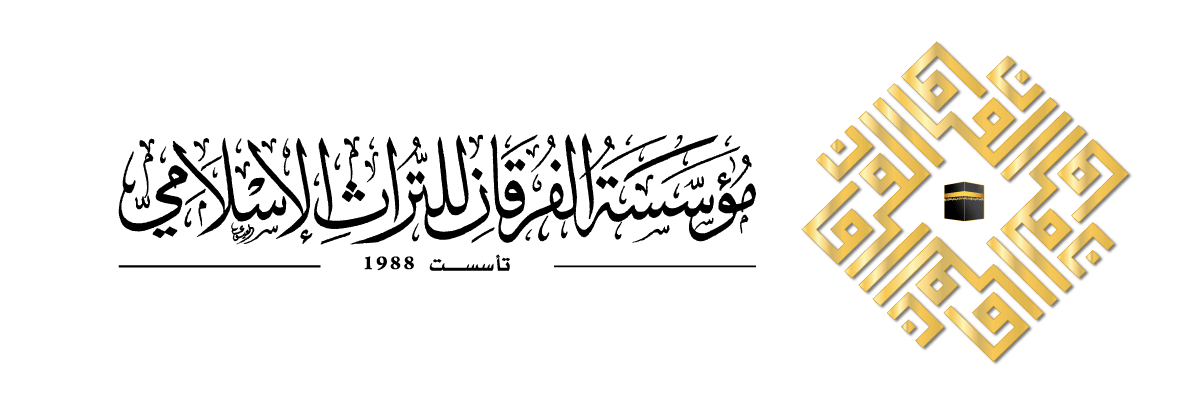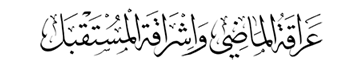الشيخ محمد الخليلي

قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾1، فلو لم يكن لبيت المقدس من الفضائل إلاّ هذه الآية لكانت كافية ولجميع البركات وافية، وكيف لا وهو محل الآيات ومنزل البركات ومجمع الأرواح الطاهرات، وقال تعالى في شأن إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام: ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾2. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ3 وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾4 وهي قرى الشام (9ب) الشاملة لها الأرض المقدسة الأوسع منها كما يعلم ذلك من حدود الشام والأرض المقدسة كما يأتي5، ومنها قوله تعالى لبني إسرائيل ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾6، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾7، قيل: بوأهم الشام وبيت المقدس وقيل: بيت المقدس خاصة.
ومنها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾8 والساهرة إلى جانب بيت المقدس ومنها قوله تعالى: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾9 قال عقبة بن عامر10: التين دمشق الشام، والزيتون بيت المقدس11. وقال تعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾12 هو سور بيت المقدس باطنه أبواب الرحمة وظاهره وادي جهنم13.
وممّا يدلّ على فضله من السُنّة ما رواه أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ14 يُبلّغ به قال: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا»15 وفي لفظ من رواية أبي16 سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ17 قال: «قال رسول الله ﷺ: لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى بيت المقدس»18. وعن أبي ذر، رَضِيَ الله عَنْهُ19، قال: «قُلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً. قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي. قال: المسجد الأقصى، قال: قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قال: فأيهما أدركتك الصلاة فصلّ فهو مسجد»20.
وعن عمران بن الحصين21 أنه قال: «قلت يا رسول الله ما (10أ) أحسن المدينة، قال: كيف لو رأيت بيت المقدس، قلت: وهو أحسن؟، فقال النبي ﷺ: وكيف لا يكون وكل من بها يزار ولا يزور وتهدي إليه الأرواح ولا يُهدى روح بيت المقدس إلا إلى الله تعالى أكرم المدينة وطيبها بي وأنا فيها حيّ، وأنا فيها ميت، ولولا ذلك ما هاجرت من مكة فإنيّ ما رأيت القمر في بلد قط إلاّ وهو بمكة أحسن»22، وقال كعب23: لا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام بيت المقدس فيقادان إلى الجنة جميعا وفيهما أهلهما والعرض والحساب بيت المقدس24.
وقال سليمان: لقد يأتي مسجد الله إلى بيت المقدس، يعني يؤتى بالكعبة إلى بيت المقدس25، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾26. ذهب جمع من المفسرين أنها بيت المقدس. فتأمل هذا البلاغ إلى العبّاد ليأتوا إلى بيت المقدس لأجل العبادة فيه، فيضاعف لهم الأجر وتقرب بهم المسافة في الحشر وتكون أرواحهم في محل من غير نقل، وهذا شهادة من الله تعالى إلى أنّ الوارث لبيت المقدس هم الصالحون، وأن المالك لها خير الملوك والخادم لها خير الخلق، والعابد فيها مشهود له بالصّلاح. قال عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: إن الحرم المحرم في السموات السبع بمقداره في الأرض، [وإن بيت المقدس مقدس في السماوات السبع بمقداره في الأرض]27. قال كعب: إن الله ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مرتين28 وقال: باب (10ب) مفتوح من السماء من أبواب الجنة ينزل [منه]29 الحنان هو كحساب الرحمة فعطفها عليه تفسير، والرحمة على بيت المقدس كلّ صباح حتى تقوم الساعة30. وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ31 أنه قال: «قال رسول الله ﷺ من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس وبيت المقدس من جنة الفردوس»32. وقال وهب بن منبه33: أهل بيت المقدس جيران الله وحق على الله أن لا يعذب جيرانه34. وقال مقاتل35: صخرة بيت المقدس وسط الدنيا وإذا قال العبد لصاحبه انطلق بنا إلى بيت المقدس يقول الله تعالى يا ملائكتي اشهدوا إني قد غفرت لهما قبل أن يخرجا هذا إذا كانا لا يصران على الذنوب36. وقد رُوي عن الحسن البصري37 من تصدق في بيت المقدس بدرهم كان [له] براءة من النار ومن تصدق لله [فيه] برغيف كان كمن تصدق بمثاقيل ذهبا، وفي رواية عنه: من تصدق في بيت المقدس بدرهم كان فداءه من النار، ومن تصدق برغيف كان كمن تصدق بجبال الأرض ذهبا38. وعن مكحول39 عن كعب: من أتى بيت المقدس فصلى فيه عن يمين الصخرة وعن شمالها ودعى عند موضع السلسلة وتصدق بما قل أو كثر استجيب دعاؤه وكشف الله حزنه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن سأل الله الشهادة أعطاه إياها40، وقال مكحول: من صلى في بيت المقدس ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ثم صلى الغداة (11أ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه41.
وروى زياد بن أبي سودة42 عن أخيه عثمان بن أبي سودة43 عن ميمونة بنت سعد44، مولاة رسول الله ﷺ، أنها قالت: «يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة [فيه] كألف صلاة [فيما سواه]. قلت: يا رسول الله فمن لم يستطع أن يأتيه. قال: فليهد إليه زيتا يسرج في قناديله فإن من أهدى له زيتا كان كمن أتاه»45. وعن ثور بن يزيد46. عن مكحول أن ميمونة سألت رسول الله ﷺ عن بيت المقدس «فقال: نعم المسكن بيت المقدس، ومن صلّى فيه صلاة كانت كألف صلاة فيما سواه. قالت: فإن لم نطق. قال: فليهد إليه زيتا»47. وعنها أنها قالت: «قلت يا رسول افتنا في بيت المقدس. فقال: ائتوه فصلوا فيه. قالت يا رسول الله فكيف والروم إذ ذاك فيه: قال: فإن لم يستطيعوا فابعثوا بزيت يسرج في قناديله»48. وقال رسول الله ﷺ: «من أسرج في بيت المقدس سراجا لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام ضوؤه في المسجد»49. وقال كعب: من أنفق في عمران بيت المقدس وقاه الله المؤتلف والمتآلِف وسنى في أجله وأحياه الله الحياة الطيبة وقَلَبَه منقلبا كريما، ومن أنفق في بيت المقدس أجاب الله دعاءه وكشف حزنه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ﷺ: (11ب) «إن خيار أمتي تهاجر هجرة بعد هجرة إلى بيت المقدس، ومَن صلّى في بيت المقدس بعد أن يتوضأ ويسبغ الوضوء ركعتين أو أربعا غفر الله له ما كان قبل ذلك»50. وقال: يطلع الله كل صباح إلى سكان بيت المقدس فَيدرّ عليهم من رحمته وحنانه ثم يدرّه على سائر البلدان. قال: والطّل الذي ينزل على بيت المقدس شفاء من كل داء. ويقول الله تعالى: المقبور في بيت المقدس يجاور51 في داري ألا وإن الجنّة داري لا يجاورني فيها إلا السخاء والحلم52. وقال النبي ﷺ لأبي عبيدة بن الجراح53 رَضِيَ الله عَنْهُ: «النجاء النجاء إلى بيت المقدس إذا ظهرت الفتن. قال: يا رسول الله فإن لم أدرك بيت المقدس. قال: فابذل واحرز دينك وفي لفظ فابذل مالك واحرز دينك»54. وقال الله تعالى لصخرة بيت المقدس: من أحبك أحببته ومن أحبك أحببته ومن أحبك أحبني ومن شنأك شنأته، عيني عليك من السنة إلى السنة لا أنساك حتى أنسى عيني، ومن صلّى فيك ركعتين أخرجته من الخطايا كما أخرجته من بطن أمه إلا أن يعود إلى خطايا مستأنفة تكتب عليه، لا تذهب الأيام والليالي حتى يحشر إليك كل مسجد يذكر فيه اسم الله يحفون بك حفيف الركب بالعروس إذا أهديت إلى أهلها أنزل عليك نارا من السماء تأكل ما داسته أقدام الناس وما مسته أيديهم. (12أ) وهذا حديث طويل ذكره الحافظ أبو محمد القاسم55، وفيه: ضمنت لمن سكنك أن لا تعوزه أيام حياته خبز البر والزيت56.
قال في إتحاف الأخصا: وكان عدد من عمل في بناء بيت المقدس ثلاثين ألف رجل وعشرة ألف منهم عليهم قَطْعُ الخشب. قال: وكان الذين يعملون في الحجارة سبعين ألف رجل، وعدد الأمناء عليهم ثلاثمائة غير المسخرين من الجن والشياطين. قال: وعمل فيه سليمان عَلَيْهِ السَلاَم عملا لا يوصف ولا يبلغ كنهه أحد، وزينه بالذهب والفضة والدّر والياقوت والمرجان وأنواع الجواهر في سمائه وأرضه وأبوابه وجدرانه وأركانه مما لم ير مثله، وأسقفه بالعود الإخليلج57 وصنع له مائة سكرة من الذهب زنة كل سكرة منها عشرة أرطال، وأولج فيه تابوت موسى وهارون58. قال الكلبي: ولما فرغ سليمان عَلَيْهِ السَلاَم من بناء بيت المقدس أنبت الله له شجرتين عند باب الرحمة إحداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة؛ فكان كل يوم ينزع من كل واحدة مائتي رطل ذهبا وفضة. وقال: وفرش المسجد بلاطة من ذهب وبلاطة من فضة59. ولما رفع سليمان عَلَيْهِ السَلاَم يده بعد الفراغ منه وإحكامه، جمع الناس وأخبرهم أنّه مسجد لله تعالى وهو أمره ببنائه، وإن كلّ شيء فيه لله تعالى من انتقصه أو شيئا منه فقد (12ب) خان الله تعالى، وإن داود عهد إليه ببنائه وأوصاه بذلك من بعده ثم اتخذ طعاما وجمع النّاس ثم أمر بالقرابين فقربت إلى الله تعالى60. قال: ذكر لنا أن نبي الله سليمان عَلَيْهِ السَلاَم لما فرغ من بنائه ذبح ثلاثة آلاف بقرة وسبعة آلاف شاة ثم أتى المكان الذي في مؤخرة المسجد مِّما يلي باب الأسباط، وهو الموضع الذي يقال له كرسي سليمان، وقال: اللهم من أتاه من ذي ذنب فاغفر ذنبه أو ذي ضرّ فاكشف ضرّه. قال: فلا يأتيه أحد إلاّ أصاب من دعوة سليمان عَلَيْهِ السَلاَم. وهو الذي هو معروف بكرسي سليمان من الأماكن المعروفة بإجابة الدعاء61.
وأما حدود الأرض المقدسة: فمن القبلة أرض الحجاز الشريف يفصل بينهما جبال الشراة62 وهي جبال منيعة بينها وبين أيلة نحو مرحلة، وسطح أيلة هو أول حد الحجاز من جهة الشام وهي من تيه بني إسرائيل، وبينها وبين بيت المقدس نحو ثمانية أيام بسير الأثقال، ومن الشرق دومة الجندل برية السماوة وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزل بها عرب الشام ومسافتها فمن بيت المقدس نحو مسافة أيلة، ومن الشمال مما يلي الشرق نهر الفرات63 ومسافته عن بيت المقدس نحو عشرين يوما بسير الأثقال، فيدخل في هذا المملكة الشامية بكمالها ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح ومسافته (13أ) عن بيت المقدس من جهة رملة فلسطين نحو يومين، ومن الجنوب رمل مصر والعريش ومسافته عن بيت المقدس نحو خمسة أيام ثم يليه تيه بني إسرائيل وطور سيناء ويمتد من تلك الجهة إلى تبوك ثم دومة الجندل المتصلة بالحد الشرقي، وتأمّل كلام العارف الرباني والهيكل الصمداني سيّدي عمر بن الفارض64 من قيل أنّ نظمه أحد قسمي الإعجاز النظم والنثر القرآن العظيم في قوله65: [من الطويل]
| ومـــا سكـــنته فهـــو بيــت مقدسٍ ومسجديَ الأقصى مساحب بردها | بقـرة عينـي فيـه أحشـــــائي قرّتِ وطيبي ثرى أرض عليها تمشّتِ |
قال شارح كلامه الفرغاني66: وإنّما خصّ المسجد الأقصى بكونه مسحب رداء الحضرة المحبوبة لأن سحب الذّيل والرّداء من خصائص من يتفاخر بالكبرياء، والمسجد الأقصى هو حدقة عين بيت المقدس ونقطة دائرة كماليّته وروحانيّته، وبيت المقدس هو كعين لروحانية جميع الأرض وأنّ لكل شيء روحانيّة باطنة في صورته حتى في كلِّ جزء وذرّة من الأرض وغيره، والإشارة إلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾67 يعني روحانيّته. وأرض بيت المقدس أرفع وأعلى من روحانيّة غيره من الأرض وأغلب من حيث [نفس]68 الروحانيّة وأظهر أثرا وحكما، وأمّا روحانيّة مكّة فهي أجمع للكمال الحقيقيّ المختصّ بالجمعيّة (13ب) وأعلى69 في جمعيتها بين جميع الأوصاف والكمالات الروحانيّة والجسمانيّة وأعلى من تلك الجمعيّة واتصالاتها70.
وكانت أرض الكعبة71 قلب جميع الأرض ومجمع جميع الكمالات الروحانيّة والجسمانيّة، فاعلم ذلك. وحيث أنّ روحانيّة المسجد الأقصى أعلا من جهة نفس الرّوحانيّة وأغلب وأظهر حكما وأثرًا حتى ظهر أثر ذلك من حيث72 اسمه بأن سميّت أرضه أرض القدس لغلبة حكم قُدس الرّوحانيّة عليها، ويسمى ذلك الموضع المعين منه المسجد الأقصى أي الأبعد عن أحكام الجسمانيّة حتى قلّما يدخله أحد ولم يجد في نفسه نشاطا73 وروحا ونزاهة نفس عن الميل إلى الألواث الطبيعية وكأن للرّوحانيّة كبرياء على الجسمانيّة أبدا لعلو درجتها وكبر قدرها لا جرم كانت إلهية الخصيصية بوصف الكبرياء وهي جرّ أذيال الرداء مختصة بالمسجد الأقصى إذا ظهر للمكاشف الوصف [وكان الوصف]74 بتلك الهيئة اللاّئقة به، فعلى هذا يقول: كان قبل هذا لا يظهر موضع من الأرض [في نظري]75 بوصف الكبرياء إلاّ المسجد الأقصى وبيت المقدس، والآن كل موضع رأيت فيه أحدا يتبختر بوصف كمال وجدته مظهرًا للحضرة المحبوبيّة من حيث باطن جماله المتجلّى من حيث مقام أحدية جمعها، فذلك الموضع الذّي أرى مسحب بردها هو عين مسجدي الأقصى غير مقيد بمكان معين وموضع مخصوص76. وهنا حسبنا تحقيق من سّر الغيب وعين السّر يظهر به الفرق بين ما فضل (14أ) من ذوات، وإن منعه، ولكن يحتاج إلى مقدمتين: الأولى، أن المرَاتب أمور معنوية ثابتة في حضرة العلم الأزليّ كباقي المعاني، إلا أن بعض المعاني المتتابعة متعلقة بهذه المعاني المسمّاة بالمرَاتب داخلة في حيطتها بحيث تكون في جميع أحوالها محكومة بها، ولو قدر ظهورها بالوجود العيني يكون ظهورها بحسب مقتضيات هذه المراتب وبحكمها، وهي كالمحالّ المعنويّة لما كان تحت حيطتها فكليّات هذه المراتب خمس: منها اثنتان منسوبتان إلى الحق في ظهوره لنفسه إحداهما منسوبة إليه هي ظهوره مجملاّ لنفسه ومندرج فيه تفصيله. والثانية منسوبة إليه هي ظهوره مفصلا لنفسه مندرج فيه إجماله. وأمّا الثلاثة الكونية، فأولها مراتب الأرواح، وثانيها مرتبة المثال، وثالثها الحس. أمّا مرتبة الحسّ لما كان محلا وظرفا للمحسوسات فلم تستغن عن مظهر مناسب لما يحويه ويحل فيه ولما كانت مظروفات مرتبة الحسّ المذكورة نوعين: أحدهما أجسام وثانيهما أعراض، صار لهذا المعنى أي لمرتبة الحس مظهران؛ أحدهما زمان والآخر مكان، فنسبة الزمان إلى الإعراض أتمّ ونسبة المكان إلى الأجسام أقوى، فصار هذان المظهران ظرفين لجميع المحسوسات لا يخرج محسوس عن حكمهما من حيث أنّه محسوس أصلا، لا جرم كل قُربة وعبادة بدينه صادرة من الإنسان (14ب) كان متعلّقا بهذين المظهرين.
المقدمة الثانية: اعلم أن الزّمان صورة مقدّرة من الهيئات العلوية السّماوية كما أن المكان صورة مقدرة من الهيئات السفلية وجميع صور الهيئات الاجتماعية من الأسماء والصفات الإلهية ومن توجهاتها في الغيب، ولما كانت الأسماء والصفات الإلهية متفاوتة الدرجات في الرتبة والشرف وسعة الحيطة، وبسرعة التأثر بالإجابة ونحو ذلك، لا جرم كان لبعض الأزمنة والأمكنة التابعين لها شرف وفضل على البعض بحيث77 تكون القربات والطاعات الواقعة في البعض تزيد في صحة النتيجة وقوتها على البعض الآخر، والنصوص الواردة تدل على صحة ما قررناه كما في فضيلة ليلة القدر ورمضان والجمعة وفي فضيلة الحرمين وبيت المقدس وفضائل أعمال متعلقة بها كالصلاة والصوم وإحياء بعض الليالي والطواف والسعيّ والوقوف وزيارة التربة المقدسة على ساكنها الصّلاة والتحيّة وأمثال ذلك.
وتقيد هذه الفضائل وأحرازها بهذين المظهرين78 والاختصاص والتقيّدات ببعض دون بعض، إنما يكون لمن كان مقيّدا بحكم هذين المظهرين وبالمراتب أو بأحكام الأسماء والصفات، فأما من كان مخلّصا عن جميع التقيّدات والاختصاصات وخارجا عن جميع الأسماء والصفات وعن حيطتها فحاله نوع وطراز آخر على ما تقرّر عند (15أ) أهله، إذا علمت أنّ بيت المقدس هو روح الأرض وأن الرّوح وأعلى من الجسد علمت أنّ المتعلقة همته بالرّوح يكون هو الأرقى والأعلى في النّاس، وأنّه هو المنصور والمؤيّد كجناب مولانا السلطان أحمد خان رفع الله قدره أعلى المنازل وبوأه المشارق والمغارب، وجناب حضرة وزيره مدبر جمهور العالم وفّقَهُ الله لكل خير، وجناب حضرة الملا محمد أفندي حفظه الله، المباشر لذلك، «الأرواح جنود مجنّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»79، فإذا تأمّلت ذلك ظهر لك معرفة النفوس القدسيّة الكماليّة العالية القدر والمزية المتعلقة بالخيرات الدنيويّة والأخروية والأماكن المفضلة المرضيّة، والأزمان العلية والأشخاص العلمية العملية أهل الفضل والمزيّة من النفوس الشقيّة الشرّيريّة، النافرة من كل خيرية، الطالبة لكل منقصة رديّة، وكلّ ذلك سوابق التجليّات الإلهية، والاختصاصات الاسمائية والأنوار الإلهية، والله اعلم.
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: الماء ومصادره في مدينة القدس الشريف وجهود الدولة العثمانية في توفيره: دراسة وثائقية من خلال السجل الشرعي مع تحقيق رسالة في تعمير عين بيت المقدس للشيخ محمد الخليلي، إعداد محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،2014، لندن، ص 111-12. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني. |