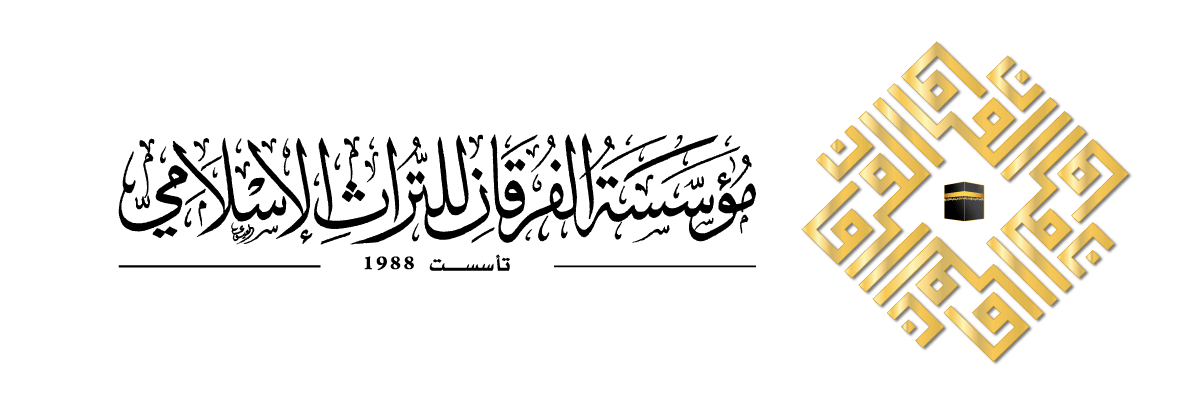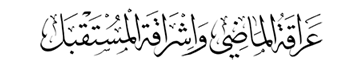محمد عدنان البخيت
يسرّني أن أتوجّه بالشكر هنا إلى الزميلين الأستاذين: الدكتور خليل ساحلي أوغلو من كلية الاقتصاد بجامعة إستانبول، والدكتور فاضل بيات من لجنة تاريخ بلاد الشام بالجامعة الأردنية، لما قدّماه من عون علمي كبير لي في قراءة قانون نامة ولاية الشام. وتقديري لزميلي الدكتور نوفان رجا السوارية على جهوده في تقديم العون والمساعدة. والشكر أجزله إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري على قراءته الدقيقة للبحث ولملحوظاته القيِّمة التي أبداها. كما وأتقدم بالشكر إلى المسؤولين عن إدارة أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول الذين وافقوا على تصوير (T.D.474) لغايات هذا البحث، والشكر موصول إلى سعادة السفير الأردني السابق بأنقرة، الدكتور معروف البخيت، والسيد حمود القطارنة من بعثة السفارة هناك، لما بدلاه من جهود في تصوير الدفتر، والشكر أيضًا إلى الدكتور مهند المبيضين، وللسيد إيمان عمورة لما بذلت من جهود مشكورة في طباعة النص .

يُقدِّم لنا علي دفتري، محرّر دفتر طابو (T.D.474) تاريخ 977هـ/ 1569م، المحفوظ بأرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول، قائمةً تفصيلية ًبمحصول المقاطعات في نفس دمشق الشام، وكان ربع هذه المقاطعات يُشكِّل جزءًا من خاص السلطان ((خلّد الله مُلكه)) الذي يشير إليه الدفتر باسم ((باديشاه عالمبناه)) ((سلطان العالم وملاذه)). كما يزودنا بأسماء نواحي لواء الشام1 التي كان ريعها يعتبر جزءًا من خاص السلطان .
ومن المفيد جدًا قراءة أسماء هذه المقاطعات 2 وفهم مكوناتها على ضوء المادة المتوافرة في قانون نامة الشام3 سواء التي جاءت في مقدمة هذا الدفتر أم ماجاء في الدفتر الجديد المفصل لعام 955 هـ / 1548م، فالفترة الفاصلة بين إجراءات المسوحات للدفترين كانت 21 عامًا. ويذكر لنا علي دفتري المُشار إليه مُبررًا إجراء هذه المسوحات في مقدمة القانون نامة أنه مع جلوس السلطان سليم خان ابن السلطان سليمان القانوني (974هـ/1566م- 982هـ/ 1574م) على عرش السلطنة، تقرّر: ((تجديد وتعديل لباس حروف دفاترها [أي دفاتر دمشق] العتيقة وتحقيق زيادة ونقصان قراها ومزارعها وتحريرها وتوجيه تيمارات طائفة السباهية وتصحيح أصحاب الأوقاف والأملاك)). ويشير إلى أنه ثمّ ((توجيه وتعيين توزيع وتقسيم الدفتر لأمير الأمراء والسباهية والزعماء على قدر طبقاتهم واختلاف درجاتهم وأصحاب الأوقاف والأملاك بحسب استحقاقاتهم بمقتضى الشرع المطهر والقانون المنيف)). وتمّ تحرير ((المحصولات الشهرية والسنوية والحقوق الشرعية والعرفية )) .
من هنا نلحظ القواعد التي اتُّبعتْ والتي تشير هنا بشكل خاص إلى التكامل بين ((الشرع المطهّر والقانون المنيف)) .
وبموجب هذا الدفتر، فإن لواء الشام قد شمل خمس (شهر) بلدات4أو قصبات5، وكان عدد القرى (1129) قرية مُضافًا إليها (2100) مزرعة، هذا بجانب (210) قطع أراضٍ . ويشير هذا المسح لخمس قصبات (شهر)، حيث توجد المحلات والأسواق والمسجد الجامع، ويذكر الدفتر أن عدد الخانات (الأسر) الخاضعة للرسوم العرفية والعوارض الديوانية (57110) خانات مُضافًا إليها (8348) مجردًا (أعزب أو غريب)، أما عدد الخطباء والأئمة والمؤذنين فكان (287). والمعلوم أن قانون نامة الشام يعفي هؤلاء من الرسوم العرفية والعوارض الديوانية: ((كما أن الأئمة معفون من العوارض الديوانية والتكاليف العرفية )) (مادة 81).
ويُبيِّن الدفتر أن محصولات لواء دمشق الشام بلغت (15804300) آقجة 6 سنويًا منها حصة خاص السلطان ((خُلِّدت خلافته)) البالغة (11044300) آقجة سنويًا. وبلغ خاص أمير الأمراء/مير ميران مليون آقجة سنويًا، أما بقية المبلغ فكانت موزعةً بين أصحاب الخاص وأصحاب التيمارات من أهالي التذاكر (باتذكرة) أو بدون تذاكر (بلا تذكرة) كما هو موضع أدناه. وسنتناول هنا محصول المقاطعات7 من نفس دمشق الشام التي كان ريعها يعتبر من خاص السلطان. ويشير الدفتر إلى الضمان الذي كان يوفر دخلاً سنويًا مقداره (1200) آقجة . ويُفهم من ذلك أن السلطات العثمانية بدمشق كانت تعرض المقاطعات للالتزام والمشاركون يدفعون رسمًا لذلك .
1- محصول مقاطعة احتساب نفس شام في السنة (600,000) آقجة
والملحوظ أنه عند استقراء المادة المتوافرة لدينا فإنّها لا توضّح القاعدة التي كانت تُتبّع في جمع هذا المبلغ الضخم، وهناك تخمين بأن الأمناء8 (موظفي الدولة الماليين) كانوا يجمعون رسومًا على الدكاكين والمحال التجارية على أسس شهرية وبذلك تكوّن هذا المبلغ الكبير. ويشير قانون نامة القدس إلى عادة الاحتساب في القدس الشريف،بما نصه: ((منذ القدم كان يتم استيفاء آقجة واحدة عن كل دكان في كل خميس باستثناء سوق العطارين، فمنذ القدم لا يؤخذ منه شيء)) فيمكن قياس الشام على القدس))9 . وعند العودة إلى القانون نامة نفسه لبلاد الشام نجده ينصّ على مايلي :
((لم يكن يوجد منذ القدم قانون مقرر يتعلّق بالاحتساب في نفس الشام ولهذا يتمّ العمل بقانون قايتباي)) (مادة 79 من القانون). والملحوظ أن كتب الحسبة لا تتعرّض لموضوع الاحتساب بمفهوم أنها رسوم وعوائد مالية .
وقانون السلطان المملوكي الملك الأشرف قايتباي المحمودي (872هـ/ 1468م – 901 هـ/1496م) غير متوافر للباحثين، وإلى أن يكتشف، تبقى الإشارات التاريخية قليلة، مثل ما جاء في أخبار سنة (910 هـ/1505م) ((وفي يوم الجمعة خامس عشر ( 21/1/1505م) شعبان المذكور نودي بدمشق بإبطال مشاهرة المحتسب وفرح الناس بذلك فرحًا شديدًا ودعوا للنائب))10.
2- محصول القبان11 في نفس شام مع دار البطيخ12 ودار الخضر مع محصول عنب العصير من اليهود والنصارى والسامرى (السمراء) في السنة (16000) آقجة
لقد اعتمد الأمناء قاعدة الحمل والقالب 13 في احتساب مقدار الرسوم المجباة على المنتوجات الحيوانية أو النباتية، كما ويستخدم الدفتر مصطلح ((علبة)) عند الإشارة للبن واللبن الرائب، ومصطلح ((ظرف))14 عند الإشارة للدبس15. ويُفصِّل القانون نامة في هذا الموضوع ويُفقِّطها مفصلةً على النحو التالي :
| 1 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل الدبس |
| 2 | أربع آقجات | 4 | عن حمل العسل |
| 3 | أربع آقجات | 4 | عن حمل الأرز (حول الأرز في الشام، انظر: البدري، حيث يشير إلى طرق طهيه مع الدهن واللبن، ومع الحليب، نزهة الأيام، ص 303 . ) |
| 4 | خمس آقجات | 5 | عن حمل الجبن (كان هناك سوق للجبن في دمشق، الزبيدي، تاج،ج 34،2001م، ص 344. حول الجبن وخانه وأنواع الجبن، انظر أيضًا: محمد سعيد القاسمي (ت 1317هـ/1900م) وجمال الدين القاسمي (ت 1332هـ/ 1914م) وخليل بن مصطفى بن حافظ باشا العظم (ت 1352 هـ/1933م)، (الجبن) – قاموس الصناعات الشامية، حقّقه وقدّم له ظافر القاسمي، دمشق، 1988م، ص 76- 77 . ) |
| 5 | ست آقجات | 6 | عن حمل حب الرمان (يتحدّث البدري فيقول: ((والرّمان أصناف : شويكي، بردي، ماوردي، مليسي،كوفي – برجنيقي، سحاقي، شويخي، مصري، سلطاني، محجر، مطوق، تدمري، لقيط، حصوي، طقاطقي، قطي، مشبه، حامض للطعام لفان، راس البغل، مجهول، نزهة الأنام، ص 214، والجدير بالذكر أن كثيرًا من هذه المسميات ما زالت سائدة إلى اليوم . ) |
| 6 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل الملح |
| 7 | ثماني آقجات | 8 | عن حمل البعير من التمر العراقي بالإضافة إلى رطلين يؤخذان كطعمة (الطعمة: يفهم أنها كانت نوعًا من الفيء أو الخراج أو الإتاوة، راجع: السيد مرتضى الزبدي، مادة ((طعم))، تاج العروس، ج 33، ص 15،21. حول الطعمة بدمشق، انظر: صلاح الدين المنجد، هامش 1 ص 34 أدناه. أما فيما يتعلّق بالطعمة، فيذكر محمد بن عمر الواقدي (ت207 هـ/822م) ((كانت الطعمة تؤخذ بصاع النبي ﷺ حتى كان يحي بن عبد الحكيم فزاد في الصاع سدس المدّ))، كتاب المغازي،3ج، تحقيق مارسدن جونز،مطبعة جامعة أكسفورد، 1966م، ج2، ص 697. ويذكر الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ/915م) ((إن صاع الرسول كان يساوي مدين وثلثي المد))، السنين ،8ج، ط1، تحقيق حسن محمد المسعودي، المطبعة المصرية بالأزهر،1930م، ج5، ص54 .يشير إليها القلقشندي عند استعراضه للوظائف وماهيتها بدمشق، فيذكر: ((شد دار الطعم وهي بمثابة الوكالة بالديار المصرية وولايتها عن النائب))، صبح، ج4، ص187. ويذكر ابن طولون الصالحي، ((حارة دار الطعم))، انظر: حارات دمشق القديمة، تحقيق حبيب الزيات،الخزانة الشرقية، ص53 . لقد أفدتُ كثيرًا في تتبع الجذور الفقهية والاقتصادية والمالية والتاريخية لكثير من المصطلحات المالية والضريبية التي وردت في الجامع لنصوص الاقتصاد الإسلامي، 3ج، إشراف عبد العزيز الدوري، منشورات مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي،عمان، 2002-2003م. وللمزيد من بيان خلفية مصطلح الفيء والطعمة، انظر: محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (ت 387هـ/997م)، ((الفيء: ما يُؤخذ من أرض العنوة))، وتعريفه للطعمة علي النحو التالي: ((هي أن تدفع الضيعة إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات ارتجعت عن ورثته))، مفاتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2. 1989م، ص 85-8 كذلك انظر: أحمد آق كوندوز، التشريع الضريبي عند العثمانيين، ترجمة فاضل بيات، منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام، عمان، 2004م . ) |
| 8 | أربع آقجات | 4 | عن حمل القنبرس (القنبرس (القنبرص): قنبريس، يذكره شمس الدين محمد ابن طولون الصالحي (ت 953هـ/ 1546 م) على أنه من منتوجات بعلبك، ويشرحه محمد أحمد دهمان علي أنه ((اللبن الخائر وما زال الاسم مستخدمًا في بعلبك وجوارها)) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، 2ق، تحقيق محمد أحمد دهمان، مكتب الدراسات الإسلامية، دمشق، ق2،1949م، ق2، ص377، والهامش رقم جاءت لدى موسى بن محمد اليونيني (ت 726هـ/1326م) في أخبار وباء سنة 656- 658هـ/1258-1260م بدمشق أن أوقية ((القيبرسي)) بدرهم، والخطأ واضح في القراءة، ذيل مرآة الزمان، 4ج، ط1، حيدر أباد الدكن ،1954 مج1، ص 376.) |
| 9 | نصف آقجة | 0,5 | عن كل علبة لبن رائب الوارد من الجهات القبلية لمدينة دمشق |
| 10 | نصف آقجة | 0,5 | عن كل علبة من اللبن الوارد من جهة حمص وطرابلس |
| 11 | آقجتان | 2 | عن كل مائة آقجة من الزيت (السمن) الصافي |
| 12 | ست آقجات | 6 | عن حمل العنّاب ( كان هناك محلة في دمشق تُعرف باسم (العناب) في دمشق الشام وجوارها، انظر: البدري، حيث يذكر أنه كان يؤكل ويُشرب ماؤه: ((والمختار فيه ما عظم حبه وإن أُكل قبل الطعام فهو أجود)) . لمزيد من التفاصيل، انظر: نزهة الأنام ، ص 271- 272 . حول محلة العنّاب، راجع : (T.D.474)، ص 54 .) |
| 13 | ست آقجات | 6 | عن حمل تين المعرة بالإضافة إلى رطل من التين (حول التين وأنواعه في لواء دمشق الشام، انظر : البدري، حيث يذكر التين البرزي (نسبةً إلى قرية برزة) والتين المزي وماسوني والرومي وبعلبكي، كعب الغزال، غريب، طيفور (ترد في الدفاتر ديفور ومازالت التسمية مستخدمة إلى اليوم للدلالة على التين الذي يحل موسمه مبكرًا)، شتوي، جبلي، حفيراني، ملكي، عسيلي، مكتّب، مجهول ورق الطير،نزهة الأنام، ص261. أما فيما يتعلّق بالمعرة، فيشير الجغرافي المشهور ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 626هـ/1228م) إلى أن ماء معرّة النعمان من الآبار ((وعندهم الزيتون الكثير والتين))، 5ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1979م، ج5، ص156، وسيشار إليه فيما بعد : ياقوت ، معجم . ) |
| 14 | آقجتان | 2 | عن كل مائة آقجة ثمن فستق وبندق ( يأتي البدري بقصص عن زراعة البندق الأخضر والفستق وعن خصائصهما الطبية. انظر: نزهة الأنام، ص 312 - 317 . ويشير إلى نمو الصنوبر بجبال الثلج، ص351، حول رأي الفقهاء في بيع ذوات القشور: الجوز واللوز والبندق والفستق والفول والحمص، انظر: تقي الدين أحمد بن تيمية (ت 728هـ/1328م)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 30ج، مطابع الرياض،1961- 1963 م، ج29، ص225. ) وصنوبر |
| 15 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل الخل |
| 16 | نصف آقجة | 0,5 | عن حمل زيت السيرج / من السمسم ( يذكر البدري السمسم بالشام ويشير إلى خصائصه الطبية ويضيف: ((ودهن السمسم هو السيرج))، ويهمنا هنا الإشارة إلى استخدام كلمة ((دهن)) التي ترد في السجلات العثمانية بدل زيت،نزهة الأنام ، ص 308 . ) |
| 17 | ست آقجات | 6 | عن حمل الزيت من عجلون (حول محاصيل عجلون والزيتون في لوائها، انظر: دفتر مفصل لواء عجلون رقم (970)، نشر محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود، الجامعة الأردنية، عمان، 1989م، وبخاصة الصفحات 31 – 37 من الدراسة حيث تبين حاصل أشجار الزيتون مع العنب والكروم. وانظر أيضًا: دفتر مفصل لواء عجلون رقم (185) لعام 1005هـ/ 1596م، دراسة وتحقيق محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود، عمان ، 1991 م، انظر ص 82 - 87 بشأن معاصر الزيتون . ) |
| 18 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل الزيت المشقراني –(المشغراني) ([لايوجد في معاجم سورية ذكر لمشقرا، وبما كان المقصود ((مشغرا)) – على الأغلب - في البقاع بلبنان، مشغري: قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع، ياقوت، معجم، ج5، ص 134. انظر أيضًا: أنيس فريحة، ((مشغرة)) في أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها، الجامعة الأمريكية ببيروت، 1956م، ص 335 .] ) |
| 19 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل الحمار من القلقاس ( القلقاس: ينبت في الأراضي الحارة مثل قرية غور من أعمال دمشق ولا ينبت بغيرها من أرض الشام. انظر خصائصه الطبية، البدري، نزهة الأنام، ص 352-353. انظر موقف الفقهاء حول بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت والقلقاس والبصل والثوم والباقلاء،أحمد بن تيمية (ت 728هـ/ 1327م)، مجموع الفتاوى، 30 جزءًا، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد النجدي، الرياض، 1961-1963م، ج29، ص 225،228. انظر أيضًا: العز بن عبد السلام (ت 660هــ/ 1262م)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، 2ج، ط2، القاهرة، بيروت، دار الجبل، 1968 م، 1980 م ، ج2، ص 11. ) |
| 20 | ست آقجات | 6 | عن حمل البغل من القلقاس |
| 21 | سبع آقجات | 7 | عن حمل الخيار (الخيار: يذكر أن هناك قابون فوقاني وقابون تحتاني وإلى القابون يُنسب الخيار، ويعقد مقارنة ما بين الخيار والقثاء مثل الفقوس ، البدري نزهة الأنام ، ص 264- 268 . ) الوارد من الخراج |
| 22 | أربع آقجات | 4 | عن حمل جبن النصارى ( حول الجبن، أشرنا أعلاه إلى سوق للجبن بدمشق، لكن ليس لدينا تفصيلات كافية عن المقصود بجبن النصارى، هذا، ويشير قاموس المنجد في اللغة المعاصرة ((لقالب الجبن))، المنجد، بيروت، 2000م، ص 1177. ويشير عز الدين محمد بن شداد (ت 684هـ/1285م) إلى حمام الجبن، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي، دمشق، 1962م، ص 21. ) بالإضافة إلى ثلاثة (3) قوالب جبن |
| 23 | خمس آقجات | 5 | عن حمل البغل من الليمون (الليمون : يُعد البدري الأترج والليمون من الأشجار المثمرة بدمشق، نزهة الأنام ، ص 332 - 334 . ) |
| 24 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل الحمار من الليمون |
| 25 | أربع آقجات | 4 | عن حمل العجوة إضافة إلى نصف رطل من العجوة |
| 26 | ثماني آقجات | 8 | عن حمل الكماء (يشير البدري إلى أن الكمأة من خواص الشام، ثم يأتي بنقولات للعلماء في الكمأة، نزهة الأنام ، ص 301-303 .) وإذا كان الحمل ناقصًا غير كامل تؤخذ أربع آقجات (4) |
| 27 | آقجتان | 2 | عن ظرف دبس الخرنوب (يذكر البدري أن الخرنوب من أشجارالشام، نزهة الأنام، ص 342- 345. حول تعريف الظرف، انظر صفحة (6) هامش رقم (2) أعلاه . ) |
| 28 | أربع آقجات | 4 | عن حمل الكستناء |
ويوضح هذا الجرد أسماء وحدات القياس للكيل من ((الحمل)) و((القالب))، أما فيما يتعلق بالسؤال، فتشير القوائم إلى استخدام ((علبة)) و((ظرف))، والملحوظ في بعض المنتوجات كالتمر العراقي وتين المعرّة والعجوة، أن الأمناء كانوا يأخذون كمية إضافية يُشار إليها أحيانًا باسم ((طعمة))، وكانوا يأخذون أيضًا عن كل حمل من جبن النصارى، ثلاثة قوالب جبن. ويجيء ذكر محصول دكان الجبن المغلي في نفس الشام والذي كان يوفر دخلاً سنويًا مقداره (2400) آقجة. وتوضح هذه القائمة أسماء السلع الزراعية والتموينية التي كانت تُباع في أسواق دمشق، وإذا ما استعرضنا المواد التي ترد تحت دار البطيخ16، نجد أنها تشمل مايلي، مع بيان مقدار الرسوم المُجباة عن كل حمل أو جوّال – شوال17 (كيس) :
| 1 | آقجتان | 2 | عن حمل المشمش ( يذكر البدري واحدًا وعشرين صنفًا من المشمش بدمشق: حموي، سندياني، أُويسي، عربيلي، خراساني ،كافوري، بعلبكي، لقّيس، لوزي، دغمشي، وزيري، كلايي، سلطاني، حازمي، ايدمري، سنيني، بردي، ملوح، فراط النجاتي (البخاتي) وجلاجل القلوع. ونلاحظ أن بعض الأصناف تحمل أسماء أمكنة وبعضها أسماء أفراد، انظر: نزهة الأنام، ص 187-192. حول مشمش دمشق، انظر: حبيب الزيات (ت 1954م)، ((مشمش دمشق))، الخزانة الشرقية، ج2، بيروت، 1937، أُعيد تصويرها، طرابلس، لبنان ، 1999م، ص 107- 111 . ) |
| 2 | آقجتان | 2 | عن حمل التفاح (يذكر البدري الأصناف التالية من تفاح دمشق: سكري، عسلي ،فتحي ،صيني،شتوي،بلدي، صيفي، قاسمي، فاطمي، قحايي، فضي، حديثي، جناني، حرستاني، لبناني، حلواني، دهشاوي، اخلاطي، بربري، نبطي، ماوردي، بطيخي، ومجهول، نزهة الأيام ، ص 201 – 206 .) |
| 3 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل التفاح الشتوي |
| 4 | أربع آقجات | 4 | عن حمل الكراس (الكرز) |
| 5 | آقجتان | 2 | عن حمل الإجاص (يذكر البدري أن من محاسن الشام الأجاص ويسميها بعض أهالي الشام ((الخوخ)) وهو أصناف ((صيفي، زجاجي، قبرصي، أسود، عين البقر، خوخ الدب، خوخ الطعام، أغبر،شقير، حايكي، برقوق، مجهول، بزرة وله نواة أبيض، صغير دون نوار، الكمثري)) ويضيف أن كل هذه الأصناف بأرض المزة وأرض اللوان، نزهة الأنام ، ص 210 – 212 . ) |
| 6 | آقجتان | 2 | عن حمل الأنجاص الصيفي |
| 7 | ثلاث آقجات | 3 | عن حمل العنب ( كان هناك خان للعنب في الصالحية وآخر بسوق باب السريجة. انظر: جمال الدين يوسف بن عبد الهادي (ت 909هـ/1503م)، كتاب الإعانات على معرفة الخانات، حققه حبيب الزيات، المشرق، م36، (1938م)، أُعيد تصويره ونُشر مع دراسات أخرى لحبيب الزيات باسم ((الخزانة الشرقية))، طرابلس، ط2، 1999 م، ص 52 – 53 . ) الوارد من الخارج |
| 8 | آقجتان | 2 | عن حمل التين الديفور(حول التين انظر الصفحة (9)، الهامش (1) أعلاه، وهو الموسم المبكر للتين الخضاري حيث يعمد أصحاب البساتين إلى دهن راس ((النونة)) لحبة التين بالزيت للإيضاح المبكر .)، وتؤخذ آقجتان إذا ثمّ بيعه بالطبلية ( الطبلية: يعرفها السيد مرتضى الزبيدي على أنها ((سلة الطعام وهو كالخوان ويُقال الطبلية والجمع الطبالي))، تاج العروس، ج29، (1997م)، ص 361- 362، وما زال المصطلح مستخدمًا، ولكن يكون على شكل صفيح من المعدن المقوى أومن الخشب على شكل طاولة صغيرة، ويشير إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393هـ/ 1002م) إلى الجونة والخايبة والحفنة وهذه المكاييل ما زالت أسماؤها رائجة إلى اليوم. انظر: الصحاح،6ج، تحقيق أحمد عبد القادر عطار، ط2، دار المعلم للملايين، بيروت، 1979م، ج5، ص2096،2102 .)،وتؤخذ آقجة واحدة إذا بيع بالسلة (السلة : شبه الجونة المطبقة، ويشيرالبعض إلى أنها غير عربية، السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج29، (1997م)، ص 212، 215. ) |
| 9 | آقجتان | 2 | عن حمل الرمان |
| 10 | آقجتان | 2 | عن حمل البطيخ (يذكر البدري أن من محاسن الشام قرية داريّا وإليها يُنسب البطيخ الداراني. ويذكر أصناف البطيخ الاخضر بدمشق، وهي: داواني، مرجي (نسبةً إلى المرج)، دومي (نسبةً إلى قرية دوما)، حبشي، قبلي، عواميدي وهو المسمى بالنومس، نزهة الأنام ، ص 220 - 223. ) والشمام ( يُسميه البدري البطيخ الأصفر ومن أهم أصنافه البطيخ الضميري الأصفر ومن أصناف الشمام: السمرقندي والسلطاني والشمام . ويضيف أن البطيخ المخطط الأصفر هو المسمى بالشام بالشمام، نزهة الأنام ، ص 259 .) |
| 11 | آقجة واحدة | 1 | عن حمل الخيار البلدي |
| 12 | أربع آقجات | 4 | عن حمل الدراق(يذكر البدري أن من محاسن الشام الدارقن وهو أصنافٌ بدمشق وأنه يُسمى في القاهرة باسم الخوخ. ومن أصنافه بدمشق: خكواجكي، رصاصي، حمصي، نيرباني، لوزي، لزيق، لقيس، كلايي، صالحي، ختمي، مظفري، مسافري، صوري، زهري، لحم الجمل، مجهول، نزهة الأنام، ص 206 – 210. تجدر الإشارة هنا إلى أشجار الفواكه في دمشق التي يوردها القلقشندي، وهي: التين، العنب، الرمان، القراصيا، البرقوق، المشمش، الخوخ وهو المسمى بالدراقن، التوت، الفيرصاد، ويكثر بها التفاح والكمثري والسفرجل والجوز والبندق والأجاص والعُناب ووالزعرور والزيتون، والأترج والليمون والكبّاد والنارنج والموز))، صبح، ج4، ص87. حول دراقن الشام، انظر: حبيب الزيات، ((دراقن الشام ))، الخزانة الشرقية ،ج3، ط2، (1999م)، ص 146 - 148 . ) |
| 13 | أربع آقجات | 4 | عن حمل الفستق والبندق الأخضر غير الناشف |
| 14 | آقجة واحدة | 1 | عن كل قفة عقابية (؟) |
| 15 | أربع آقجات | 4 | عن حمل الانجاص الشتوي |
| 16 | آقجتان | 2 | عن حمل العنب ( يذكر البدري أن من محاسن دمشق قرية يلدا(يلداه، يلدان) جنوب شرقي قرية عربيل ((وما بينهما من القرى الجميع برسم زراعة كروم العنب وعرائشه))، والعنب صنوفٌ بدمشق، فمنها: البدري، خناصري، عاصمي، زيني، بيتموني، قناديلي، إفرنجي، مكاحلي، بيض الحمام، حلواني، بوارشي، جبلي، قصيف، أبزاز الكلبة، قشلميش، كوتاني، عبيدي، شحماني، جوزاني، دراقني، مخ العصفور، عرايشي، رومي، شبيهي، نيطاني، عصيري، رناطي، ورق الطير، سماقي، حرصي، مجزع، شعراوي، دربلي، قاري، علوي، عينوني، مورق، مشعر، مسمط، مرصص، محضر، مقوس، حمادي، تفاحي، رهباني، زردي، مبرد، مخصل، مغاربي، شحمة القرط، نزهة الأنام، ص 223-224 وما بعدها. حول يلدا، انظر، ص 61 من هذه الدراسة . ) الوارد من مدينة دمشق |
| 17 | أربع آقجات | 4 | عن حمل المشمش الناشف |
| 18 | آقجتان | 2 | عن كل شوال من المشمش الناشف |
| 19 | آقجة واحدة | 1 | عن كل ألف حبة جوز (حدّد القانون نامة مقدار الرسم الذي يُؤخذ على أشجار الجوز على النحو التالي: ((تُؤخذ آقجتان خراجًا عن كل شجرة جوز على أن تكون ناضجة وكاملة النمو وتُؤخذ آقجة واحدة عن كل شجرة جوز صغيرة وغير مكتملة النضوج)) . ويشير البدري إلى الجوز من قرية منين المعروف ((برقّة قشره وبياض قلبه))، وهو صنوف: مغاربي، فرك، منيني، جبلي، بستاني، والجدير بالذكر أن الصباغين كانوا يستخدمون قشره، نزهة الأنام، ص345 – 347 . ) |
| 20 | نصف آقجة | 0,5 | عن كل زنبيل (سلّ) لزهر النارنج والورد (يورد البدري أشعار بعض الشعراء في النارنج، نزهة الأنام، ص 335 – 339. ويذكر من محاسن دمشق ((الورد)) وهوجنس تحته ستة أنواع بدمشق خلا الأسود))، منه الجوري، ويذكر أن قرية الزبداني ((هي قلعة الورد يستخرجون بها ماورد القاهرة المحروسة ومكة المشرفة وغيرهما من البلاد))، ومن محاسن الشام الورد النسريني وهو نوار أبيض وأصله بري …. ويعرش كالكرم وله أغصان برؤوسها الورد كل غصن فيه مائة وردة وأكثر)). انظر: نزهة الأنام، ص 104-121. وعلى ذكر ماء الورد وما يصدر للقاهرة ولمكّة المكرّمة وذلك على ضوء كثرة الورود، فإن شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري المعروف باسم شيخ الربوة (ت 727هـ/ 1326م) يصف لنا طريقة استخراج ماء الورد في دمشق، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، تحقيق أ .ف. مهرن، تصوير بغداد،1928م، ص 195 – 198 .) |
نلاحظ أن هذه القائمة تكمل قائمة دار القبان، حيث ترد الإشارة إلى الفواكه المجففة، وورد مصطلح ((جوال)) ( كيس ) و((قفة))18 و((زنبيل)) (سلّ)، بالإضافة إلى استخدام مصطلح ((حمل)) ومصطلح ((طبلية )).
وتكتمل الصورة أكثر إذا ما تفحصّنا العناوين الواردة تحت اسم ((عوائد دار الخضر))19 حيث شملت ما يلي :
| 1 | آقجة واحدة | 1 | عن كل كيس جوال من البصل(يذكر البدري أن بالشام البصل، ويُعدد مزاياه الطبية، نزهة الأنام، ص 295. ) والباذنجان(يذكر البدري عن الشام: ((ومن خصوصياتها الباذنجان الأحمر الرفيع والأبيض القليل البزر الرقيق القشر))، نزهة الأنام ، ص 285 ) أو اللوبيا ( يذكرها البدري في الشام، نزهة الأنام ، ص 303 . ) أو القرنبيط (يذكرها البدري باسم القنبيط ((ويُدعى عند المصريين بالكرنب))، ويذكر خصائصه الطبية، نزهة الأنام ، ص 283 – 284 . ) مع رطل طعمة |
| 2 | آقجتان | 2 | عن كل كيس عجور (العجور في الاستخدام المحلي الدارج هو الفقوس وهو نوع من القثائيات ولا تذكره كتب الفلاحة والزراعة، ويذهب الشيخ عبد الله البستاني (ت 1930م) على أنه ((ضرب من البطيخ))، البستان (معجم لغوي)، 2ج، المطبعة الأمريكانية، بيروت،1930م، ج2، ص 1522. ) |
| 3 | آقجة واحدة | 1 | عن حمل الرمان الحامض والحصرم (الحصرم ثمر الكرم قبل الحلاوة، نزهة الأنام، ص 225 -226 . ) |
| 4 | آقجة واحدة | 1 | تؤخذ كل يوم جمعة من باعة الهوج (الجزر) (الجزر: يذكر البدري ((من خضار دمشق الجزر)) ويأتي بنقولات حول خصائصه الطبية، نزهة الأنام، ص 290 .) والهليون |
ويشير القانون نامة إلى أن العادة قد جرت ببيع الزيت والفحم بخان الخليلي20 بدمشق. والملحوظ أن دفاتر الطابو لا تأتي على أسماء الأشجار المثمرة ولا تذكر أنواع الخضروات الطازجة أو الناشفة التي ترد هنا في الدفتر ضمن إطار ((المقاطعات))، فيتوفر بذلك للباحث كشف دقيق بأسماء الثمار والخضروات التي كانت تُزرع في بلاد الشام، وما يُعصر منها من زيت ودبس أو مجففات مثل الزبيب والمشمش والفستق والبندق الجاف ... الخ. والتي كانت تُباع في أسواق دمشق .
3- محصول بازار (سوق) اسب (حصان / خيول) وجمل واستر (البغل) وحمار وساير الدواب في السنة (60000) آقجة
جاءت الإشارة في قانون نامة بلاد الشام على تطبيق العادة القديمة الموروثة من زمن السلطان قايتباي في جمع الرسوم في سوق الدواب، ويُفصِّل القانون نامة ذلك ليُبيِّن لنا مقدار الرسوم التي يجبيها الأمناء عند بيع الحيوانات التالية :
| 1 | ست آقجات | 6 | عند بيع الحصان، ويكون المبلغ مناصفةً بين البائع والشاري |
| 2 | ثماني آقجات | 8 | عند بيع الجمل، ويكون مبلغ مناصفةً بين البائع والشاري |
| 3 | أربع آقجات | 4 | عند بيع الحمار، ويكون المبلغ مناصفةً بين البائع والشاري |
| 4 | ثماني آقجات | 8 | عند بيع الجاموس* أو الثور، ويكون المبلغ مناصفةً بين البائع والشاري * يشير القانون نامة للجواميس أنه تقرر ((فرض ست عثمانيات / آقجات على الجاموس الحلوب والسمين)) (مادة 75). ويشير النص إلى أنه في بعض بلاد العرب كان يُؤخذ اثنتا عشرة آقجة، وفي بعض الأماكن لا يُستوفى أي مبلغ، لذا وحدت جميع بلاد العرب كما أشير له أعلاه. أما فيما يتعلق بالأسواق، انظر:يوسف بن عبد الهادي، نزهة الرفاق، ص127. ولقد عني مؤرخو مدينة دمشق يذكر أسواقها فهذا عز الدين بن شداد (ت 684هـ/1285م) يورد أسماء الأسواق التالية: سوق علي في دمشق، سوق الصرف، السوق الكبير، سوق البزوريين، سوق الجلاديين، سوق القطر، سوق أم حكيم (العلبيين)، سوق الأحد،سوق الغزل العتيق، سوق الدواب خارج المدينة، الأعلاف الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تاريخ لبنان وفلسطين والأردن، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، دمشق، 1962م، ص20،21،27-30. ويذكر شمس الدين بن طولون (ت 953هـ/1546م) أيضًا أسماء أسواق في دمشق، منها: سوق بيع العقيق وسوق حكر السماق وسوق ساروجا وسوق جسر باب الحديد وسوق باب البريد وسوق باب الشاغور وقيسارية القواسين لبيع الحرير قبالة الجامع الأموي وسوق الذراع لبيع القماش. كما وأن نجم الدين الغزي (ت 1061هـ/1650م) يشير أيضًا إلى سوق الرصيف بالقرب من الجامع الأموي وإلى سوق الحياكين وسوق القاضي وسوق الخيل، انظر: ابن طولون، أعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد دهمان، وزارة الثقافة، دمشق، 1964م، ص7، 59، 61، (2 - مقالات) 101، 126،150،164،174،186؛ نجم الدين الغزي (ت 1061هـ/ 1650 – 1651م، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، 3ج، تحقيق جبرائيل جبور، ط2، دار الآفاق، بيروت، 1979م، ج1، ص 111، 271 ، 279 ، 282 ، ج 3، 158 ، 215 . |
وتدلّ قيمة المبلغ المجموع (60,000) آقجة على مدى حجم التبادل في سوق الخيل والدواب. والجدير بالذكر أنه لا ترد إشارة هنا إلى بيع الأغنام والماعز والمواشي في هذا السوق، حيث كان لهاسوق خاص بها. ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى ما لي: سوق الخيل تحت القلعة بكرة كل يوم، سوق الحمير تحت القلعة بكرة كل يوم، سوق البقر يوم الجمعة تحت القلعة وسوق الجمال يوم الجمعة تحت القلعة 21. وقبل ذلك يشير القلقشندي إلى نظرالأسواق في دمشق: ((وموضوعها التحدث على سوق الرقيق والخيل ونحوها وولايتها عن النائب))22.
4- محصول بازار (سوق) الأسارى (الأسرى) في نفس الشام في السنة (30000) آقجة
يجدر بنا التنبيه هنا إلى أن كلمة ((أسرى)) قد لا تعني دائمًا (أسير الحرب) بمقدار ما تعني الرقيق والعبيد من الذكور والإناث، البيض أو السمر، الذين كان يجلبهم تجّار النخاسة، وعلى ضوء إشارة القلقشندي أعلاه كان هناك سوق خاص بالرقيق في دمشق، وكانت هناك ((عادة)) تُؤخذ باسم ((عادة سوق الأسرى والعبيد)) مقدارها (30) ثلاثون آقجة تُجبى عند بيع العبد أو الجارية سمراء أو بيضاء، وتؤخذ من البائع فقط ويشار لهذا على أنها ((عادة من قديم الزمان)). ويأتي يوسف بن عبد الهادي على ذكر النخاسين وبياعي
الرقيق، ويذكر أن ((الحسبة عليهم في الصدق والأمانة وعدم التدليس والوطء قبل الاستبراء))23. ويذكر في رسالته ((نزهة الرفاق)) (29) سوق الجواري والرقيق يباعون بدمشق في التكّة في يوم الاثنين والخميس .
5- محصول باج بازار (سوق) أغنام (الأغنام) (220000) آقجة/سنويًا
ويشير القانون نامة إلى أن مقدار الرسوم على الرأس عند البيع آقجتان تؤخذان من البائع، كما جرت العادة على الوجه المشروح منذ القديم . وكانت تدرّ دخلاً عاليا مقداره (220000) آقجة سنويًا مما يدلّ على حجم البيع في العام الواحد إذ كان في إطار (110000) رأس سنويًا. وعلى الأغلب أن سوق الغنم قد استمر، فقد ذكره مؤرّخ دمشق محمد خليل المرادي (ت 1206 هـ/ 1791 ــــ 1792 م )24 .
6- محصول باشخانه (دكان رؤوس الماعز والأغنام) في نفس الشام (40000) آقجة / سنويًا
كان من عادة الروّاسين الذين يبيعون رؤوس المواشي من الماعز والأغنام بعد سلخها، وفي بعض الأحيان طبخها وتقديمها مع الشوربة، شراء عشرة رؤوس بآقجتين وبيعها بخمس وذلك في أيام الصيف. أما في موسم الشتاء فيشترون العشرة رؤوس بخمس آقجات ويبيعونها مع أقدامها بثمانية .
ويشير البدري عند تناوله للربوة أن الصيادين كانوا يصطادون السمك والقلاّيين يقلونه، ((ويذبح فيها كل يوم خمسة عشر رأسًا من الغنم خلاف ما يجيئها من المدينة، وبها عشرة شرايحية)) شغلهم ((الطبخ والغرف في الزبادي ))25.
7- محصول كمرك26 (الكمرك، الجمرك) في نفس الشام في السنة (230000) آقجة
يُفصِّل قانون نامة لواء الشام عوائد الجمرك على البضائع سواء الواردة إلى قصبة دمشق الشام أو الصادرة عنها . ويُشار هنا بشكل خاص إلى مجموعة التوابل والسلع التي ترد مع التجار المرافقين لقافلة الحج الشريف عند عودتها من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى دمشق. فإذا ما كانت عودتها عن طريق غزة، كانت الدولة تجبي الكمرك (الجمرك) بخان يونس27 . أما إذا كانت العودة عن طريق حوران، فكان الجمرك يجمع في بلدة الكسوة 28 جنوبي دمشق. وكان الأمناء يتقاضون سبع ((ذهبات)) عن كل حمل بعير من البهار29 أو الأقمشة بالإضافة إلى مبلغ نصف ذهبة يُجمع كــ ((رسم مباشرية)) ويتم ضبط الوارد لحساب الميري وهو هنا الخاص السلطاني. وكان هذا الباج على البهار والأقمشة وغيرها، الواردة مع قافلة الحج الشريف، توفر دخلاً للخاص السلطاني مقداره (600000) آقجة سنويًا. وعند بيع أي من هذه السلع للتاجر الإفرنجي، يأخذ الأمناء عشر ذهبات من البائع وتسع ذهبات أيضًا من التاجر الإفرنجي، هذا بالإضافة إلى ذهبتين عن كل ما قيمته مائة ذهبة يدفعها التاجر الإفرنجي تحت رسم ((تخزين)) .
وعند نقل البضاعة إلى ميناء بيروت، يدفع التاجر الإفرنجي سبع آقجات وثلث آقجة عن كل مائة تُعرف بحق (القبلة ؟ ربما مثله ؟) ((حسب الاصطلاح المعتاد))30.
وعند استيراد بعض المواد من بلاد الفرنجة كالجوخ والأطلس والكمخا والمرجان والقصدير والنحاس وما شابهها من المواد، يتم تقدير قيمتها وتجبي الدولة ثلاث أشرفيات31 (عملة السلطان الأشرف أبي النصر سيف الدين برسباي 825 هـــ/ 1422م ــ 841 هـ/ 1438م)عن كل مائة أشرفية. أما الخردوات كالمواد الزجاجية والخيوط والكرباس32 والورق، فيؤخذ رسم ((حق قبله / مثله )) مقداره أربع آقجات عن كل حمل، وعند تصدير الزبيب33 من العنب الأحمر إلى بلاد الفرنجة، تأخذ الدولة اثنتي عشرة آقجة عن كل صندوق (علبة) ويساوي الصندوقان (العلبتان) منهما خمسين منّا .
8- محصول دلاّليّه34 (السمسارية)35 الجوانية في نفس الشام بين المسلمين والنصارى (الفرنجة)36 في الكمرك في السنة (5500) آقجة
يوضّوح قانون نامة لواء الشام أنه عند ورود المواد الواردة أدناه مع قافلة الحج الشريف، وهي: الزنجبيل والنيل واللوك والصمغ الهندي، يؤخذ من المشتري والبائع مبلغ خمس آقجات عن كل ما قيمته ألف آقجة. ويؤخذ العُشر من صاحب الزنكار وهو كحل العين، والصبر والكافور وما شابهها من البضائع . أما البضائع التي يوردها الفرنجة، وعلى الأغلب أشار إليهم باسم (النصارى)، كالأطلس والكمخا والقديفة والكهرباء37 ومسابح المرجان وما شابهها فتؤخذ عشرون آقجة عن كل ما قيمته ألف آقجة، كذلك تؤخذ عشر أشرفيات عن كل صندوق من المرجان. وكان ناظر الجيش في السابق، أي في العهد المملوكي، يأخذ نصف حاصل الدلالية، ويأخذ الدلاّلون النصف الآخر، أما في الوقت الحالي (سنة إعداد الدفتر) فيخصص ثلثا الدخل للميري أي للسلطان، ويأخذ الدلاّلون الثلث الثالث، ويذكر القانون أن المترجمين 38 يسمون ذلك الدلالية الجوانية. ونلاحظ هنا أن أكثر من عملة ذهبية وفضية مملوكية وعثمانية كانت تستخدم في سوق الدلالية الجوانية .
9- محصول الدلالية البرانية في سوق البزورية 39 في السنة (24000) آقجة
تؤخذ خمس آقجات بالمائة من قيمة كل مادة أو سلعة تباع في سوق البزورية .ولا توفّر المصادر المتاحة لنا مواد واسعة عمن كان يقوم بالسمسارية والدلالية، وتجيء المعلومات على شكل نتف منها مثلاً: أن والد العالم علي بن إسماعيل الشافعي (ت979هـ/1571م) كان سمسارًا في القماش بسوق جقمق40 .
10- محصول مشدية41 الأنهار مع خراج مفصول (أي مقطوع) في السنة (68000) آقجة
كانت العادة في زمن المماليك التي يُشار إليها بـ ((العادة القديمة )) أن رسمًا يُجمع من أصحاب البساتين التي تُروى بمياه أنهار دمشق السبعة فيتم صيانة مجاريها 42، وترمّم الأقنية فيها والتي كان عددها يزيد على مائة وعشرين قناة، ويتمّ تنظيف المجاري وتُزال الأعشاب والأوساخ المتجمعة، وبخاصة في قلبيط، لتيسير تدفّق المياه وما يزيد على هذه النفقات فيضبط لحساب الخزائن السلطانية. ويشير القانون نامة إلى تعبير ((عدان)) الذي ما زال مستخدمًا في محيط دمشق إلى يومنا هذا، ويُطلق هذا المصطلح، كما يذكر القانون نامة في بعض الأماكن ((على مساحة الأرض التي يسقيها النهر الذي يتم سدّ مجراه ويُسمح له بالمسيل من فتحة وذلك في غضون يوم وليلة )). وكانت الأنهار التالية تجري في مدينة دمشق أو في محيطها لتزويد المدينة بالمياه ولتنظيف المكاره، مثل نهر قليط، ولري قرى الغوطة وبعض قرى المرج : نهر بردي، يزيد، قناة المزة، الديراني، تورى [تورا]، قنوات، بانياس، العقرباني، الداعياني والمليحي، وهناك أقنية خاصة تنقل المياه من الانهار إلى القرى43.
11- محصول باج بازار (سوق)44 الغلة في نفس شام في السنة (40000) آقجة
يشير القانون نامة على ((العادة القديمة)) لسوق الغلة والخلاصة أنه تؤخذ آقجتان من المشتري عند بيع كل غرارة45 قمح ومثل هذا المبلغ يُجبي عن كل غرارة من الشعير والغلال الأخرى، ويؤكد القانون نامة أنه يمنع بيع الحبوب والغلال خارج سوق الغلال. ويشير ابن عبد الهادي في السنة 883 هــ/ 1478 م إلى سوق الحبوب بباب الجابية وإلى سوق القمح وهو ((عرصات بميدان الحصى وما والاه )). ويشير أيضا إلى سوق الدقيق بباب الجابية))46.
12- محصول بيت الحشيش وغيره في نفس الشام في السنة (36000) آقجة
لا يشير القانون نامة إلى بيت الحشيش في دمشق ولكن في أحداث عام 927هـ/ 1521م، يذكر شمس الدين محمد بن طولون ( ت 953 هـ/ 1546م) أن نائب السلطان سليم الأول في دمشق جان بردي الغزالي (ت صفر 927هـ/ شباط 1521م)، وأثناء حركة عصيانه ضد العثمانيين، منع استخدام الخمر والحشيش وكذلك الرسوم التي ((نظمها)) العثمانيون على هذين الصنفين47 .
13- محصول دار الضرب: الذهب والفضة والفلوس في نفس الشام في السنة (000,001) آقجة
كانت دار الضرب تقع في قلعة مدينة دمشق48، ولا يشير قانون نامة الشام إلى دار الضرب، ولكن دفاتر أخرى، بالإضافة إلى دفاتر الطابو، تشير إلى هذه الدار وأنه في عام 970 هــ/ 1562م قد لزمت إلى الخواجا عبيد ومحمد بن مزيد لمدة أربع سنوات بمبلغ إجمالي قدره (287000) آقجة أي بمقدار (71750) آقجة سنويًا، ونلاحظ من خلال هذا الدفتر، وبعد سبع سنوات، أن المبلغ قد ارتفع إلى مائة ألف آقجة سنويا، وكان رأس مال دار ضرب الشام يوزع على أهل الأسواق. وبالإضافة إلى الذهب والفضة، كان النحاس يستخدم في صك الفلوس التي يُشار إليها أحيانًا باسم ((ما نقر (نحاس))). ويُشار في بعض الأحيان إلى ((الزغل )) في العملة وأن عملية التنقية للحصول على صك (سكّ) بادشاهي وعملة ((حسنة)) فإن دار الضرب كانت تأخذ ((حق النار )) أي قيمة المعدن الذي يضيع لدى إذابة الذهب والفضة وما سواها. وأصبحت دمشق وحلب وحميد من ديار بكر من مراكز ضرب العملة
كالآقجة)) والدرهم الفضي بالإضافة إلى السلطانية الذهبية. وكانت الدولة تعتمد موظفين ((أمناء)) مختصين للإشراف على صك العملة وحفظ وزنها وحمايتها من الزغل والتزوير. كما كانت دار الضرب التي تخضع للتلزيم تقوم بالإشراف على العيارات ووحدات الوزن في أسواق الذهب والفضة وبقية الأسواق. كما أنه لم يكن يسمح للأفراد أو الجماعات من التجار والأثرياء بصك القطع الذهبية أو الفضية على مسؤولياتهم، ويذكر البدري عن دمشق: ((وفيها تعمل صناعة الذهب المسبوك والمضروب والمجرور والمرفوع والمحدود والمرصوع49، بل عليهم تقديمها إلى دار الضرب التي كانت تأخذ خُمس القيمة50 مقابل عملية التقطيع والسك .
14- محصول بيت المال العام الذي يقل عن عشرة آلاف آقجة سنويًا باستثناء الخاص [السلطاني] ومال الغائب ومال المفقود في نفس الشام (100000) آقجة سنويًا
كان المبلغ الذي يقل عن عشرة آلاف آقجة يدفع حسب ما هو محدد في الدفتر وغالبًا لأمير السنجق أو للعامل أو الملتزم في اللواء. أما المبلغ الذي يزيد على عشرة آلاف آقجة سنويًا، والمتأتي من ريع أرض الميري والرسوم المُجباة على العبيد الآبقين أو القطعان الضالة، بالإضافة إلى تركات خدام السلطان الذين لا وارث لهم، فإنها كانت تعتبر ملك بيت المال51. وكان هذا استمرارًا للإجراءات المتبعة في موضوع المواريث الحشرية52.
15- محصول مقاطعه فايده البلس53 في نفس شام في السنة (680000) آقجة
وهو مجموع الرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة على ((رماد الاشنان ))54 بعد حرقه ويُعرف رماده باسم ((القلي)) وكانت الأعشاب البرية التي تنمو خارج دمشق في ناحية المرج55 وجبة العسّال56 والقلمون57 تُحرق و يُنقل رمادها بإشراف مسؤولي الدولة إلى دمشق و يُباع لصالح الميري أو للخاص السلطاني ويقبض أصحاب الأرض ثماني آقجات عن كل قنطار58 أجرة للأرض وثماني آقجات أخرى أجرة نقل عن كل قنطار، يذكر القانون نامة أسماء ست قرى حدد القانون مقدار ما تقدمه كل قرية منها من القلي كحد أدنى سنويًا، وهي :
قرية ضمير59، تقدم ألف قنطار قلي على الأقل وألفي قنطار سنويا على الأكثر. ويكون الحساب فيما يتعلق بأجرة الأرض و كراء النقل كما ذُكر أعلاه .
قرية جرود 60، تلتزم بخمسمائة قنطار قلي وأن تكون أجرة الأرض لقاء ذلك (1200) آقجة سنويًا، لكن القانون نامة لم يذكر شيئًا عن أجرة النقل.
قرية روحية61 (رحبية) (؟)، يقدم أهلها ثلاثمائة قنطار (300) قلي ويُدفع لهم ألف آقجة أجرة للأرض.
قرية معيصرة62، يقدم أهلها ألف قنطار قلي ويقبضون (1200) آقجة أيجارًا للأرض .
قرية معظمية63، يقدم أهلها (500) قنطار قلي و يأخذون إيجارًا للأرض على شكل مقطوع مبلغ (1200) آقجة .
قرية قطيفة64 ، ويقدم أهلها (600) قنطار ويقبضون أجرة الأرض (1200) آقجة سنويًا .
ويشير القانون إلى وجود قطعة أرض بجوار جامع قرية عذرا65 وقفًا على الجامع المذكور ويستغلها أهالي القرية المذكورة مقابل (200) آقجة سنويًا و قفًا للجامع المذكور. ويبدو أن أهالي عذرا كانوا يجلبون القلي من خارج القرية ويبيعونه على أنه من إنتاج أرض وقف الجامع المُشار إليها أعلاه فيحذر القانون المسؤولين وأهالي القرية من مثل هذا التلاعب، ويحذر القانون أيضًا أهالي بقية قرى نواحي دمشق من حرق وبيع أي قلي خارج ((دار الطعمة)) 66 بدمشق، حيث يُباع ثلثه للإفرنج وثلث لعمال الميري والثلث الأخير للمصابن والمصابغ وللقاصرين ولا يباع للتجار ولا للمحتكرين. ويشير القانون بالقول بأن ((قوانينهم))، أي قوانين المماليك، كانت تقضي بمصادرة ما يُباع خارج ((دار الطعمة )) ويقرر القانون الحالي مثل ذلك أيضًا .
16- محصول رسوم تذاكر براءات التيماريين (أصحاب الإقطاعات) بولاية دمشق الشام في السنة (32000) آقجة
يشير الدفتر الذي بين أيدينا إلى وجود صنفين من أصحاب التيمارات بولاية دمشق الشام، الصنف الأول، وعددهم (155) تيماريًا، كانوا من أصحاب الخاص وهي الإقطاعات ذات الريع العالي، وكان علي كل مستفيد منهم أن يحصل على براءة67 سلطانية بذلك مقابل رسم معين بقيمة 206,5 آقجة
سنويًا للفرد الواحد يدفعه للخاص السلطاني، وكان مجموع دخل هؤلاء (1233000) آقجة سنويًا، أي بمعدل (7955) آقجة سنويًا لصاحب الخاص الواحد من هذا الصنف.
أما النصف الثاني من أصحاب التيمارات وهم من ((صغار التيماريين ))، وكان عددهم (211) نفرًا، فكانوا يحصلون على ((تذاكرهم)) من الوالي ((مير ميران)) مقابل رسم سنوي يدفعونه لحساب الوالي بمعدل (1, 71) آقجة سنويًا، وكان مجموع دخلهم (751000) آقجة سنويًا، أي بمعدل (3559) آقجة للفرد الواحد.
17- محصول مصبغة القطن في نفس الشام في السنة (20000) آقجة
18- محصول بويخانه (المصبغة) للأقمشة في نفس الشام في السنة (1600) آقجةصول رسوم تذاكر براءات التيماريين (أصحا
لاحظنا، عند تناولنا لمادة القلي، أن قسما منها كان يباع للقصارين ولأصحاب المصابغ، ولاحظ الباحثون من خلال استقرائهم لسجلات المحكمة الشرعية بدمشق في القرن الثامن عشر وجود عدد كبير من طوائف الحرف النسيجية بحيث بلغ عددها أربع عشرة طائفة، منها: الفتالون، القطانون، حياكو الحرير، حياكو الكتان، العقادون الدقاقون، الملقيون ... الخ68.
و يذكر البدري أنه كان تحت القلعة سوق للقماش المذروع وسوق قماش للمخيط أحدهما للرجال والآخر للنساء وبها سوق للفراء والعبي وغير ذلك . ويزيد على ذلك بقوله: ((ومن محاسن الشام ما يضع فيها من القماش والنسيج على تعداد نقوشه وضروبه ورسومه ومنها عمل القماش الأطلس بكلأجناسه وأنواعه)) والقماش الهرمزي والقماش الأبيض المصور للأحياء والأموات، وبها أيضا القماش السابوري بجميع ألوانه وحسن لمعانه69.
19- محصول حمام الغزالي في محلة الطواقية (الطواقيين) في السنة (80000) آقجة
20- محصول شيخ الحمامين وعريف قصر ميل مع مشاطيات وطوائف في السنة (24000) آقجة
21- حماية حمام الورد بقاسيون – مرفوعة
يُلاحظ كثرة الحمامات في قضية دمشق وفي محيطها، فلقد عدّدها الحسن بن أحمد بن زفر الأربعي الشافعي (ت 726هـــ/ 1327 – 1326م) حين وروده لدمشق، فوجد أربعة وسبعين حمامًا داخلها وأربعة وثلاثين حمامًا في خارجها. أما عدد الحمّامات في الحواضر المتّصلة بالمدينة فكانت تسعة وعشرين حماماً، فيكون مجموع ما بداخل المدينة وما بخارجها من حمامات
(137) مائة وسبعة وثلاثين حمامًا70. ولا توضح المصادر المملوكية القاعدة التي اتبعها المماليك في جباية الرسوم على الحمامات، فلا يذكر لنا الدفتر هنا أسماء كل هذه الحمامات71 ، بل اكتفى بذكر حمام الغزالي، وأنه بمحلة الطواقين، وأنه كان يدر دخلاً سنويًا لحساب السلطان مقداره ثمانون ألف آقجة، وهذا مبلغٌ ضخمٌ جدًا. ويُشار هنا إلى شيخ طائفة الحمامين ويبدو أنه كان يدفع رسمًا للدولة على الأغلب، وكان يجمعه من أصحاب الحمامات وربما العاملين فيها، و الذي يهمنا هنا أن الدولة كانت تعتمد عريفًا لجمع الرماد المتحصل من حرق جذوع الأشجار والأعشاب وروث الدواب المستخدم في تدفئة الحمامات وتسخينها، لأن هذا الرماد المعروف باسم ((قصرميل)) كان يستخدم في صناعة البناء، هذا بجانب جمع رسوم على الممشطين و((الماشطات)) الذين كانوا يقومون بمشط وغسل مرتادي الحمامات ويُعرفون باسم البلان أو ((البلانة))، وكان مجموع الحاصل السنوي (24000) آقجة، والغالب أن هذه الخدمة كانت تُلَزَّم، والجدير بالذكر أن هناك رسمًا للحماية يُؤخذ على حمام الورد بجبل قاسيون وأن هذا الرسم كان مُحدثًا وضعته زوجة والي الشام المملوكي السابق سيباي72 ، والمعلوم أن الحمامين في دمشق فيالقرن الثامن عشر نظموا أنفسهم في طائفة خاصة بهم ولها شيخ ورتب كالمعلم والناطور والريِّس المكيس والتبع الذي يقوم باستقبال المستحمين، أما السيدات، فوُجدت المرأة الحماميّة والناطورة والأسطة مهمتها التكييس والتفريك والبلانة، ومهمتها التدليك، والزبال والقميمي والشاوي، وهو المسؤول عن تسخين المياه 73 .
24- محصول دواليب الحرير في نفس الشام في السنة (2400) آقجة على كل باب [أي دولاب] (60) آقجة سنويًا
25- محصول ميزان الحرير في نفس الشام (120000) آقجة
من المعروف أن زراعة شجرة التوت74 وتربية دودة. القز قد ازدهرت في بلاد الشام نظرا لكثرة طلب التجار الأوربيين من فرنسيين وإنجليز وغيرهم على مادة الحرير التي أصبحت تشكل موسما رئيسا من مواسم بلاد الشام. ويشير القانون نامة أن النصف الثاني من رسم الديموس75 كان يؤخذ في بعض الأماكن في موسم الحرير. ويشار في قانون جمارك بيروت وصيدا وصور وعكا ويافا بولاية عند ذكر التجارة مع الخارج: ((تؤخذ ثلاث آقجات ونصف عن الحرير الوارد من دمشق بلا ختم إذا ما تم بيعه بالميناء ولا يؤخذ عنه إذا ورد مختوما)) (مادة 65)، و (( يؤخذ على كل بالة حرير ترد من الخارج مثل حلب خمس وستون آقجة)) ( مادة 69) .
وينص القانون نامة أيضا أنه : ((تؤخذ أربع آقجات عن كل رطل مناصفة ما بين الشاري والبائع وأن كمية المبلغ الذي يتم تلزيمه يدل على حجم تجارة الحرير التي تمر من خلال ميزان الحرير)). وقبل ذلك أشار البدري إلى صناعات دمشق قائلا: ((وفيها صناعة الحرير بالفتل والدواليب والسرير ))76 .
ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى ((سوق الحرير77 عند باب الجامع القبلي بياعة الحرير والخيطان والحسبة عليهم في المعاملة وعدم الغش بالردي )) ، ويضيف أيضا لذلك عن ((حاكة الحرير وهم أكثر من أربعين صنف وهؤلاء الحسبة عليهم في الجودة وعدم الغش وعدم الخلوة بالصبيان وغلق الأبواب عليهم معهم)) .
26- محصول اقسماوية في نفس الشام في السنة (24000) آقجة
الاقسماوية شراب من المثلجات الممزوجة بالزبيب المدقوق، ويشتري الزبيب من خان الخليلي، ويتم تقديمه بعد تصفيته في قدور من النحاس78 ، ويشير قانون بلاد الشام إلى خان الثلج79 الذي يقوم أهالي قرية منين، من ناحية جبة العسال، بنقل الثلج إلى هذا الخان في دمشق بالتناوب ما بين أهالي القرية.
ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى صنعتيْ ((الفقاعية والشراباتية والحسبة عليهم في النظافة وتغطية الأواني وعدم الغش والتنقيص80، ويشير كذلك إلى سوق الا قسماوية، وهم : ((مفرقون وجلهم تحت القلعة)) .
27- محصول غربتان ( ؟) غريبان (؟) (الغرباء) نفس الشام مع نواحيها في السنة (30000) آقجة
يذكر شمس الدين محمد بن طولون الصالحي (ت 953 هـ/ 1546م) في كتابه ((القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية)) عند تعداده لمساجد الصالحية مسجد زقاق الزطّيين تحت تربة السبكيين، ويشير الناشر إلى أن تربة السبكيين تقع في حارة المتاولة من جهة الشرق، وحيث أن المعنى الدقيق لـ ((غربتان)) غير واضح، وأن بعض المختصين رأوا أن المقصود بهم هم الزط، فلربما تجيء إشارة ابن طولون بهذا الخصوص موضحةً لهذا المصطلح81. ويشير دفتر طابو (T.D.474) إلى أن ((الغربتان )) كانوا يعيشون في محلة الخراب 82 .
28- عادت قود عرب أمير الشام [ لا يذكر المبلغ المالي بالآقجة أو عدد الأمهار من الخيول والجمال التي يقدمها عادة أمراء وشيوخ العشائر للحظائر السلطانية]
تشير دفاتر الطابو إلى العشائر العربية حينًا باسم (جماعت) وحينًا آخر باسم (طائفة)، ويلاحظ أن الدفاتر تحدد أماكن سُكنى هذه الجماعات والطوائف، وزيادةً على ذلك، تذكر أماكن مشاتيها ومصافيها. والملحوظ، بشكل عام، قلة عدد أفراد الجماعات العربية البدوية في لواء الشام، ونشير هنا إلى بعض الأسر العربية التي برزت في الحياة المحلية كآل الحنش في البقاع وآل مساعد الغزاوي في لواء عجلون وآل طره باي الحارثيين في مرج ابن عامر وبني عطا وعطية في لواء غزة ومن حسن الحظ أن المصادر المحلية تشير إلى مثل هذه العشائر عندما كانت تأتي على ذكر قافلة الحج الشريف عند خروجها من دمشق إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي طريق عودتها وتشير المصادر إلي درجة استعداد الدولة العثمانية لتوفير الأمن و الحماية للقافلة، وتخصيص مبالغ مالية سنوية ((الصُرّة)) لشيوخ العشائر لكسب ولائهم. وأشار الباحثون إلى وجود إمارة للعرب في بلاد الشام منذ مطلع العهد الأيوبي وأن الأمير كان يقدم عددا من الجمال غالبًا ما تحوّل إلى قافلة الحاج وعددًا من الأمهار تُرسل إلى حظائر الخيول السلطانية، ويُشار لهذه التقدمة في قائمة المقاطعات هنا باسم ((عادت قود عرب أمير الشام)) 83 .
29- محصول دكاكين سراج خانة يعرف بالغزالي باب عدد (22) في السنة (2200) آقجة
يُلاحظ أن هذا المبلغ كان شبه ثابت في خمسة دفاتر من دفاتر الطابو المتعلقة بمدينة دمشق84، والمعروف أن المساجد والجوامع والمدارس، كما هو حال المنازل، كانت تعتمد على ((الشمعدانات)) وعلى الشمع والزيت في الإضاءة، ونلاحظ أن الوثائق الوقفية تُعطي كثيرًا من التفاصيل حول هذا الموضوع85 .
30- ((جماعت)) جرجيان çerçiyan (حصير جيان) hasirciyan في ولاية الشام في السنة (2000) آقجة
يُشير يوسف بن عبد الهادي في كتاب الحسبة إلى الجرزموشية وأن ((الحسبة عليهم العمل في الإتقان وحُسن العمل))86. ويشير في رسالته ((نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق)) إلى سوق السقطيّة، وأن لهم سوقين، أحدهما في النحاسين تحت القلعة، والثاني في فضا القلعة87 . وكانت هذه الجماعة تتعاطى بيع القطع الصغيرة ((الخردة))، أما فيما إذا قُرئت الكلمة على أساس ((حسرجيان)) حصير جيان، فسيكون المقصود بها باعة الحُصُر التي كان عليها طلب كبير وبخاصة لفرش مداخل المساجد وساحاتها، وكان يوجد بدمشق، كما ذكر ابن عبد الهادي، ((سوق للحصر)) في راس سوق المدهون بدمشق88، إلا أن المصادر المملوكية، وكذلك القانون نامة لا يحدد لنا القاعدة التي كان يتم بموجبها جبي ((المحصول )) من هذه الجماعة .
31- محصول بستان السلطان في محلة القنوات89 في السنة على وجه المقطوع في عهدة حسين زعيم الشام في السنة (1200) آقجة
لاتتوافر لدينا معلومات عن هذا البستان ولكن الجدير بالإشارة أن ضمان هذا البستان كان في عهدة أحد كبار العسكريين التيماريين في دمشق حسين الملقب بـ ((زعيم شام )). ويذكر بهاء الدين بن شداد (ت 632هـ/ 1239م) أن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي (ت 589هـ/ 1193م) كان قد تمرض ودفن في داره بالبستان فأصبح البستان90 يعرف باسم ((بستان السلطان ))، وربما كان هذا هو المقصود بهذه الإشارة ((بستان السلطان )) . ويشير البدري إلى غيضة السلطان وأشجاره ((من الحور الكثيف المتشابك لانضمامه ))91.
32- محصول حدادين شمس في ولاية الشام يتنقلون من قرية لأخرى يؤخذ من كل متزوج منهم ستون آقجة ومن الأعزب منهم ثلاثون آقجة في السنة، الحاصل (6000) آقجة سنويًا
ويشير يوسف بن عبد الهادي إلى ((الحدادين)) وهم أصناف كثيرة و((الحسبة عليهم في التقوى والنّصح)) 92. وربما يندمج المبيضون الذين كانوا يتعاطون ((تبييض )) الأواني النحاسية معهم 93 . ويشير ابن عبد الهادي أنّ للحدادين سوقيين، الأول بباب الجابية والثاني بالشاغور94. كما كان هناك سوق للسكاكين95. ولا تأتي قائمة المقاطعات على ذكر المسابك التي يشير إليها القلقشندي في أكثر من موقع وأنه كان هناك وظيفة ((نظر المسابك)) وصاحبها من أرباب السيوف مسؤول عن شد المسابك من الحديد والنحاس والزجاج96.
33- محصول مقاطعة بساتين الخندق وأحكار البيوت في دائر قلعة دمشق الشام في السنة (2900) آقجة
يذكر ابن فضل الله العمري وعنه ينقل القلقشندي أن الأسوار كانت تحيط بمدينة دمشق وبقلعتها ويحيط بها جميعا خندق ((يطوف الماء منه بالقلعة وإذا دعت الحاجة إليه أطلق على جميع الخندق المحيط بالمدينة فيعمها))97 . يفهم من النص الوارد في الدفتر وجود بساتين عند خندق قلعة دمشق وأحكار للبيوت الموجودة في تلك المنطقة، وكانت تدور حول قلعة دمشق وأنها تخضع للري98. ويشير البدري إلى أن من محاسن دمشق الحواكير ((وهي كالحدائق في سفح جبل قاسيون)).
34- محصول بساتين جامع بيت لحيه (لهيه / لهيا ؟) في نفس الشام في السنة (1440) آقجة
تشير كتب الزيارات إلى أن حوّاء كانت في بيت لهيا، وهي قرية خارج مدينة دمشق، مكانها اليوم في القصّاع، وكان فيها بستان الناعمة للملك العزيز عثمان بن العادل الأيوبي99 (ت 630هـ / 1233م) . ويذكر ابن طولون في رسالته ((ضرب الحوطة على جميع الغوطة)) بيت الآلهة – بيت لهيا : ((هي حارة في دمشق شرقيها وبها جامع مبارك. وعليها بساتين وأراضي كثيرة ))100.
35- محصول نحيرة اليهود في نفس الشام في السنة (8000) آقجة
تشير كل من دفاتر طابو: ((401)) (حوالي 950هـ/ 1543م) ودفتر ((263)) ( 955هـ/ 1548م) والدفتر الذي بين أيدينا (T.D.474) (977 هـ/ 1569م) إلى وجود ملحوظ لليهود في مدينة دمشق، وتراوحت أعدادهم ما بين (512) خانة إلى (546) خانة، بالإضافة إلى مجموعة المجردين الذين تراوحت أعدادهم ما بين (12) و(56) مجردًا101 . ويُشير الدفتر الذي نحن بصدده إلى جماعة ((جماعت)) السمرا في محلة بيت اللحية وإلى يهود في محلة العناية، وتأتي الإشارة كذلك إلى اليهود الإفرنج وهم في الغالب اليهود المهاجرون من إسبانيا والسواحل الأوربية إلى بلاد الدولة العثمانية، وإلى ((جماعت يهود))، دون تحديد للهوية، وكذلك تذكر اليهود القرائين واليهود في بستان القط من قرية جوبر واليهود الصقالبة (؟) وسمح العثمانيون لليهود بذبح ما يحتاجونه من الأنعام في مسلخ خاص بهم، وكان الأمناء يأخذون مقابل ذلك رسومًا معينة باسم ((النحيرة – النهيرة)) أو ((الذبحية ))102 . أما فيما يتعلق بالمسلمين، فيُشير ابن طولون في أخبار سنة 912هـ/ 1506م إلى المسلخ بدمشق 103، ويُضيف يوسف بن عبد الهادي إلى سوق اللحّامين بباب الجابية ((وثم منهم متفرقون بكل سوق))104 . ويُضيف إلى ذلك قوله في كتاب الحسبة ((اللحّامون والحسبة عليهم في النظافة وحُسن المعاملة))105.
36- محصول دكان الطير في نفس الشام في السنة (8000) آقجة
يُشير يوسف بن عبد الهادي إلى سوق الدجّاجين عند باب الجابية وبالحدرة، ويُشير أيضًا إلى ((دكان الطير بباب الصغير، تُباع فيها الصيد من الطيور))106 في الاجام وقصبها. ويُشيرفي كتاب الحسبة إلى الصيادين ((وهم أصناف كثيرة والحسبة عليهم في التقوى وتعاطي أسباب الحلال من الذبح ونحو ذلك ))107. ويُشار إلى وجود سوق للطير منذ أيام ابن شداد (ت 684هـ/ 1286م)108. ويذكر ابن فضل الله العمري من دواجن دمشق: ((الأوز والدجاج والحمام وكثير من أنواع الطير ولا تكون الفراريج إلا بحضانة))109. وينص القانون نامة الشام على ما يلي : ((ومن جنس الصيد فكل من يصطاد [ طيرًا] ينبغي جلبه إلى دكان الطير ويبيعه هناك ويمنع بيعه في الخارج)) إلا أن القانون نامة لا يوضح لنا القاعدة المعتمدة في جمع المحصول والرسوم على كل طائر حسب صنفه .
37- محصول بساتين غراز [غراس] في الصالحية وفي قرية مِزّة ؟ (2500) آقجة سنويًا
يذكر محمد بن طولون في كتابه ((القلائد الجوهرية))، عددًا من البساتين في الصالحية110 ومن المفيد هنا الإشارة إلى ما جاء في القانون نامة من أن السكان ((أقاموا بساتين وكرومًا ووضع على كل منها مقدار من الخراج ولكن يبست فيما بعد أشجار البساتين والكروم فيها فقاموا بزراعة أماكنها فإذا أرادوا دفع الخراج الموضوع نفسه بحجة أن هذه الأماكن أصبحت ملكهم لا يقبل منهم بل أن عادتهم الجارية هي اعتبارها قسمًا حسب قانونهم ووفق الشكل الذي تكون عليه أقسام القرى)).
38- محصول احتساب نفس صالحية في السنة (160000) آقجة
كما لاحظنا عند تناولها لمحصول مقاطعة احتساب نفس الشام، فإن القانون نامة يشير إلى اعتماد قانون السلطان المملوكي قايتباي، ومن هنا يجيء الافتراض بأن القانون المُشار إليه قد طُبِّق بالصالحية، و لعله من المفيد أن نشير هنا إلى أن ابن طولون أورد لنا أسماء بعض من ولي الحسبة بالصالحية وأن هذا المنصب قد ضمّ إلى محتسب مدينة دمشق، ثم عاد هناك محتسب للصالحية111.
39- الطواحين مائة حجر في (60) (6000) آقجة
عندما جُمعت الأحجار وُجدت (115 حجرًا) يُلاحظ هنا أن الدولة كانت تتقاضى من أصحاب الطواحين التي تُدار بالمياه مبلغ ستين آقجة سنويًا على الحجر الواحد . وتُقدِّم لنا القائمة الواردة اسم وموقع اثنين وثلاثين طاحونًا وعدد الأحجار في الطاحون الواحد، أكبرها كان لديه أحد عشر حجرا يعرف، بسبب ذلك، بطاحون الإحدى عشرية112، ومعظم الطواحين بمعدل ثلاثة أحجار، والريع المتأتي من هذا الباب كان يُعتبر من موارد الخاص السلطاني، ويقوم على خدمة المطاحن التراسونالذين يأتي القانون نامة على ذكرهم113.
ونشير هنا، استكمالا لتفاصيل هذه الرسوم إلى ما كان يُجبى على أحجار معاصر الدبس، فلقد فرض القانون نامة أخذ رسم ((ست بارات114)) على كل معصرة. وتشير قائمة المقاطعات إلى محصول رسوم معاصرالسيريج (السيرج) من السمسم، وكانت الدولة تجبي (60) آقجة على الحجر، وحاصل ذلك كان (1500) آقجة. ويذكر الدفتر (T.D.474) أن رسمًا إضافيًا باسم ((حماية معصرة ابن الكركي)) لم يكن موجودا في السابق ولكنه وضع على يد زوجة نائب الشام السابق سيباي .
40- الطواحين في أرض الصالحية تابع الشام 31 حجرا ريعها سنويا (1860) آقجة
وكانت الصالحية تشكل ضاحية كبيرة من ضواحي مدينة دمشق، جملها الدفتر (T.D.474) مع إحصاءات دمشق معدِّدًا محلاّتها .
وكان ريع هذه الطواحين يعتبر من الخواص السلطانية. يشير ابن طولون إلى طاحون مقرا وبجانبه حمام مقرا بالصالحية وقد خرب115.
ويورد السجل لنا أسماء أحد عشر طاحونًا خراب في أرض الصالحية 116.
41- اأراضي في أطراف الشام أراضي وبساتين في حوالي نفس شام كلها وقف وملك عشرها للميري أي للخزينة السلطانية
42- أراضي نيرب، وهي غربي الصالحية، يذكر ابن طولون أن بها بيوتًا وبساتين وهي كثيرة المياه117. ويشير إليها البدري على أنها ((محلة ومن أعظم المحلات، حسنة الثمار وفيها حمام الزمرد وجامع بخطبة [أي تُقام فيه الخطبة يوم الجمعة] وكانت مسكن الرؤساء والأعيان)) 118.
وهي في يد أهالي صالحية دمشق حصل – قَسْمْ من النصف كليًا [جميع الأراض] وقف وملك ( 298) فدان مشجر يؤخذ العشر من غير محصول وقف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان119 في (35) آقجة في السنة (9000) آقجة . ولكن إذا ما ضُرب عدد الأفدنة بالرسم (298 ˣ35 = 10430) آقجة، ويبدو أن الرسم المجموع كان بمعدل (2 30,) آقجة عن كل فدان .
43- أراضي أرزة 120 ــ شربها من نهر ثورا [ تورا ]
أراضي أرزة مع رفوف (؟) الزعفران في الصالحية مع مزرعة محمد باب الفوقا والتحتا ومزرعة جمعان
حصل قَسْمْ من النصف: جميع [ كل] الأرض وقف وملك (320) فدان مشجر
يؤخذ العشر باستثناء وقف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان(35) آقجة في السنة (9000) آقجة سنويًا .
إلا أننا نلاحظ هنا أن المبلغ المجبا أقل مما يستوجب بمقدار(2200) آقجة.
44- أراضي وبساتين تعرف بالسهم الأعلى121 في نفس الصالحية
حصل قَسْمْ من النصف (20) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أراضي وقف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة، على كل فدان أربعون آقجة في السنة (800) ىقجة.
45- أراضي قصر لباد [ اللباد ] 122 في يد أهالي نفس الشام مع مزرعة جورت (جورة) علي
حصل قَسْمْ من النصف (120) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان في السنة (35) آقجة (6000) آقجة. لكن على ضوء ما يُدفع عن الفدان يكون المبلغ (4200) آقجة سنويًا وهو أقل من المبلغ المُدوَّن: (6000) آقجة .
46- أراضي وبساتين ميطور123 في يد أهالي نفس الشام124
حصل قَسْمْ من النصف (108) أفدنة مشجرة
يؤخذ العشر من غير أن يشمل أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة، عن كل فدان في السنة (35) آقجة، (3300) آقجة سنويًا .
تبين أن المجموع، وعلى ضوء الأجرة، يجب أن يكون (3780) آقجة.
47- أراضي مسجد الزيتون 125في يد أهالي نفس الشام
حصل قَسْمْ من النصف فدانًا يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع عن كل فدان (35) آقجة في السنة (5600) آقجة سنويًا .
48- أراضي مسجد الزيتون في يد أهالي نفس الشام
أراضي وبساتين مقرى (مُقرا)126 بقرب القلعة في يد أهالي نفس الشام حصل من النصف (220) فدانًا مشجرًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي مزبورين عن كل فدان في السنة (6600)
49- أراضي سطرا127 بيد أهالي نفس الشام
حصل من النصف (220) فدانًا
يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة، عن كل فدان (30) آقجة سنويًا في السنة (6600) آقجة .
50- أراضي سطرا بيد أهالي نفس الشام
حصل [أي حصة الخاص الشاهي السلطاني] قَسْمْ من النصف (130) فدانا يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة وعن كل فدان (30) آقجة، في السنة (4000) آقجة .
والملحوظ هنا أن الفرق ما بين رسم الفدان الواحد ومجموع المساحة هو مائة آقجة (130 ˣ 30 = 3900 ) .
51- أراضي وبساتين بيت لهية128 بيد أهالي قرية جوبر129 وقابون130
حصل قسم من النصف (550) فدانًا. يؤخذ العشر باستثناء أوقاف الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة وعن كل فدان (30) آقجة سنويًا في السنة (16500) آقجة .
52- أراضي وبساتين باب الشرقي بيد أهالي باب الشرقي (210) أفدنة مشجرة (130) سليخًا
يؤخذ العشر عن جملة المتحصل عن الغلال وعن الفصل (المفصول أي المقطوع) ومال الجامع وعن مال الوقف عن الصيفي والخراج باستثناء حصة الحرمين الشريفين والجامع الأموي عن كل فدان مشجر(30) آقجة ولكل فدان سليخ131 (15) آقجة على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة في السنة (8200) آقجة ( دُقِّق المجموع فجاء 8250 آقجة ) .
53- مزرعة غرداسية تابع باب الشاغورفي الغوطة وقف على قراءة (قراءة القرآن العظيم) تمامًا
حصل من النصف (1200) آقجة العشر عن الوقف (120)
54- أراضي وبساتين قينية132 الحمرية (والجمرية ، الخمرية ؟ )
بيد أهالي قرية كفرسوسية 133 وباب السريجة 134 في الشام
حصل الأراضي كلها وقف وملك العشر عن جملة متحصل عن الغلال والفصول – من كلمة (Vassal) اللاتينية [أي المبالغ المقطوعة] ومال صيفي مع عشرعن مال الوقف مع الخراج باستثناء حصة الحرمين [ الشريفين ] وجامع بني أمية عن كل فدان مشجر (30) آقجة. وعن كل فدان سليخ (15) آقجة على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة وفي السنة (19500) آقجة.
مزرعة أراضي وبساتين شاغور بيد أهالي قرية يلداه135 وأهالي محلة شاغور136 وأهالي باب المصلى137
55- مزرعة أراضي وبساتين شاغور بيد أهالي قرية يلداه138 وأهالي محلة شاغور139 وأهالي باب المصلى140
حصل قَسْمْ من النصف وجميع قطع الأراضي وقف وملك (375) فدان مشجر، (450) سليخ
العشرعن جملة المحصول عن الغلال والفصول (المقطوع) وعن مال الوقف مع خراج أشجار وكروم غير حصة الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة في السنة (18000) آقجة .
56- مزرعة فدّاية تابع
حصل قَسْمْ من النصف وجميع المزرعة وقف وملك (250) فدانًا مشجرًا ، (200) سليخ
العشر عن جملة متحصل عن الغلال وعن مال الوقف وعن الخراج باستثناء حصة الحرمين الشريفين والجامع الأموي على وجه المقطوع في عهدة أهالي الأراضي المزبورة عن كل فدان مشجر (30) آقجة سنويًا وعن كل فدان سليخ (15) آقجة سنويا في السنة (10400) آقجة . (لكن مجموع العملية الحسابية حسب القاعدة المحددة لأجرة الفدان الواحد هنا يكون ( 10500) آقجة سنويًا). من هنا نلاحظ وجود نوعين من الأراضي: أراضي مشجرة، وتحسب رسومها على المساحة وليس على عدد الأشجار، وأراضي سليخ، أي غير مشجرة، والرسم هو نصف رسم الدونم المشجر، وزيادة على ذلك، نلحظ أن هناك فروقًا في مجمل أرقام الرسوم ما
بين المبلغ المدون والمبلغ الحاصل نتيجة العملية الحسابية، ولكن الأهم والجدير بالتنبيه إليه هنا أننا نلاحظ البدايات الأولى لدخول الأهالي على التزام ما يتوجب للدولة من رسوم على الأراضي والأشجار.
خواص حضرة أمير أمراء [ والي ] ولاية الشام
يشير الدفتر ( T.D.474) ( ص2) إلى أن محصول خواص مير الميران [ أي أمير أمراء الشام وهو الوالي ] كانت مليون آقجة سنويًا، نذكر منها ما كان من دمشق:
- محصول بادهوا وجرم وجناية [ وجنايت ] ورسم عروسانه نفس الشام في السنة (130000) آقجة .
كانت الدولة تجمع رسومًا تُعرف بالبادهوا سبق أن تناولناها أعلاه وهي أقرب ما تكون إلى ((الطيارات))، ورسوما عند اقتراف الجرم والجناية شريطة أن لا تكون من مواضيع الحدود الكبرى وفي القضايا التي ينظر فيها حكام السياسة أو قضاة السياسة141، وكذلك رسوما تتقاضاها المحكمة مقدارها (125) درهما عند زواج البكر و(75) درهمًا عند زواج الثيب، ويشار إلى هذا الرسم باسم ((رسم عروسانه))142 .
- محصول رسوم براءات ( بروات ) في السنة ( 15000 ) آقجة .
كنا قد أشرنا إلى أن أصحاب التيمارات من السباهية كانوا على نوعين، الأول، وعددهم (155) نفرًا، يحصلون على تيماراتهم مقابل تذكرة أو براءة143 يصدرها السلطان ويدفع المستفيد رسومًا مقابل ذلك، والقسم الثاني، وعددهم (216) نفرًا، كانوا يحصلون على التذكرة من مير الميران أو أمير أمراء ولاية الشام مقابل رسم معين قُدِّر مجمل محصوله السنوي بخمسة عشر ألف آقجة .
- محصول سرعسية (رئيس الحرس الليلي) في نفس الشام والصالحية بموجب العادة القديمة في السنة (20000) آ قجة .
كان العثمانيون يجبون رسوما من أصحاب الدكاكين وأهالي الحارات مقابل الحراسة الليلية ولم تُحدِّد المادة المتوافرة لدينا الأسس والقواعد التي كان المسؤولون يعتمدونها في جمع هذه الرسوم . ولكن، يُفهم من النص أن مثل هذه العادة كانت موجودة من أيام المماليك وأنها عادة قديمة في نفس الشام وفي الصالحية، وقد اعتُمدت هنا في مطلع عهد السلطان سليم الأول. والجدير بالذكرأن شمس الدين محمد بن طولون (ت 953هـ/ 1546م) يشير في أحداث عام 932هـ/ 1526م في الشكوى التي حملها الشيخ الصوفي محمد الصمادي (ت 989هـ/ 1581م) إلى السلطان، وفيها: ((الشكية على النائب والأمناء وغيرهم بسبب مظالم عددها كعسس باشى ومشد الزبالة ويسق [ رسوم ] المحتسب))144.
- محصول بادهوا نواحي الشام من دون خواص الهمايون السلطاني وخواص الزعماء وأصحاب التيمارات الحرة (سربت) ولا يشمل هذا الرسم أوقاف الحرمين الشريفين وخليل الرحمان عليه السلام وجامع بني أمية والقدس الشريف وأوقاف حضرة لا لا مصطفى باشا مع ( رسوم ) الجرم و الجناية والعروسانة لنواحي الشام في السنة (195000) آقجة .
يشمل هذا المحصول رسوم البادهوا (الطيارات) في نواحي بلاد الشام باستثناء البادهوا المجموع لحساب الخاص السلطاني والزعماء وأصحاب التيمارات الحرة ولا يشمل أيضًا أوقاف الحرمين الشريفين – مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة – وأوقاف خليل الرحمن. وكذلك فإنّ أوقاف مسجد بني أمية والقدس الشريف غير خاضعة لرسوم البادهوا كما حددها القانون نامة على النحو التالي : ((ثمّ تسجيل جميع أوقاف الحرمين الشريفين والقدس الشريف
وحضرة خليل الرحمان عليه السلام معفاة من العوارض الديوانية والتكاليف العرفية ومن العشر وذلك في الدفتر الجديد))145.
أما فيما يتعلّق بأوقاف لا لا مصطفى باشا (ت 988هـ/ 1580م)، حاكم دمشق البوسنوي الأصل (971هـ/ 1563م - 975هـ/ 1567م) وأستاذ السلطان سليم الثاني (974هـ/ 1566م – 982هـ/ 1574م)، فلقد أقام خانًا في الشام اشتمل على مائة وسبعين غرفة بالإضافة إلى مسجد وفرن ولكن معظم أوقافه كانت في القنيطرة146 حيث أقام فيها عمارة عامرة فيها مسجد ومرافق لخدمة الصوفية وطلاب العلم والمسافرين وحبّس عليها في السنة (983هـ/ 1575 – 1576م) وسنة (984 هـ/ 1576م) كثيرًا من الدكاكين والدور وحمامات وطواحين وقرى ومزارع وكروم وقطع الأراضي ))147 . ويتضمن دخل أمير أمراء الشام، بالإضافة إلى رسم البادهوا، رسوم الجرم والجناية والعرائس148 في نواحي الشام كما سبق لنا وشرحنا أعلاه .
- محصول باج الخمر الذي يجلبه الكفرة لأنفسهم شرط أن لا يبيعوه للمسلمين في السنة (40000) آقجة
نلاحظ، عند مراجعة دفاتر الطابو أرقام : (169، 263، 401، 423، 474) أن قيمة الباج على الخمر كانت بدايةً مائة ألف آقجة سنويًا ثم ارتفعت إلى (360000) آقجة ثم تدنت إلى أربعين ألفًا149. ويؤيد ذلك ما جاء في القانون نامة حيث ينص على ما يلي : ((وتم تدوين مقاطعة الخمر في البداية في الدفتر الخاقاني بأكثر من ثلاثماية ألف آقجة وتم رفعها بالأمر الشريف لكن ونظرا لكون الكفار يدفعون باجا للخمر الذي يجلبونه لأنفسهم عاده قديمة فقد تم تدوينه في الوقت الحالي في الدفتر الخاقاني بأربعين الف آقجة واشترط عليهم عدم بيعه إلى المسلمين وإذا ما تجاوزوا ذلك يقوم أهل الحكم بمنعهم))150.
محصول باج سوق (بازار) وباج الدواب في منزل المزيريب تابع قضاء حوران151
من المعروف أن بلدة المزيريب152 الواقعة ضمن قضاء حوران كانت تقوم فيها قلعة عثمانية مشهورة وكانت مياهها كثيرة وكانت قافلة الحاج الشامي تنزل بها وكما هو معروف فإنّ أسواقًا كانت تُقام في منازل الحج حيث يكثر الطلب على الدواب لتلبية حاجات الحجاج والتجار لنقل حوائجهم أو للركوب .
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 1-64. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني. |