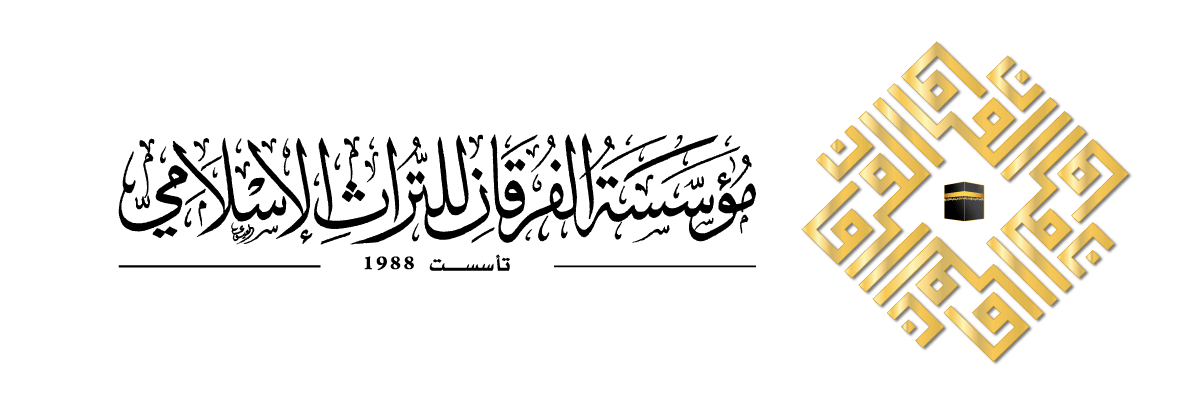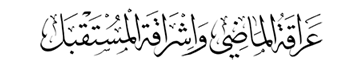محمد سليم العوَّا

العدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو اسم من أسماء الله، تعالى، إذ هو، سبحانه، لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. والعدل الحكم بالحق. والعدل من الناس المرضيُّ قوله وحكمه وشهادته1 والعدل هو الاستقامة، يقال هذا قضاء عدلٌ غير حَدْل، فالحدلُ ضدُّ العدل.2 والعدل هو الإنصاف3. والعدل تقويم الشيء إذا مال ولو أدنى ميل، والعدل الحكمة.4 والعدل القسط، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار.5 وعَدَلَ الشيء بالشيء أي سواه به، وعَدَّلتُ الشهود: إذا قلت إنهم عدول.6 والعدل هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وهو الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق.7 والعدل نقيض الجور، يقال «عَدَلَ بين الخصوم أي أنصف ولم يظلم».8 وعلى هذه المعاني المتقاربة يدور استعمال كلمة العدل، وكلمة القسط، في لغة العرب.
والعدل عند المعتزلة هو أحد أصولهم الفكرية الخمسة التي لا يعد معتزليًا من لم يجمع القول بها9. وحاصل قولهم في العدل أنه «التصرف على مقتضى الحكمة».10وهم يقصدون بالعدل تقرير حرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله،11ولهم في تعريفات العدل عبارات كثيرة يواجهون بها فكرة الجبر التي نشأت زمن بني أمية.12 ولأهل السنة والجماعة مناقشات مستفيضة لهذا الأصل، ردًا على وجهة النظر المعتزلية.
ولأهل اللغة استعمال خاص لمصطلح العدل، لا يريدون به أيًا من المعاني السابقة لهذه الكلمة، بل يريدون به العدول عن باب الأصل إلى باب فرع من فروعه أو صيغة من صيغه.13
وشيوع استعمال اللفظ في مجالات معرفية متعددة، أو تعدد تصريفاته التي يؤدي كل منها معنىً مغايرًا للمعنى الذي يؤديه سواه، يجعله من زمرة الألفاظ التي يسميها علماء اللغة الألفاظ «الشريفة». وهكذا نجد لفظ (العدل) شائعًا في علوم كثيرة بمعانٍ متعددة ونجد المعنى – معنى العدل – شائعًا تعبِّر عنه في لغة العرب كلمات مختلفة المباني. وهذا وذاك دليلان على أهمية العدل من الجهتين جميعًا: جهة اللفظ المعبِّر عنه أصلا، وجهة المعنى الذي يهدي اللفظ إليه14.
فإذا تركنا جانبًا العدل الاعتزالي، والعدل في مصطلح أهل اللغة، إذ كل منهما مستعمل في نطاق لا صلة له بمقاصد الشريعة، وعلى رأسها المقاصد القرآنية، فإن الأمر يقتضينا أن نيمم الوجه شطر القرآن الكريم لنقف على مواطن ذكر العدل والقسط فيه، وما إذا كان ذكره إياها يشير إلى «مقصد قرآني» أم هي أحكام – بأنواعها – لا يستفاد منها مقصد قائم بذاته، كما زعم الشيخ المعمم؟!
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: مقصد العدل في القرآن الكريم، 2016، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 11 -16. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني. |