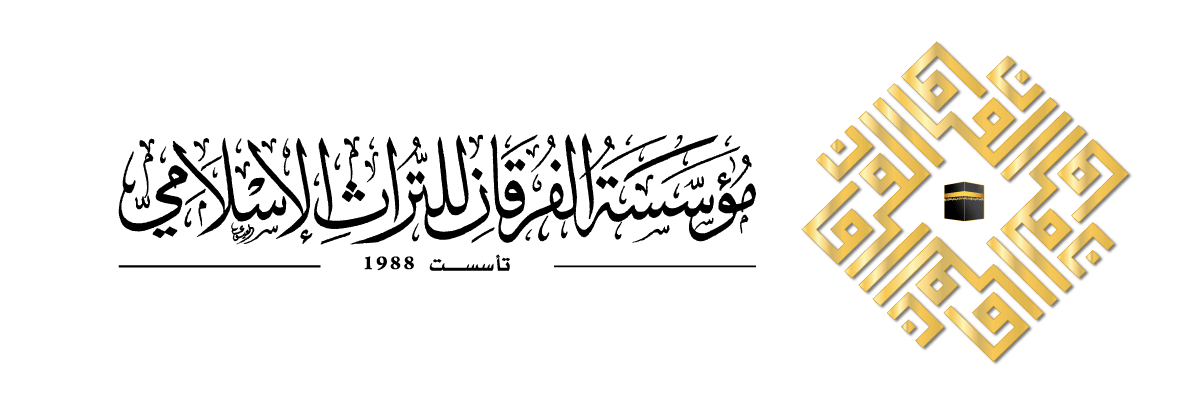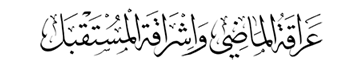عوض محمد عوض: أستاذ بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية
فكرة المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها وتطورها

(1) كان مبدأ التفكير في إنشاء محكمة جنائية دولية تختص بمحاكمة أفراد ينتمون إلى دول مختلفة، عن جرائم خطيرة ارتكبوها ضد الإنسانية، يبدو ضربًا من الخيال أو حلمًا من الأحلام؛ ذلك أن وجود محكمة على هذا النحو يقتضي تنازل الدول عن سيادتها على بعض مواطنيها، وعن اختصاص قضائها الوطني بمحاكمتهم، والتسليم بحق جهة قضاء أخرى بتعقبهم وإرغامهم عن المثول أمامها والامتثال لمحاكمتهم أمام قضاة آخرين، واحتمال الحكم عليهم بعقوبة يجري تنفيذها عليهم في دولة غير دولتهم.
ولم يكن قبول مثل هذه المحكمة ميسورًا. غير أن ما كان يبدو حلمًا أو خيالًا قد أصبح اليوم حقيقة واقعة، وإن كان النظام القانوني لهذه المحكمة لم يبلغ بعدُ المدى الذي ترنو إليه الأبصار وتطمح إليه الآمال.
(2) وقد بدأ التفكير في ضرورة عقد محاكمة دولية لبعض الأفراد في أواخر العقد الثاني من القرن الماضي، ثم صار هذا التفكير أكثر إلحاحًا في منتصف ذلك القرن. وكان هذا نتيجة حربين عالميتين مدمرتين لم تشهد لهما البشرية من قبل مثيلًا، إذ لم يقتصر الاقتتال في كل منهما على دولتين اثنتين، بل تورطت فيه دول عديدة، واتسعت مسارح القتال لتشمل معظم القارات، وجرت المعارك على الأرض وفي البحر والجو، واستخدمت فيها أسلحة بالغة التطور شديدة الفتك والتدمير، وسقط عشرات الملايين من الناس بين قتلى وجرحى وأسرى. ولم يقتصر الضحايا على الجنود وحدهم، بل شمل كذلك المدنيين، فهدمت مساكنهم ودمرت مصانعهم ومتاجرهم وخربت كثيرًا من مدنهم.
(3) وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى اتفق الحلفاء المنتصرون في فرساي على وجوب محاكمة المسؤولين عن إشعال نار الحرب وعن الجرائم التي ارتكبت فيها، خروجًا على القوانين والأعراف الدولية المستقرة. واستقر الرأي على عقد محاكمة عسكرية لقيصر ألمانيا ويلهلم الثاني وعدد كبير من الضباط الألمان والمسؤولين الأتراك، وأعدت قائمة اتهام شملت مئات من المتهمين غير أنه لاعتبارات خاصة لم تَجْرِ محاكمة دولية لأي من المتهمين، بل لم تشكَّل لهم محكمةٌ أصلًا، واكتفي بدلًا من ذلك بمحاكمة عدد محدود من مجرمي الحرب الألمان أمام المحكمة الألمانية العليا، أما الأتراك فلم يُقدَّم أيٌّ منهم للمحاكمة.
ويبدو أن السبب في الإغضاء عن عقد محاكمة جنائية دولية للألمان هو ما طرا على الأوضاع في أوروبا من تطورات اشفق الحلفاء معها من تعريض استقرار الجمهورية الألمانية لخطر السقوط الذي كانت معرَّضة له بالفعل.
أما بالنسبة للأتراك فيرجع السبب إلى قيام الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 وما ترتب عليها من سقوط للنظام القيصري، ولما كانت تركيا مجاورة للنظام الشيوعي الجديد، وكانت هي المتحكمة في مضيقي البسفور والدردنيل، وهما الطريق الوحيد لوصول روسيا من البحر الأسود إلى البحر المتوسط، فقد رأى الحلفاء أهمية استقرار الأوضاع في تركيا وبقاء المجموعة الحاكمة فيها، والمعروف عنها انحيازها إلى الغرب، ولهذا فقد منحوا المسؤولين الأتراك حصانة ضد جرائم الحرب التي وجّهت بها التهمة إليهم. وهكذا انتصرت السياسة على العدالة الدولية.
(4) وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية شكَّل الحلفاء في أغسطس 1945 محكمة عسكرية- عرفت بمحكمة نورمبرج- لمحاكمة كبار القادة العسكريين الألمان عن الجرائم البشِعة التي ارتكبوها إبان الحرب. وحدد النظام الأساسي لهذه المحكمة الجرائم التي تختص بنظرها، وهي: الجرائم المرتكبة ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وجرت محاكمة بضعة وعشرين شخصًا قُضِي ببراءة ثلاثة منهم، وبإعدام 12 شخصًا، وبالسجن المؤبد والمؤقت على الآخرين. أما دولتا المحور الأخريان، وهما إيطاليا واليابان فلم تعقد محاكمات دولية لأحد منهما. وكان السبب في ذلك سياسيًا أيضًا: فقد احتلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إيطاليا- ولم تَنْشَطا لمحاكمة مجرمي الحرب الإيطاليين على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية في إثيوبيا، وجرائم حرب في اليونان وليبيا ويوغوسلافيا، وذلك لما ارتأته دولتا الاحتلال من أن النظام الفاشي هو أفضل معارض للشيوعية، ومن ثم فقد توقفت محاكمة المتهمين، وكانت عدتهم 750 شخصًا. ورفضت دولتا الاحتلال كذلك تسليم المتهمين لحكومات إثيوبيا واليونان وليبيا ويوغوسلافيا التي طالب كل منها بتسليم بعضهم، وذلك لمحاكمتهم طبقًا لاتفاقية استسلام إيطاليا.
أما بالنسبة لليابان، وكانت تحت الاحتلال الأمريكي، فقد أنشئت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى، وقضت بإدانة عدد من مجرمي الحرب اليابانيين. غير أنه لاعتبارات سياسية تم الإفراج عن كل من قُضِي بإدانتهم في خلال الفترة من 1951 إلى 1957، وذلك من منطلق حرص الولايات المتحدة على الحد من مطامع الاتحاد السوفيتي في الشرق الأقصى من جهة، والحرص من جهة أخرى، على الاستئثار بالمعلومات والأبحاث اليابانية الخاصة بالأسلحة الجرثومية وحجبها عن الاتحاد السوفيتي.
(5) ومما تقدم نسجل ملحوظتين: الأولى أن الاعتبارات السياسية طغت على مقتضيات العدالة الدولية؛ فقد رأينا كيف خَفَتَ صوتُ الداعين إلى محاكمة مجرمي الحرب عما ارتكبوه ضد السلام وضد الإنسانية، وكيف علا صوت المصالح الوطنية على صوت الضمير والعدالة الدولية.
أما الملحوظة الثانية فهي أن الدعوة إلى محاكمة مجرمي الحرب اقتصرت على المجرمين من الدول المهزومة ولم يرتفع صوت يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب من الدول المنتصرة، مع أن كثيرًا منهم لم يكن أقل إجرامًا أو أكثر إنسانية من الآخرين. وتكفي الإشارة في هذا المقام إلى المأساة الكبرى التي تمثلت في استخدام الولايات المتحدة القنابل الذرية وإلقائها على كل من نجازاكي وهيروشيما.
(6) وعلى الرغم مما تلا الحرب العالمية الثانية من نزاعات مسلحة داخلية ومن حروب إقليمية، وما ارتكب فيها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم.
وقد أورد بعض الباحثين إحصائية تبين منها أنه فيما بين نهاية الحرب العالمية الثانية ونهاية القرن العشرين، وقع ما يقرب من 250 نزاعًا مسلحًا بلغ عدد ضحاياها- فضلًا عن ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها بعض النظم القمعية- ما يتراوح بين 70 إلى 170 مليون قتيل. ومن هذه النزاعات والحروب الإقليمية على سبيل المثال: الحرب الكورية، وحرب ڤيتنام، وحرب السويس، وحرب 1967، واحتلال روسيا لأفغانستان.
وقد أطلق على الفترة التي امتدت حتى سنة 1993 «سنوات الصمت»، وكان السبب في ذلك يرجع إلى الحرب الباردة التي حالت دون قيام إرادة دولية للتحقيق مع مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم.
غير أنه بانتهاء الحرب الباردة تبلورت مبادرات عديدة من جراء النزاعات التي حدثت في كل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وتعالتِ الأصوات الداعية لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقد استجاب مجلس الأمن لهذه الدعوة، فأصدر سنة 1993 قرارًا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت في أراضي يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وأطلق عليها اسم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وفي سنة 1994 أصدر مجلس الأمن قرارًا مماثلًا بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، للفصل في الاعتداءات الواقعة من التوتسي على ضحاياهم من الهوتو.
وقد أثبت العمل ضرورة وجود نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية بدلًا من اللجوء إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة كلما اقتضت الحاجة؛ فقد تبين أن تشكيل هذه المحاكم في كل مرة يستغرق وقتًا طويلًا يتعذر بسببه الحصول على الأدلة في الوقت المناسب، وهو ما تتأذى منه العدالة.
وبعد اجتماعات كثيرة ومفاوضات طويلة وجهود مضنية، أمكن الاتفاق على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنشودة، واعتُمد نظامها الأساسي في يوليو 1998، ونُص فيه على أنها هيئة دائمة تباشر اختصاصها على الأشخاص الذين يُتهمون بارتكاب طائفة من الجرائم حدَّدها النظام الأساسي على سبيل الحصر بوصفها أشد الجرائم خطورة من وجهة نظر المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم الواقعة على الإنسانية، وجرائم الحرب.
(7) وثمة ملحوظتان في هذا الصدد:
الأولى: أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بناء على معاهدة دولية لا يلتزم بها سوى أطرافها، أما غيرهم فلا يخضعون لنظامها. وقد وقَّعتْ كثير من الدول على هذه المعاهدة، لكنَّ دولًا أخرى امتنعت عن الدخول فيها والالتزام بأحكامها. بل إن النظام الأساسي للمحكمة يجيز لأي طرف الانسحاب منه بموجب إخطار كتابي يوجَّه للأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذًا بعد سنة من تاريخ تسلُّم الإخطار، وإن كان هذا الانسحاب لا يعفي الدولة من الالتزامات التي نشأت عن النظام الأساسي أثناء كونها طرفًا فيه (م127).
والثانية: أن المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للدول التي صدّقت على نظامها الأساسي ليست بديلًا عن قضائها الوطني، بل إن هذا النظام- بوصفه معاهدة دولية- يصبح بعد التصديق عليه جزءًا من القانون الوطني. وطبقًا لهذا النظام فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعد اختصاصًا احتياطيًّا (م1). فالأصل أن يختص القضاء الوطني بنظر الجرائم الواردة في هذا النظام إذا كانت قد ارتُكبت في إقليم الدولة أو وقعت من أحد رعاياها. ولا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا في حالتين: أن تكون الدولة غير راغبة في القيام بمهمة التحقيق والمحاكمة، أو غير قادرة على ذلك، لانهيار النظام القضائي فيها، أو لأي سبب آخر (م17).
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
(8) حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي هذه الجرائم وحصرتها- كما ذكرنا- في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأضافت كذلك جرائم العدوان. وعُنيت المواد التالية بتحديد المقصود بكل جريمة من الجرائم الثلاث الأولى في تطبيق النظام الأساسي.
ويجمع بين هذه الجرائم أمران: الأول أنها جميعًا عمدية. والثاني أن كلًّا منها لا يكوّن في ذاته جريمة واحدة بالمعنى الدقيق، وإنما يمثل عنوانًا أو عائلة إجرامية تضم أفرادًا أو مجموعات من الجرائم تتقارب أفعالها- وقد تتماثل- صورة ومحلًّا وغاية في أحيان، وتتباعد في أحيان، وربما وجدنا بعض الأفعال مدرجة ضمن أفراد أكثر من عائلة.
أما «جرائم العدوان» فقد خلا النظام الأساسي من بيان مفهومها أو تحديد الأفعال المكونة لها، وناط هذه المهمة بجمعية الدول أطراف المعاهدة، ومن ثم فإن مباشرة المحكمة الجنائية لاختصاصها بنظر هذه الطائفة من الجرائم، يظل موقوفًا أو مرجأ إلى حين الموافقة على تحديد مضمونها وبيان أفعالها من جمعية الدول بأغلبية ثلثي أعضائها وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي.
(9) وقد عرَّفت المادة السادسة من هذا النظام الإبادة الجماعية بأنها تعني أي فعل مما نصت عليه يُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عِرْقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكًا كليًّا أو جزئيًّا. وظاهر من هذا النص أنه لا يكفي لوقوع هذه الجريمة أن يكون محلها فردًا واحدًا، بل يجب أن تكون متجهة إلى سائر أفراد الجماعة. وأما الأفعال التي تتمثل فيها هذه الجريمة فهي: قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، أو إخضاعهم عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم فعليًّا كليًّا أو جزئيًّا، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفالهم عنوة إلى جماعة أخرى.
(10) وعرّفت المادة السابعة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بأنها تشمل أي فعل مما نصت عليه إذا ارتكب عمدًا في ظل هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد مجموعة من السكان المدنيين.
وظاهر من هذا النص أنه يلزم لوقوع هذه الجريمة أن يرتكب الفعل المكون لها في ظرف معين وضد جماعة من السكان المدنيين، لا ضد فرد واحد أو اثنين. وتشتمل قائمة الأفعال التي تتكون منها هذه الجريمة على أحدَ عشرَ فعلًا، هي: القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، وإبعاد السكان أو نقلهم قَسْرًا، وسَجْنهم أو حرمانهم الشديد من الحرية البدنية، والتعذيب، والعنف الجنسي كالاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء أو الحمل القَسْري أو التعقيم القَسْري، ونحو ذلك مما يماثله في الخطورة، والاختفاء القَسري للأشخاص، والفصل العنصري، والاضطهاد الجماعي لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.
ثم ختمت المادة بعبارة تتسع لأي فعل لا إنساني آخر له طابع مماثل يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيرًا يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية.
(11) وعرّفت المادة الثامنة جرائم الحرب بأنها التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة لهذه الجرائم. وتشتمل جرائم الحرب على مجموعة كبيرة من الأفعال تتجاوز عدتها الأربعين، وهي مقسَّمة إلى مجموعات، بعضها يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المعقودة في سنة 1949، وبعضها يتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، وبعضها يتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
ويهدف تجريم طائفة من هذه الأفعال إلى حماية المدنيين غير المشاركين في أعمال الحرب، وتهدف طائفة أخرى إلى رعاية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف، وتهدف طائفة ثالثة إلى كفالة الحد الأدنى من الضمانات التي تعارف عليها المجتمع الدولي عند مباشرة أعمال الحرب، وفي معاملة العسكريين المشاركين فيها.
ومن الطائفة الأولى: حظْر توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية، وحظْر مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت، وحظْر توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشرط ألا تكون أهدافًا عسكرية، وحظْر نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه بالقوة، وحظْر قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم، داخل هذه الرض أو خارجها، وحظر إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداعٍ من أمن المدنيين، أو لأسباب عسكرية ملحَّة، وحظر أخذ رهائن أو تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة، وحظر الاغتصاب الجنسي والإكراه على البغاء أو الحمل القَسْري أو التعقيم القَسْري.
ومن الأفعال التي حظرتها الطائفة الثانية: توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقًا للقانون الدولي، وكذلك شن هجمات ضد موظفين مستخدَمين، أو منشآت أو مواد، أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية، أو حفظ السلام؛ عملًا بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
ومن الأفعال التي حظرتها الطائفة الثالثة: إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تسوغ ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، وتعمُّد شن هجوم، مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية، ويكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة مباشرة.
ومن الأفعال المحظورة أيضًا: استخدام الأسلحة المسمّمة والغازات الخانقة أو السامة وما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة، وكذلك أنواع معينة من الرَّصاصات.
ومنها كذلك: قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معادٍ أو إصابتهم غدرًا، وقتل أو جرح مقاتل استسلم مختارًا وألقى سلاحه ولم تعد لديه وسيلة للدفاع، وكذلك أفراد القوات المسلحة الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة. ومنها كذلك إرغام أسرى الحرب أو أي شخص مشمول بالحماية، على الخدمة في صفوف قوات معادية، وإجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، وتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًّا في الأعمال الحربية، وإخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معادٍ للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يقتضيها العلاج الطبي1.
(12) وعلى الرغم من نبل الغاية التي أنشئت من أجلها المحكمة الجنائية الدولية، فإن كثيرًا من الدول تقاعست عن الانضمام إلى نظامها الأساسي، وذلك تفاديًا لما يترتب على هذا الانضمام من تبعات. فبعض الدول- ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل- امتنعت تحسبًا لاحتمال تقديم بعض كبار المسؤولين فيها من الساسة والقادة العسكريين والضباط والجنود إلى المحاكمة أمام تلك المحكمة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبوها ضد شعوب دول أخرى.
ومن الدول الممتنعة كذلك طائفة خشي حكامها أن يؤدي انضمام دولهم إلى النظام الأساسي لتلك المحكمة إلى محاكمتهم هم أنفسهم أمامها عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في حق شعوبهم. وتدخل الدول العربية بكل أسف ضمن هذه الطائفة، إذ لم ينضم إلى الاتفاقية الخاصة بتلك المحكمة سوى قلة قليلة من هذه الدول تعد على أصابع اليد الواحدة. أما بقية الدول فمنها من امتنع عن التوقيع أصلًا، ومنها من وقّع عليها، ومع ذلك فلم يستكمل إجراءات الانضمام بالتصديق عليها من قبل السلطة التشريعية المختصة. بل إن إحدى الدول العربية- وهي العراق- كانت قد انضمت إلى الاتفاقية سنة 2005، ثم ما لبثت أن انسحبت بعد أسبوعين دون تفسير.
(13) وإذا كان الجانب الموضوعي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية محل تأييد وإقرار، فإن الجانب الإجرائي منه نظرًا، وعلى الأخص ما تعلق منه بالإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة لاختصاصها؛ فالنصوص المقررة في هذا الشأن تسمح لأي دولة طرف في نظام المحكمة أن تحيل إلى المدعي العام أية جريمة مما يدخل في اختصاصها، ولو كانت لم تقع في إقليمها أو على أحد رعاياها، بل وقعت في إقليم إحدى الدول الأطراف أو على بعض رعاياها، بكل ما يترتب على هذه الإحالة من آثار. وهذا يفتح الباب واسعًا لإساءة استعمال تلك الرخصة واتخاذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف. ذلك أنه يمكن لبعض الدول أن تثير فتنة داخلية في إحدى الدول المنضمَّة للاتفاقية، ثم تبادر هي، أو توعز إلى دولة من الأطراف بإحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية مع توجيه الاتهام لأشخاص بأعيانهم من كبار المسؤولين في تلك الدولة؛ إما للتخلص منهم، أو لحملهم على تغيير الموقف السياسي لدولتهم.
وهنا تكمن الخطورة، لاسيما أن الاتفاقية وإن كانت قد أجازت لأي من أطرافها أن ينسحب منها، إلا أنها لم تُجِزْ لمن يطلب الانضمام إليها أن يبدي أي تحفظات على النظام الأساسي. ولعل هذا هو ما حمل كثيرًا من الدول- ومنها معظم الدول العربية- على التردد، أو على رفض الانضمام إلى هذا النظام.
المحكمة الجنائية الدولية في ميزان الشريعة الإسلامية:
(14) ذكرنا أن هذه المحكمة أنشئت بمقتضى اتفاقية دخلت فيها دول عديدة ودعيت سائر دول العالم لكي تنضمَّ إليها. وعَقدت الاتفاقية لتلك المحكمة اختصاصًا بالفصل في طائفة معينة من الجرائم، قدر المجتمع الدولي خطورتها؛ لارتكابها ضد الإنسانية أو لانتهاكها قوانين الحرب المتعارف عليها. وكلا الأمرين سيكون محلًّا لدراستنا من وجهة نظر شرعية مقاصدية: فإلى أي مدى يجوز للدول الإسلامية أن تنضمَّ إلى اتفاقية دولية بعض أطرافها غير مسلمين؟ هذه واحدة، والأخرى- وهي الأهم- ما حكم الشريعة الإسلامية في مفردات الأفعال التي اعتبرتها هذا الاتفاقية جرائم تختص تلك المحكمة بالفصل فيها؟
أولًا: مدى جواز الدخول في الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية
(15) ليس في أصول الإسلام، ولا في عمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء من بعده، ما يحول دون الدخول في عهود أو معاهدات مع غير المسلمين، سواء كانت هذه المعاهدات ثنائية أو جماعية؛ فالإسلام دين سلام، والعلاقات السلمية- وليست الحروب- هي الأساس في الروابط بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية. وليس صحيحًا ما يشاع من أن العالم- طبقًا للنظرية الإسلامية- ينقسم إلى دارين اثنتين فقط، هما دار السلام ودار الحرب، وإنما الصحيح أن ثمة دارًا ثالثة، هي دار الصلح أو العهد. وإذا كان في الفقه الإسلامي التقليدي ما يصح أن يستدل به على صحة التقسيم الثنائي، فإنما كان ذلك تسجيلًا ورصدًا لواقع حالٍ في فترة تاريخية معينة سادتها ظروف خاصة، لكنه ليس من أصول الإسلام، ولا كان سنّة متَّبَعة على مدى تاريخه. بل إن النصوص الشرعية وعمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) نفسه والخلفاء من بعده تنفيه وتثبت عكسه.
(16) أما النصوص الشرعية فلا يتسع المقام هنا لسردها حصرًا، ولهذا فسوف نجترئ بذكر نماذج منها. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13]. والنداء في هذه الآية موجه إلى الناس كافة لا إلى المسلمين وحدهم. والآية تلفت الناس إلى أنهم وإن كانوا قد خلقوا من أصل واحد وتفرقوا مع ذلك شعوبًا وقبائل، فإن اختلاف انتماءاتهم بما ترتَّب عليها من اختلاف ألسنتهم وألوانهم، بل ومعتقداتهم رغم وحدة أصلهم، إنما كان لحكمة سامية، هي التعارف لا التناكر، والتواصل لا التناحر. ومن هذا يتبين أن الأصل الإسلامي في العلاقات بين الناس، أفرادًا وجماعات، شعوبًا ودولًا، هو السلام لا القتال، وهو ما ينفي أن يكون العالم في المنظور الإسلامي إما دار سلام أو دار حرب.
ويحدد الإسلام طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، ويجعل هذه العلاقة على ضربين تبعًا لموقف الأخيرين من المسلمين. وهو يبدأ بعلاقة السِّلْم بوصفها الأصل، فيقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 8 - 9]. ووصف القرآن البر بالفريق الأول بأنه عدل وإقساط، ووصف موالاة الفريق الثاني بأنه ظلم، وهذا وذاك منتهى الإنصاف.
وعرض الإسلام لمشكلة التعارض بين واجبين: واجب المسلمين نحو فريق من إخوانهم في الدين لا يقيمون معهم، ولكنهم استنصروهم على عدو لهم يقاتلونه، وبين التزام أولئك المسلمين بمعاهدة عقدوها مع هذا العدو. ورفع القرآن هذا التعارض بتغليب المعاهدة على وحدة الدين، التزامًا بالوفاء بالعهد. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [الأنفال: 72].
ويرى بعض المفسرين أن على المسلمين نصرة من يُعتدى عليهم من إخوانهم شريطة ألا يُخِلَّ هذا بعهد من عهود المسلمين مع الغير، ولو كان هذا الغير هو المعتدي، بل ولو كان الاعتداء واقعًا عليهم في دينهم وعقيدتهم.
وتأكيدًا لمشروعية التعاهد مع غير المسلمين ووجوب الالتزام بشروط العهد نقرأ في مستهل سورة التوبة: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾. وظاهر النص يوحي بانصراف الحكم إلى عموم المشركين، والنهي عن التعاهد معهم. غير أن ما تلا هذا الاستهلال يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 4]. ثم تمضي السورة فتقول: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 7]. ونلاحظ هنا أن كلتا الآيتين ذيلت بما يدل على أن الوفاء بالعهد هو من التقوى التي يحب الله أهلها.
(17) وقد بدا لبعض المفسرين أن هذا الحكم وقتيُّ اقتضته ظروف المرحلة، وأن سورة التوبة أنهت العقود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين، سواء كان هذا الإنهاء بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة أو للناكثين لعهودهم، أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عقود مقيدة ولم ينقصوا المسلمين شيئًا ولم يُظاهروا عليهم أحدًا، وأن النتيجة الأخيرة- على الجملة- هي إنهاء العقود مع المشركين، وإنهاء مبدأِ التعاقد أصلًا معهم، بعد ذلك بالبراءة المطلَقة من المشركين، وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله.
ويرى صاحب هذا الرأي أن كون هذه النصوص مرحلية، لا يعني أنها منسوخة، بل هي تقررت لمواجهة واقع معيّن، وهذا الواقع قد يتكرر وقوعه في حياة الأمّة المسلمة، وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية، لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك الحالة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ويضيف: لكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى، وأن هذه هي نهاية خطوات هذا الدين2.
ولسنا مع أصحاب هذا الرأي، بل الرأي عندنا هو ما قدمناه ودللنا عليه، من أن الأصل في الإسلام هو العلاقات السلمية بين الدول والجماعات رغم اختلاف الأديان. ولهذا فنحن لا نسلّم بأن النصوص التي وردت في سورة التوبة وفي غيرها من السور تنطوي على أحكام مرحلية، بل هي أحكام عامة تسري بصفة مطلقة ودائمة. ومما يعزز رأينا هذا ما جاء به القرآن في شأن القتل الخطأِ، فلا يشك شاكّ في أن الأحكام الواردة فيه هي أحكام عامة وغير مرحلية، بل دائمة. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، فقد بينت هذه الآية حكم المؤمن الذي يقتل الغير خطأن وفرقت بين فروض ثلاثة: أولها أن يكون المقتول يقيم في دار الإسلام، وجزاء قتله تحرير رقبة مؤمنة وأداء الدية. والثاني أن يكون المقتول مؤمنًا من قوم هم أعداء المسلمين، وجزاء قتله تحرير رقبة مؤمنة فقط. والثالث أن يكون المقتول من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق- سواء كان المقتول مؤمنًا أو غير مؤمن- وجزاء قتله تحرير رقبة مؤمنة وأداء الدية.
وظاهر من هذه الأحكام أن من يُقتل خطأ- بيد مؤمن- إن كان القتيل من قوم غير مسلمين يربطهم بالمسلمين عهد وميثاق، فحكمه حكم من يُقتل خطأ في دار الإسلام. ولما كان هذا الحكم عامًّا ودائمًا، فهذا دليل على أن التعاهد مع غير المسلمين جائز شرعًا في كل وقت وليس حكمًا مرحليًّا.
(18) وعمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) نفسه وأصحابه والخلفاء منهم من بعدهم، يؤكد مشروعية التعاهد مع غير المسلمين، سواء كان التعاهد لمدة محددة أو غير محددة فعقب هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة واستقراره فيها، شرع في تأسيس الدولة الإسلامية وتأمينها. وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يتكونون من جماعتين: جماعة المسلمين من المهاجرين والأنصار، وجماعة اليهود. وقد أعد الرسول وثيقة أطرافها المسلمون من جهة، واليهود من جهة أخرى.
واختلف الدارسون في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة؛ فثم من يرى أنها وثيقة دستورية، وثم من يرى أنها معاهدة. والذي نراه أنها ذات طبيعة مزدوجة؛ فهي في شق منها تضمنت بعض المبادئ الدستورية المهمة، وهي في الشق الآخر معاهدة؛ فقد وصفت المسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، بأنهم أمة واحدة من دون الناس، ووصفت اليهود بأنهم أمة مع المؤمنين، لهم دينهم وللمسلمين دينهم، وأنهم جميعًا يدٌ على من حارب أهل المدينة، وأنه لا يأثم حليف بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأنه لا تُجار قريش ولا من نصرها3.
ويصف د. محمد حسين هيكل هذه الوثيقة- نقلًا عن ابن هشام في «سيرته»- بقوله: إن الرسول كتب بين المهاجرين والأنصار كتابًا وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرَّهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم4.
وفي السنة السادسة من الهجرة عقد النبي مع مشركي قريش معاهدة عرفت باسم «صلح الحديبية». وتضمنت هذه المعاهدة شروطًا يبدو من ظاهرها أنها مجحفة بالمسلمين، لكن النبيَّ قبلها رغم ذلك. وقد استاء بعض الصحابة من اشتمالها على تلك الشروط، وعبروا صراحة عن ذلك، غير أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمضاها معلنًا لهم أنه عبد الله ورسوله، وأنه لن يخالف أمره ولن يضيعه. ثم تبين من بعد أن ما حسبه أولئك النفر تفريطًا واستسلامًا لتعنت قريش كان خيرًا ونعمة، وأنه كان إرهاصًا بفتح مكة. وهذه المعاهدة تثبت أمرين: الأول: جواز التعاهد مع غير المسلمين. والثاني: أنه لا بأس من قبول المسلمين عند التعاهد في بعض الأحيان شروطًا من النِّديَّة والإنصاف متى كانت ظروف الواقع لا تمكنهم من الحصول على شروط أفضل، وذلك عملًا بقاعدة «دفْع الضَّرر الأشدِّ بالضَّرر الأخفِّ».
وفي السنة العاشرة من الهجرة عقد النبي صلحًا مع نصارى نجران، ضرب عليهم فيه الجزية وأمّنهم على أموالهم وأنفسهم ودينهم، وألا يغير أُسْقفٌ من أسْقُفيَّته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته، وألا يؤخذ رجل منهم بظلم آخَرَ.
فهذه معاهدات ثلاث عقدها الرسول مع غير المسلمين: الأولى مع يهود المدينة، والثانية مع مشركي مكة، والثالثة مع نصارى نجران.
(19) وفي السنة الخامسة عشرة من الهجرة عقد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) صلحًا مع أهل إيلْياءَ (بيت المقدس)، أمّنهم فيه على أنفسهم وأموالهم ودينهم، وألا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من حيِّزها ولا من صُلْبانهم، ولا يُكرهون على دينهم ولا يُضارَّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وفرض عليهم الجزية مثلما فرضت على غيرهم من أهل المدائن.
وعقد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) في السنة العشرين من الهجرة معاهدة مع أهل مصر مماثلة لمعاهدة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لأهل بيت المقدس. ثم مضى الخلفاء الأمويون والعباسيون بعد ذلك على سُنة من سبقوهم في عقد المعاهدات مع غير المسلمين دون نكير.
(20) وما قدمناه حتى الآن هو حكم النقل وعمل السَّلف، ونضيف هنا أنه لو لم يكن هناك نقل لَوجب أن يكون حكم الدخول مع غير المسلمين في معاهدات هو الجواز بحكم العقل؛ لما فيه من المصلحة، وهي من مصادر الأحكام في الشرع؛ فليس في العالم اليوم دولة تستطيع العيش منغلقة على نفسها، مكتفية بذاتها، مستغنية عن غيرها. بل إن حاجة كل دولة إلى غيرها في العصر الحديث صارت أشد مما كانت عليه في الزمن القديم، وأصبح العالم اليوم- كما يقال- قرية صغيرة. ولم تعد حاجة كل دولة إلى غيرها ترفًا ورفاهة، بل غدت ضرورة. وتكفي الإشارة إلى وسائل النقل والاتصال، وإلى التجارة والمصارف، وإلى الحاجة إلى تبادل المعرفة والاستعانة بالخبرة الفنية والعلمية في مختلف المجالات. ولا شك في أن أي دولة إسلامية تفكر اليوم في عزل نفسها عن الدول الإسلامية كافة، إنما هي دولة تُقْدِم بسَفَهٍ على الانتحار. ذلك أن الدول الإسلامية المعاصرة هي اليوم في مجموعها دول مستهلكة لمعظم- إن لم يكن لكل- ما تنتجه الحضارة غير الإسلامية. ولهذا فحاجة الدول الإسلامية إلى الدول غير الإسلامية لعقد معاهدات أو اتفاقيات معها- أشد من حاجة تلك الدول إليها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المعاهدات بين مختلف الدول ضرورة لا مَعْدَى عنها، حتى لو سلمنا جدلًا بصحة ما توهمه الرأي المخالف من قطيعة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. ذلك أن حالة الحرب بطبيعتها وأيًّا كان أطرافها هي حالة عارضة، غذ يمتنع عقلًا أن يكون هناك مجتمع بشري تعيش طوائفه أو دوله في حالة حرب مستمرة. وإنما الحرب عَرض طارئ، ولا بد أن ينتهي إما بهدنة أو صلح، أو بهزيمة ونصر. والهدنة تقتضي معاهدة تحدد مدتها وتبين شروطها، والصلح يقتضي معاهدة كذلك. وانتصار طرف وانهزام آخر يقتضي معاهدة يعلن فيها المهزوم استسلامه ويفرض فيها المنتصر شروطه؛ فلا بد في كل الأحوال من معاهدة توقف الحرب مؤقتًا أو تنهيها صلحًا أو نصرًا وهزيمة. وإذا لم تكن حرب فالسلام، وهذا هو الأصل في العلاقات الدولية، بصرف النظر عن اختلاف الأجناس والأيديولوجيات والأديان.
هذا عن المعاهدات التي تعقد في ظروف الحرب. أما التي تعقد في حالة السلم فلا تَقِل عنها لزومًا في نظر الشرع، لأنها مقتضى التعارف الذي هو علة جعل الناس شعوبًا وقبائل مع أنهم جميعًا خلقوا من ذكر واحد وأنثى واحدة.
ولعل أفضل ما نختم به هذا الموضوع- ونحسمه أيضًا- هو أن نورد حديثًا لمن كان خلقه القرآن، فقد روي عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لقد شهدتُ في دار عبد الله بن جُدْعانَ حِلْفًا ما أحب أن لي به حمْر النَّعَم، ولو دُعي به في الإسلام لأجبتُ»5.
وقصة هذا الحلف- كما وردت في «سيرة ابن هشام»- أن قبائل من قريش تداعت إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جُدعان لشرفه وسنِّه، فكان حِلْفهم عنده، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مَظْلمته، فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وكان هذا الحلف قبل البعثة بعشرين سنة، وشهده النبيُّ وهو ابن عشرين. وحُمْ النَّعَم عند العرب هي أنفَس الإبل.
ودلالة هذا الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يعتز بشهوده هذا الحلف ويعرب عن سعادته بما دار فيه وما انتهى إليه المجتمعون من توحيد كلمتهم على الانتصار للمظلوم والوقوف جميعًا ضد من ظلمه حتى يرد إليه حقه، ويعلن- وهذا هو المهم- أنه لو أن جماعة كتلك الجماعة دعت إلى مثل ذلك الحلف ودعته إليه بعد أن بُعث نبيًّا لاستجاب لدعوتهم. والمعنى أنه لا يعنيه دين الداعي، مسلمًا كان أو غير مسلم، وإنما الذي يعنيه هو نُبْل الغاية من الدعوة. والحديث يغني عن التعليق.
ثانيًا: حكم الإسلام في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
(21) كل الأفعال التي ذكرتها المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إجمالًا، ثم أوردتها المواد التالية تفصيلًا، هي في نظر الشريعة الإسلامية محظورات توجب عقاب مرتكبها؛ لما تشمل عليه من عدوان وانتهاك لحرمات يمتنع المساس بها إلا بحقها. وأغلب هذه الأفعال تنال من الضرورات الخمس التي حددها فقهاء الشريعة، وهي حفظ النفس والعقل والنسل والمال والدين، وتنال كذلك من ضرورات أخرى لا تقِل عنها في الأهمية، كالحرية الشخصية، والكرامة الإنسانية، والعرض، والمساواة.
وما نقرره ليس قولًا مرسلًا سنده الوحيد هو المقاصد العامة للشريعة، بل يستند كذلك إلى أحكام شرعية خاصة وردت في شأن معظم تلك الأفعال، وإلى ممارسات فعلية باشَرها المسلمون في أوقات السلم وفي ظروف الحرب.
ثالثا: جرائم الحرب
(22) الحرب والقتال في الاصطلاح مرادفان. ولفقهاء الشريعة في بيان أحكام القتال شروح ومؤلفات لعل أكثرها شمولًا وذيوعًا كتاب «السِّير الكبير»، لمحمد بن الحسن الشيباني. ويمكن لأغراض هذا البحث تقسيم أحكام القتال قسمين، أولهما فيمن توجَّه إليه أعمال القتال. والثاني في آداب القتال، أي فيما يباح فيه وما يحرم من أفعال.
القسم الأول: بيان من توجَّه إليهم الأعمال الحربية
(23) حدد القرآن من توجَّه إليهم هذه الأعمال، فقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]. ودلت هذه الآية بصريح لفظها على أن المسلمين لا يبدؤون غيرهم بالقتال، وإنما يقاتلون الغير ردًّا لعدوانه، وأنهم حين يقاتلون لا يتوجهون بقتالهم إلى غير من يقاتلهم، لأن قصْد غيرهم عدوان نهى الله عنه. وبناء على ذلك يمتنع توجيه أعمال القتال إلى مواطني العدو الذين لا يباشرون القتال حقيقة أو حكمًا. وتأصيل هذا الحكم شرعًا أن الآدمي في نظر الإسلام خلْق معصوم الدم، وإباحة قتله في الحرب عارض اقتضاه دفع شرِّه، فمن لم يتحقق منه قتال ولا مشاركة فيه لا يخشى شره، فوجب أن يبقى على أصله من العصمة، وهؤلاء هم من يطلق عليهم في الاصطلاح المعاصر وصف «المدنيين».
وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء من بعده كانوا يوصون أمراء الأجناد الذين يبعثونهم للقتال بأنه لا يحل لهم في حال القتال قتل النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين المعتزلين والزَّمْنَى وذوي العاهات العاجزين عن القتال، ومن في حكمهم من العُسَفاء- أي الأُجَراء- والفلاحين والصناع والتجار. والجامع بين كل أولئك أنهم لا يشاركون في القتال ولا في الإعانة عليه. فإن هم اشتركوا فيه بالفعل أو أعانوا عليه- سواء بالتحريض أو بالرأي والتدبير- لم تغن عنهم صفاتهم، وجاز معاملتهم معاملة المحاربين. فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قوله لمن بعثهم للقتال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةً»6. وروي عنه قوله: «ألا ما بالُ أقوامٍ قتلوا المقاتلة ثم تناولوا الذُّرية- يعني النساء والأطفال- ألا لا تقتلُنّ الذرية، ألا لا تقتلن الذرية»7.
وأوصى أبو بكر (رضي الله عنه) يزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرًا على القتال بالشام: يا يزيد، لا تقتل صبيًّا ولا امرأة ولا هَرِمًا، وستلقى أقوامًا زعموا أنهم قد فرّغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا أنفسهم له.
وقال الشوكاني عقب إيراده أحاديث الكفِّ عن قصْد النساء والصبيان والرهبان بالقتل: إن أحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال حتى لو تترَّس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم8.
ويلحق بالمدنيين بجامع عدم المشاركة في أعمال القتال الموظفون القائمون بمهامِّ الإغاثة والمساعدة الإنسانية- كالأطباء والممرِّضين- أو بحفظ السلام، عملًا بالمواثيق الدولية.
وقد أكد إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، الصادر عام 1990، في مادته الثالثة حق المدنيين في الحماية، فنص فيها على أنه في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال، كالشيخ والمرأة والطفل.
القسم الثاني: أعمال القتال
أولا: التزام قواعد الشرف وتجنُّب الغدْر
(24) ينهى الإسلام المسلمين عن مفاجأة عدوهم بالحرب وأخذه على غِرَّة، ويوجب عليهم إذا جدّ ما يقتضي الحرب تنبيه العدو والإعذار إليه قبل البدء في القتال، فربما استجاب للإنذار فزال داعي الحرب وحُقنت الدماء، وهذا ما يعرف بالمنابذة. ويجب أن تمضي بين الإنذار وبدء القتال فترة معقولة قدرت بثلاثة أيام على الأقل، حتى يتاح للعدو خلالها تدبر أمره وتحديد موقفه.
وإذا كان العدو طرفًا في معاهدة مع المسلمين، وتحقق لهم أنه على شرف نقضها غدرًا، وجب عليهم قبل البدء في قتاله أن يخطروه بأن المعاهدة لم تعد قائمة بسبب سعيه الحثيث لنقضها غدرًا. وليس لهم أن يتحللوا من هذا الواجب وإلا كان هذا منهم غدرًا وخيانة، وهو منهي عنه بقول الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]. وهذا ما التزمه الصحابة في علاقتهم بمن كانوا متعاهدين معهم، ثم ثبت لهم من مسلكهم انعقاد عزمهم على نقض عهودهم. يذكر الشوكاني أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو بِرْذَونٍ وهو يقول: اله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرُو بنُ عَبسَةَ، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء». فرجع معاوية بالناس9.
ويرى الفقهاء أنه كان في بلاد الإسلام من رعايا العدو عدد ذو بالٍ دخلوا البلاد بترخيص من ولي الأمر ثم نَشِبت الحرب وتوجَّس المسلمون منهم خيفة لأمارات دالة، وجب أن يُردوا إلى بلادهم لا أن يقتلوا أو يعتقلوا، وذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: 6].
ومما يدخل في باب الغدر المنهي عنه: التظاهر بالتسليم أو طلب المفاوضة، وكذلك إساءة استعمال علَم العدو أو شارته العسكرية وزِيـــِّه العسكري أو علَم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، إذا أدى ذلك إلى قتل بعض الأشخاص أو إلحاق إصابات بهم.
(25) على أن النهي عن الغدر بالعدو في الحرب لا يقتضي النهي عن اللجوء إلى وسائل الخداع فيها؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «الحرب خدعة»10. ولا تعارض بين الأمرين؛ لاختلاف كل منهما في دلالته؛ فالغدر لؤم وخِسَّة في الطبع، أما الخداع الحربي ففطنة وذكاء. ومن حق كل فريق أن يتخذ من الوسائل المشروعة ما يخادع به عدوه، حتى يتمكن من الغلبة عليه، وهو في الوقت ذاته يقدح زناد فكره تخيلًا لما يفكر فيه هذا العدو وتحسبًا لما يخطط له، كي يبطل خططه ويفسد عليه أمره. والكل يعلم أن الحرب ليست مواجهة بين الأسلحة فحسب، ولكنها قبل ذلك مواجهة بين العقول التي تدير الحرب وتحرك هذه الأسلحة. وكُتب التاريخ قديمًا وحديثًا حافلة بقصص المعارك التي هزم الذكاء الحربي فيها الجيوش الجرَّارة العَتاد الوفير.
وعلى الرغم من نهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الكذب، أجازه في حالات منها حالة الحرب. روى أبو هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفي القتال، وفي إرضاء الرجل أهله»11.
ويقول السَّرَخْسيُّ في «شرح السِّير الكبير» لمحمد الشيباني: إنه ليس المراد الكذب المحض، وإنما المراد استعمال المعاريض. ونقل عن عمر (رضي الله عنه) قوله: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. ويقول: ومن هذا النوع أن يقيد كلامه بلعلّ وعسى. ونظير ذلك ما فعله الرسول يوم الخندق، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه. فقال له: «فلعلنا نحن أمرناهم بهذا». فرجع الرجل إلى أبي سفيان وقال: زعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا. فقال: أنت سمعته يقول هذا؟ قال: نعم، قال فو الله ما كذب. وكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم12.
ووسائل الخداع لا تقع تحت حصر، منها تسريب الأخبار غير الصحيحة كنوع من حرب الأعصاب والتضليل، ومنها التجسس. ويروى أن خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لما أصبح الصباح جعل مقدمة جيشه ساقه وميمنته ميسرة، فأنكر العدو حالهم، وقالوا جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين. فهذه خدعة بالفعل لا بالقول.
ثانيًا: وسائل القتال وأساليبه
الحرب مقتلة بحكم طبيعتها- أو هي مأيَـمَةٌ مَيْتَمةٌ كما يقال- هكذا كانت وستظل أبدًا. والأخيار من بني البشر يدينونها ويدعون إلى نبذها أو توقِّها ما أمكن. وإذ كانت لا محالة واقعة بوصفها شرًّا لا سبيل إلى قطع دابره، فإن الجهود الإنسانية لم تنقطع عن السعي إلى تهذيبها والحد من بشاعتها وشناعتها. ومقتضى الحرب- من ناحية نظرية مجردة- أن يكون لكل دولة أن تستخدم من الأسلحة ما تراه كفيلًا بدَحْر العدو وقهره وحمله على الرُّضوخ والاستسلام له. غير أن هذا الحق لا ينبغي أن يكون مطلقًا، وذلك لاعتبارات إنسانية في المقام الأول، وعلى الأخص في عصرنا الراهن، حيث وصل التقدم العلمي، وعلى الأخص في مجال ابتكار الأسلحة الحربية، درجة لا تدعو إلى القلق فحسب، بل تثير الفزع، لا خوفًا على المتحاربين وحدهم، بل إشفاقًا على البشرية بأسرها، وهذا قمة الفساد الذي نهى الله عنه في كتبه وعلى لسان رسله؛ فكلهم كانوا يخاطبون أقوامهم قائلين لهم: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [الأعراف: 85]، ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف: 56]، ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22].
ويمكن تقسيم أفعال القتال المحظورة شرعًا أقسامًا ثلاثة، منظورًا فيها إلى طبيعة الأداة المستعملة، والأشخاص الذين تقع عليهم، والأماكن التي تقع فيها أو عليها. وقد اشتملت الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية على طائفة كبيرة من الأفعال التي ترتكبن سواء في المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي أو في الصراع المسلح غير الدولي، واعتبرتها جميعًا في تطبيق أحكامها جرائم حرب. وهذه الأفعال كلها محظورة في الشريعة الإسلامية للعلة ذاتها التي حظرت من أجلها في تلك الاتفاقية.
(26) أ- أما الأفعال المحظورة بسبب أدائها فتشمل كل فعل يستخدم فيه أحد أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها السلاح النووي؛ فاستخدام هذا السلاح يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح لا تقتصر على المشاركين في القتال وحدهم، بل تتجاوزهم إلى المدنيين فتلحق بهم- فضلًا عن ذلك- أضرارًا واسعة النطاق طويلة الأجل تنال من صحتهم نيلًا بالغًا، وتنال بالدرجة نفسها من البيئة الطبيعية المحيطة بهم.
وهذه الأضرار لا تتناسب البتة مع المكاسب العسكرية المتوقعة أو حتى المرجوة. ولهذا السبب نصت الاتفاقية على حظر استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارًا زائدة أو آلامًا لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل.
ونصت الاتفاقية بوجه خاص على حظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة وغيرها من الغازات، وكل ما هو في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة. ونصت كذلك على حظر استخدام السموم أو الأسلحة المسمَّمة، وعلى حظر استخدام طلقات الرَّصاص التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، كالطلقات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الطلقات المحزَّزة الغلاف.
(27) ب- وأما الأفعال المحظورة لوقوعها مباشرة على الأشخاص فتشملها قائمة طويلة يترتب على كل فعل منها انتهاك لحقٍّ من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن وفي السلامة البدنية والنفسية، ومنها كذلك حقه في الحرية الشخصية وفي صون عرضه وكرامته الإنسانية، وحقه في حماية أمواله وممتلكاته. ولما كانت صور العدوان على كل حق من هذه الحقوق تتعدد وتتباين، وكان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي تحديد الأفعال المؤثمة تحديدًا دقيقًا، فقد عمدت الاتفاقية في سبيل بيان الأفعال التي تنال من هذه الحقوق إلى تحديد صور العدوان التي تدخل تحت أحكامها تحديدًا حاصرًا، ولم تكتف بعبارات عامة تجرِّم مطلق العدوان على كل حق من تلك الحقوق.
(28) أ- أما النفس الإنسانية فلها في الشريعة الإسلامية حرمة خاصة جُعل القصاص جزاء للعدوان عليها. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: 33]، وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. وقال (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع: «أيها الناسُ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا»13.
وقد حظرت الاتفاقية القتل العمد إذا كان المجني عليه من الأشخاص الذين تشملهم اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف 1949، كما حظرت تعذيب هؤلاء الأشخاص أو معاملتهم معاملة غير إنسانية، بما في ذلك إخضاعهم لتجارب بيولوجية. ونصت كذلك على حظر استعمال العنف ضد أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم، وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب إصابتهم، سواء كان ذلك بقتلهم أو تعذيبهم، أو استعمال القسوة في معاملتهم.
وحظرت كذلك إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة أحد الأطراف المعادية للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تسوغها المعالجة الطبية.
وحظرت الاتفاقية كذلك أخذ رهائن والتهديد بقتلهم أو إلحاق الأذى بهم، لإجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري، على القيام بعمل أو الامتناع عنه كشرط لسلامة الرهائن أو الإفراج عنهم.
وحظرت الاتفاقية أيضًا تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات المسلحة الوطنية، أو استخدامهم للمشاركة فعليًّا في الأعمال الحربية.
ولما كان القتال ليس هو الغاية المباشرة للحرب، وإنما غايتها قهر العدو والتغلب عليه فقط، أما القتل فمجرد وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لذلك فإن القتل الذي يباح شرعًا يجب أن يكون في الحدود التي تقتضيها ضرورة الحرب، وبالصورة التي لا تصدم مشاعر الإنسانية.
وروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، وليحد أحدكم شَفرته وليُرحْ ذبيحته»14.
وهذا الحديث يتناول القتل المشروع والذبح المشروع، ويأمر بالإحسان في الحالين. وإحسان القتل يقتضي إزهاق الروح بأخف الوسائل مئونة على المقتول. ولما كان الألم من لوازم القتل، وجب أن تكون أداة القتل وكيفية مباشرته بحيث تحدثان أدنى قدر من الألم، وإلا لم يكن الفعل قتلًا فحسب بل كان تعذيبًا ثم قتلًا، والتعذيب محل نهي، فضلًا عن أنه لا فائدة فيه. ويروى أن النبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: انظر فلانًا، فإن أمكنك الله منه فاحرقه بالنار، فلما ولّى دعاه فقال: إني قلت لك ذلك وأنا غضبان، فإنه ليس لأحد أن يعذِّب بعذاب الله تعالى، ولكن إن أمكنك الله تعالى منه فاقتله. وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول لأمراء جنده: «لا تغُلّوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا»15.
وقال الإمام الشافعي: إذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم، قتلوهم بضرب الأعناق، ولم يجاوزوا ذلك إلى أن يمثّلوا بقطع يد ولا رجل ولا عضو ولا مفصل ولا بَقْر بطْن ولا تحريق ولا تغريق ولا شيء بعد ما وصفت، لأن رسول الله نهى عن المثُلة، وقتَل من قتل بما وصفت.
وتروي كتب السيرة أنه لما كان غزوة أحد وفيها قتل حمزة عم النبي (صلى الله عليه وسلم) ومُثِّل به بشناعة، فحزن النبي (صلى الله عليه وسلم) لذلك أشد الحزن وقال: «والله لئن أظهرنا الله عليهم يومًا من الدهر لأمثّلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب»16، ولكن الله نهاه عن ذلك فلم يفعل رغم أن الله أمكنه منهم. وروي عنه (صلى الله عليه وسلم)، أنه نهى عن الـمُثْلة ولو بالكلب العَقور17.
وجاء في شرح «السِّير الكبير» أن عُقْبة بن عامر قدم على أبي بكر الصديق برأس أحد البطارقة، فأنكر ذلك، فقيل له: يا خليفة رسول الله، إنه يفعلون ذلك بنا. قال: فاستنانٌ بفارسَ والروم؟! [أي: أجَرْيٌ على سنتهم] لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر. وفي رواية: لقد بغيتم، أي تجاوزتم الحد18.
أما عن جرحى الحرب فيبدو من كتابات جمهور الفقهاء أنه ليس هناك ما يمنع من الإجهاز على الجرحى من غير أهل الإسلام. وقد رويت أخبار تنسب إلى الصحابة قتل جرحى العدو في غزوة بدر وفي غزوة اليرموك. على أن من الفقهاء المحدثين من يرى غير ذلك، على أساس أن إباحة قتل غير المسلم في الحرب في أثناء المعركة إنما يقصد به درء شرِّه وكفُّه عن العدوان؛ فهو قتل اقتضاه الدفاع. والجريح إذا أعجزه الجرح عن القتال لم تعد ثم حاجة إلى مدافعته بما يذهب بنفسه. ويستشهد لصحة ذلك بما هو مقرر في شأن البغاة؛ فالأكثرون على أنه لا يجوز التذفيف (أي الإجهاز) على جرحاهم. ويستشهد كذلك بما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال يوم فتح مكة: «ألا لا يُجهزنّ على جريح ولا يتبعنّ مدبر ولا يقتلنّ أسير». ويستبعد صاحب هذا الرأي أن يكون النبي خاصًّا بأهل مكة، لأن اللفظ عام، وأنه يتقوى كذلك بالقياس، ومن ثم فهو يرى عدم قتل الجريح، بل الرأي عنده هو الإحسان إليه وعلاجه19. وعندنا أنه لو صح ما ذهب إليه الرأي الأول فيمكن حمله على أنه كان من باب المعاملة بالمثل، على النحو الذي كان سائدًا في ذلك الزمان، إذ كان العمل يجري في الحروب آنذاك على قتل الجرحى. وغذا كان المجتمع الدولي قد تواطأ اليوم على حظر قتل الجرحى الذي تعجزهم إصابتهم عن مواصلة القتال، وأوجب رعايتهم وعلاجهم، فلا خلاف في امتناع قتلهم شرعًا.
واختلف الفقهاء كذلك في الأسرى؛ فقال قوم يقتلون. وقال قوم: لا يجوز قتلهم. وفوض آخرون أمرهم إلى الإمام. وسبب الخلاف- كما يقول ابن رشد- هو تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام. فظاهر قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، الآية [محمد: 4]، أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المنّ أو الفداء، قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾، الآية [الأنفال: 67]، والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستعباد. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في غير ما موطن، كما أنه منّ ولم يقتل.
ويضيف ابن رشد: إن من رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناسخة لفعله، قال: لا يقتل الأسير. ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى، بل فعله عليه الصلاة والسلام، وهو حكم زائد على ما في الآية، قال بجواز قتل الأسير20.
والذي نراه هو أنه ما دامت المسألة تحتمل الخلاف، فالمصلحة هي المرجِّح. ولما كان المجتمع الدولي قد أجمع على عدم قتل الأسرى، وهو حكم يستفيد منه طرفا القتال، وفيه استنقاذ الأنفس، فما قرره المجتمع الدولي في هذا الشأن هو ما ينبغي أن يكون عليه الحكم شرعًا، لأن فيه معاملة بالمثل.
ونصت الاتفاقية على حظر تجويع المدنيين بوصفه أسلوبًا من أساليب الحرب، وذلك بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة، لأن من شأن ذلك تعريضهم للموت.
وفي الحديث أن «امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض»21.
وفي الحديث أيضًا «أن رجلًا دخل الجنة في كلب كان يلهث وقد اشتد به العطش فسقاه»22.
وإذا كان منع الطعام والشراب عن الحيوان الأعجم يُدْخل النار وسُقْياه تدخل الجنة، فأولى أن يكون هذا هو حكم الإسلام فيمن يحرم الإنسان- بما هو إنسان، وبغض النظر عن دينه- من الطعام والشراب مما يعرضه للموت جوعًا وعطشًا.
كما نصت الاتفاقية على حظر استغلال بعض مواقع المدنيين أو غيرهم ممن يتمتعون بحماية كفلها لهم القانون الدولي، وذلك لوقاية هدف عسكري من الهجوم أو لحماية عملية عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
(29) وحرصت الاتفاقية على ضمان الحرية الشخصية، فحظرت إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين من الأرض المحتلة، كما حظرت نقلهم كلهم أو بعضهم داخل هذه الرض أو خارجها، ما لم يكن ذلك لدواعٍ أمنية أو لأسباب عسكرية ملحّة. وحظرت كذلك إجبار رعايا الطرف المعادي، على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى إن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة، كما حظرت إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية، على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
(30) أما معاملة أهل البلاد المفتوحة فإن المسلمين منذ الخلافة الراشدة كانوا إذا فتحت جيوشهم بعض البلاد أقرُّوا أهلها على ما هم عليه في أوطانهم. وكل ما كانوا يفعلونه هو تخييرهم بين الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية. ويذكر الطبري في «تاريخه» نص المعاهدة التي كتبها معاوية بن أبي سفيان ووقَّع عليها عمر بن الخطاب وبطريرك مدينة إيلياء (بيت المقدس)، ومما جاء فيها أن «أهل إيلياء لا يُكْرَهون على دينهم ولا يُضام أحد منهم... وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمِن وعليه مثْلُ ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويُخلي بِيَعهم وصُلُبهم فإنهم على أنفسهم وعلى بيعهم وصلُبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض، فمن شاء منهم قعد وعليه مثلُ ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء منهم سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله»23.
ويضيف الطبري أن الشروط نفسَها مُنِحها سكان المدن الأخرى، فقد منح خالد بن الوليد هذه الشروط لأهل دمشق والحيرة وأنات، ومنحها أبو عبيدة بن الجراح لأهل بعلبك وهمساند وحماة، ومنحها إياد بن غَنْم لأهل الرجاء.
ولم تكن الجزية تفرض على أهل البلاد المفتوحة عقابًا لهم على رفضهم الدخول في الإسلام، بل كانت مقابلًا لإعفائهم من المشاركة في واجب الدفاع عن البلاد. وكان هذا منطقيًّا، فلم يكن من الإنصاف- من جهة- حملهم على القتال دفاعًا عن دين لا يؤمنون به، فضلًا عن أن القتال قد يكون ضد أهل دينهم، ولم يكن من سداد الرأي- من جهة أخرى- الاعتماد في القتال على قوم فتحت بلادهم عَنْوة ولما يدخلون في دين الفاتحين. غير أنه لما كان الدفاع عن الدولة واجبًا يتحمل به كل من يقيم على أرضها مقابل تمتعه بالحماية والأمان، فقد كان السبيل إلى التوفيق بين الاعتبارات المتعارضة هو أن يوضع الجهاد عمن لم يدخل في الإسلام، وأن يدفع القادر منهم على القتال مبلغًا من المال يستعان به في تدبير نفقات الحرب. ولهذا السبب وعلى الرغم من قطعية النصوص التي توجب على الذميين دفع الجزية، فقد كانت توضع عمن يشترك منهم في القتال مع المسلمين، وهو ما حدث في كثير من الحالات.
(31) ونصت الاتفاقية كذلك على حظر الاغتصاب (زنىً كان أو لواطًا)، والاستعباد الجنسي (أي تملك الغير وحمله على ممارسة الجنس) والإكراه على البغاء، وكذلك الحمل القسري، والتعقيم القسري (أي الحرمان من القدرة البيولوجية على الإنجاب)، كما حظرت الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة معاملته معاملة مهينة تحطُّ من قدره واعتباره. ولا شك أن كل ممارسة للجنس خارج منظومة الزواج فهي محرمة في كل الأديان، وإذا تمت كرهًا فهي جريمة في كل التشريعات الوضعية لانتهاكها حرمة العرض، وهو من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان. وليس العنف الجنسي وحده هو ما ينال من كرامة الإنسان، بل ينال من كرامته كل فعل يقصد به إذلاله وامتهانه. والإسلام حريص كل الحرص على كرامة الإنسان أيًّا كان الدين الذي يعتنقه؛ فالأمر في هذا موكول إلى الله. لكن الإنسان أهل للتكريم لمجرد كونه إنسانًا خلقه الله ونفخ فيه من روحه، وقال في محكم كتابه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70]، ومقتضى تكريمه أنه لا ينبغي أن يُذَلَّ أو يُهانَ. نعم قد يخطئ، وكل بني آدم خطاء، وخطؤه يستوجب العقاب، لكن العقاب لا يقتضي الإذلال والامتهان.
(32) وإذا كانت الاتفاقية قد حظرت تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا خمسَ عشرةَ سنة في القوات المسلحة أو استخدامهم فعليًّا في الأعمال الحربية، فهذا الحظر ترديد لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، إذ لا يفرض الجهاد إلا على المكلفين، والأطفال غير مكلفين إلى أن يجتازوا مرحلة الطفولة ويصبحوا من أهل القتال. ومن الجرم حقيقة أن تغتال براءة الأطفال بالزَّجِّ بهم في أتون المعارك، سواء خاضوا بأنفسهم أو كلِّفوا بأعمال تتيح لهم شهود ما يجري فيها من قتل وتدمير وقد ذكر عن ابن عمر أنه قال: عُرضت على النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم أحد وأنا ابن ثلاثَ عشرةَ سنة فردَّني، ثم عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة24.
(33) ونصت الاتفاقية كذلك على حظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم يكن هذا الاستيلاء أو التدمير مما تحتمه ضرورات الحرب، وهذا النص يتفق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يقول لقواده: «ولا تهدموا بيتًا ولا تعقُرنّ شجرة إلا شجرًا يمنعكم قتالًا أو يحجز بينكم وبين المشركين»25.
وجاء في وصية أبي بكر (رضي الله عنه) ليزيد بن أبي سفيان: لا تقتُلنّ مولودًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا، ولا تعقُرنّ شجرًا بدا ثمره ولا تَحرِقُنَّ نخلًا ولا تقطعنّ كَرْمًا، ولا تذبحن بقرة ولا شاة، ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا لأكل26.
ويرى فقهاء الشريعة أن إتلاف ممتلكات العدو بعد الاستيلاء عليها وانتهاء القتال بالفعل ضرب من الفساد لا يقره شرع ولا عقل، أما ممتلكات العدو في أثناء الحرب فإنها ثلاثة أنواع: الأول: ما تدعو ضرورة الحرب إلى إتلافه، كالتي تعوق التحركات العسكرية في ميدان القتال، أو التي يستخفي العدو وراءها، أو يستخدمها في قتاله أو في تنقله أو في تموينه الحربي، أو التي يكون إتلافها قصاصًا لينتهي العدو عن مثله إذا كان يفعله بممتلكات المسلمين. وهذا النوع لا خلاف في جواز إتلافه، بل إذا دعت الضرورة إلى إتلافه وجب.
والنوع الثاني: ممتلكات لا تدعو الحاجة إلى إتلافها ، بل تدعو إلى الإبقاء عليها، كالتي يعود إتلافها بالضرر على المسلمين أنفسهم، كصهاريج المياه والسدود التي لو ضربت لأخذت عليهم الطريق، والممتلكات التي يخشى لو ضربها المسلمون لضرب العدو نظائرها عندهم كآبار البترول. وهذا النوع لا خلاف في حرمة إتلافه.
والنوع الثالث ممتلكات لا تدعو الحاجة إلى إتلافها ولا إلى الإبقاء عليها، كسائر المزروعات أو المباني التي لا تعوق الجيش ولا تقف عقبة في طريق النصر. وهذا النوع لا يجوز إتلافه على التحقيق؛ لأن إتلافه فساد محض، والله ينهى عن الفساد.
ولا يُعترض بما فعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع بني النضير ويهود خيبر، إذ أحرق بعض بيوتهم وقطع بعض كرومهم؛ فهذا كان مما اقتضته ضرورة القتال27.
(34) جـ- وأما الأماكن التي يحظر شن الهجوم عليها فهي بوجه عام الأماكن التي لا تشكل أهدافًا عسكرية، ومنها المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، وكذلك الآثار التاريخية والمستشفيات والوحدات الطبية وأماكن تجمع المرضى والجرحى. ولا خلاف في أن هذا الخطر يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن هذه الأماكن كلها تؤدي نفعًا للإنسان، وليس من شأن تدميرها أو المساس بها تحقيق نصر أو درء هزيمة إلا أن يساء استخدامها باتخاذها مخازن للأسلحة أو مأوى لبعض القوات المقاتلة، فعندئذ تخرج عن الأغراض التي خصصت لها فتنقلب أهدافًا عسكرية يصح شن الهجوم عليها.
ثالثا: الجرائم الواقعة ضد الإنسانية
(35) اشتملت المادة السابعة على طائفة من الأفعال عَدَّت أيًّا منها جريمة ضد الإنسانية إذا وقع الفعل في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وكان الجاني عالـمًا بأن فعله هذا جزء من هذا الهجوم، أو كان قاصدًا جعْله جزءًا منه. ولا يلزم لوقوع هذه الجريمة أن تكون هناك حالة حرب، ولا أن يكون هناك نزاع مسلح غير دولي، أي إنه لا يشترط أن يكون الفعل عملًا عسكريًّا. وحضرت المادة السابعة الأفعال المؤثمة في القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، وإبعاد السكان أو نقلهم قسرًا، والسجن أو الحرمان الشديد من حرية التنقل، والتعذيب، والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو على الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو الاضطهاد لأسباب لا يجيزها القانون الدولي، والاختفاء القسري للأشخاص والفصل العنصري، وأضافت المادة فضلًا عن ذلك عبارة عامة تتسع لأفعال أخرى عن طريق القياس وصفتها بأنها: سائر الأفعال اللاإنسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم، أو بالصحة العقلية، أو البدنية.
والمقصود بالهجوم المنهجي الواسع النطاق كل نهج سلوكي يتضمن تكرار ارتكاب الأفعال المشار إليها ضد مجموعة من السكان المدنيين تنفيذًا لسياسة دولة أو منظمة جعلت هذا الهجوم من أهدافها.
ويقصد بالإبادة إجبار جماعة من الناس على العيش في ظروف قاسية تؤدي حتمًا إلى إهلاكها كليًّا أو جزئيًّا، وذلك بحرمان أفرادها من الحصول على ضرورات الحياة، كالطعام والدواء، مع العلم بعواقب هذا الحرمان.
أما الاسترقاق فيعني ممارسة الجاني على بعض الأشخاص- لاسيما النساء والأطفال- أيًّا من السلطات التي يمارسها المالك على ملكه، كالشراء والبيع والإجارة والإعارة، أو يفرض عليهم حرمانًا من التمتع بالحرية.
وأما الإبعاد أو النقل القسري فيعني نقل جماعة من الناس جبرًا من المنطقة التي يقيمون فيها بصفة مشروعة إلى منطقة أخرى دون مسوغ مما يجيزه القانون الدولي.
ويعني الحمل القسري إكراه المرأة على الحمل وعلى الوضع، بقصد التأثير على التكوين العرقي لمجموعة معينة من السكان. أما التعقيم الجنسي فيقصد به حرمان المجني عليه من القدرة البيولوجية على الإنجاب للسبب نفسه، دون أن يكون لذلك مسوِّغ طبي ودون موافقة من يقع عليه هذا الفعل.
أما الاضطهاد المحظور فيتمثل في القبض على أفراد جماعة معينة أو احتجازهم أو خطفهم، ورفض الإفصاح عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، إذا ارتكب الفعل باسم دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو بدعم أو إقرار منها، وكان ارتكابه لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية، أو دينية، أو لنوع الجنس- أي الذكورة والأنوثة- أو لسبب آخر لا يجيزه القانون الدولي.
(36) والأفعال السابقة جميعًا تنال من حقوق أساسية للإنسان، وهي حقه في الحياة، وفي السلامة البدنية والنفسية، وفي الحرية وسلامة العرض، وهي حقوق تعد في الشريعة الإسلامية من الضروريات. ولهذا فإن تحريم العدوان عليها يتفق مع مقاصد الشريعة.
على أنه في موضوع الرِّق في الإسلام كلمة يجب أن تقال إقرارًا للحق ودرءً لشبهة قد تثار؛ فربما قيل: إنه لا نص في الإسلام على حظر الرق، وهو ما يعني أن القول باتساق ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الاسترقاق مع ما هو مقرر في الإسلام غير صحيح. والرد: أن هذا الاعتراض- مقدمة ونتيجة- هو غير الصحيح؛ ذلك أن الرِّق الذي هو محل خلاف في الفقه الشرعي ينصبُّ أساسًا على استرقاق أسرى الحرب وحدهم، أما غيرهم فلا خلاف بشأنهم، إذ لا يجوز استرقاقهم أصلًا. وما دمنا بصدد الحديث عن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في غير ظروف الحرب، فإن استرقاق الأشخاص محظور في الإسلام بغير خلاف، ومن ثم فلا تعارض البتة بين ما حظرته الاتفاقية وبين ما هو مقرر في الإسلام.
أما استرقاق أسرى الحرب فكان نظامًا متعارفًا عليه في العالم القديم، وظل ساريًا حتى عهد غير بعيد؛ عرفه المصريون القدماء والصينيون والهنود والرومان والفرس والإغريق والعرب. ولم تكن الحرب هي مصدر الرق الوحيد، بل كان الأحرار أنفسهم يُسترَقُّون في غير الحروب؛ إما جبرًا عنهم باختطافهم أو رضًا بالبيع للفاقة وشدة الحاجة. بل إن الرق كان يفرض أحيانًا بحكم القانون، كاسترقاق المدين عند عجزه عن الوفاء بدينه عند الرومان. ولما جاء الإسلام أبطل الرق ضمنًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع: «إن أباكم واحد»28، «كلكم لآدم وآدم من تراب»29. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]. ومقتضى التكريم ألا يَسترِقَّ أخٌ أخاه فيحيله «شيئًا» وقد خلقه الله مثله إنسانًا. ومن هنا كانت قولة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لعمرو بن العاص (رضي الله عنه): متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!30.
ولا يؤخذ على الإسلام أنه لم يبطل استرقاق الأسرى ويعلن تحرير الرقيق صراحة؛ وذلك لسببين: الأول: أن الرق كان نظامًا اقتصاديًّا راسخًا على مستوى العالم المعروف حينذاك، وتغيير النظم الاقتصادية المتأصلة طفرة لا يلقى القبول بسهولة من قبل الناس لارتباطه بالمال، وهو شقيق الروح كما يقال. ولهذا جرى الإسلام على عادته في التدرج في الأحكام في مثل هذه الأحوال. وبدا هذا واضحًا من تضييقه في مصادر الرق، إذ لم يجعل له مصدرًا سوى الحرب المشروعة، وتوسيعه في أسباب انقضائه بالأخذ بنظم الكفارات والمكاتَبة والتدبير والاستيلاد، وسريان العتق والتطوع به.
أما العتق تطوعًا فإنه تصرف يقع من المالك بإرادته المنفردة، فتزول عن العبد حالة الرق ويسترد حريته. وقد يكون التعبير عن هذه الإرادة صريحًا، وقد يكون كتابة عند أكثر الفقهاء. أما الكفارة فجزاء على معاصٍ محددة شرعًا، كالإفطار في نهار رمضان والظهار والحِنْث باليمين والقتل الخطأ. وأما المكاتَبة فهي تعاقد السيد مع عبده على عتقه مقابل مال. أما التدبير فعِتْقٌ مضافٌ لما بعد الموت، وهو قريب من الوصية. ومن الفقهاء من لم يفرق بينهما، ومن فرق جعل التدبير لازمًا والوصية غير لازمة. وأما الاستيلاد فمعناه أن تلد الأمة من سيدها، وتسمى «أمَّ الولَد». وفي تحررها بمجرد الولادة خلاف. وأما سريان العتق فيتحقق فيمن يُعْتق بعضَ عَبْده، فالجمهور على أنه يُعتَق كلُّه. وإن كان يملك بعضَ عبدٍ وله شريك، فالراجح تحرير العبد. وفي حق الشريك خلاف فيمن يلزمه: المعتق أو العبد، أو بيت المال. وحجة القائلين بالسِّراية أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه.
والسبب الثاني أن الإسلام لو نص على استرقاق أسرى الحرب، فهذا الحظر يلزم المسلمين بوصفهم المخاطبين بأحكامه، لكنه لا يلزم غير المسلمين. وليس من سداد الرأي ولا العدل أن يطلق المسلمون سراح الأسرى من أعدائهم في الوقت الذي يَسترِقُّ فيه الأعداءُ أسراهم.
ومع ذلك فإن المصدر الوحيد للرق وهو الحرب ليس محل إجماع في الفقه. وإذا كان جمهور الفقهاء يجيز استرقاق الأسرى فإن منهم من ينكره. أما سند الجمهور فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: 4]. وقيل نقلًا- عن ابن عباس-: إن الله في هذه الآية جعل الخيار للنبي والمؤمنين في الأسرى: إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم31. واستندوا كذلك إلى فعله (صلى الله عليه وسلم)؛ فقد سَبى النساء والصبيان.
وحجة الفريق الثاني أن السنّة كانت تشريعًا خاصًّا لحالة خاصة- هي استرقاق العدو لأسرى المسلمين؛ فهو نوع من المعاملة بالمثل. أما آية المنّ والفداء فتشريع عام ظاهر الشمول، فيُحمل العامُّ على الخاصِّ ويعمل به في سائر الحالات الأخرى. أما حمل المن على أنه العتق فمحل نظر، لأن المن شيء والعتق غيره، وهما يختلفان اختلاف الأعمِّ والأخصِّ، لأن المنّ هو الإنعام بأي شيء، عتقًا أو غيره. ولا موضعَ للعتق هنا ما دام لم يَقُمْ دليل آخر على تقدم الرق، وإثباتُ الأعمِّ لا يستلزم إثبات الأخصِّ. بل الاستعمال الشرعي لَيَقْصُرُ المنْ على إطلاق الأحرار، أي على معنًى مباينٍ لمعنى الإعتاق. ويضيفون أنه لا دلالة لشدِّ الوثاق على معنى الاسترقاق، إذ لا يلزم من تقييد المرء استرقاقه لا عقلًا ولا عرفًا.
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أن الخصال الدائمة التي جاءت في تشريع الإسلام ليُختار من بينها مصير الأسرى إنما هي الإطلاق بلا مقابل، وهو المسمى بالمن، أو بمقابل، وهو المسمى بالفداء. ويقرر أن ما انتهى إليه المجتمع الدولي الآن بشأن الأسرى يتفق مع أحكام الإسلام، حيث ينص القانون الدولي على أن تنتهي حالة الأسر بإطلاق سراح الأسير، سواء أطلق سراحه بلا قيد أو شرط، أو بعد إعطائه كلمة شرف، وتنتهي كذلك بتبادل الأسرى بعضهم ببعض32.
| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: مقاصد الشريعة والإتفاقيات الدولية (مجموعة بحوث)، 2013 مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ص 167-210. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني. |